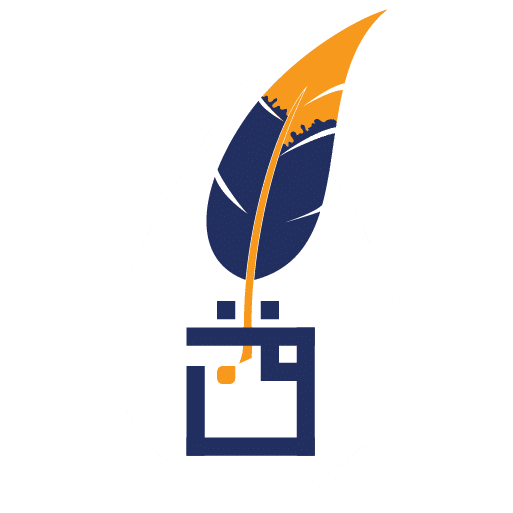بين الإنسان السامي والسوبرن: مقاربة فلسفية بارادايمية
أيمن قاسم الرفاعي
ليس فيلم “سوبرمان” مجرد حكاية بطل خارق يحلّق في السماء وينقذ العالم من الشرور، بل هو تمثيل رمزي كثيف للتوتر الوجودي بين “ما هو كائن” و”ما ينبغي أن يكون”. إنه إعادة إنتاج معاصرة لصورة الإنسان المُتأله، الحائر بين ألوهية مرجوة وقصور بشري واقع. وهنا، سنحاول مقاربة هذه الأيقونة الثقافية من منظور فلسفي خاص، عبر استحضار الفلسفة النيتشوية، ومقارنتها برؤية “بارادايم القرآن” لمفهوم الإنسان، بين التمكين والاستعلاء، بين الضعف والغاية، بين “السوبرن” كقوة خارقة، و”الإنسان السامي” كنموذج أخلاقي وروحي.
سوبرمان: الميلاد والبعثة والنبوة العلمانية
تبدأ الحكاية بسقوط كائن من كوكب آخر إلى الأرض، رضيعًا يُرمى بها كما رُمي موسى في اليمّ، لكنه ليس نبيًا بالمعنى التقليدي، بل رسولًا لعصر العلمانية. يُربى بين البشر، ويكتشف تدريجيًا قدراته الخارقة، ويخفي هويته خلف شخصية “كلارك كينت”، الصحفي الخجول، بينما يخوض معاركه باسم “سوبرمان”.
هذه الثنائية بين الإنسان العادي والسوبرن تمثل إعادة سرد حداثية لثنائية الروح والجسد، الظاهر والباطن، لكنها تُفرغ من بعدها الغيبي لصالح تمجيد الإنسان لا باعتباره مخلوقًا ذا رسالة، بل كمشروع سيطرة وقوة. هنا يبدأ التوتر الفلسفي بين المنشود الأخلاقي والهيمنة التقنية.
الفلسفة النيتشوية وسوبرمان:
نيتشه، في سياق رفضه للضعف الأخلاقي المسيحي، نادى بمفهوم “الإنسان الأعلى”، ذاك الذي يتجاوز القيم التقليدية، ويصنع قيمه الخاصة. لكن هذا الإنسان السامي النيتشوي ليس بطلًا خارقًا بمقاييس القوة الفيزيائية، بل بمقاييس الإرادة الحرة وتجاوز الحشود.
بالمقابل، يأتي “سوبرمان” في الرواية الهوليودية الأمريكية كنقيض مقلوب: كائن خارق الجسد، لا الفكرة. هو إله مصغّر بلا رسالة وجودية سوى الحفاظ على النظام القائم. قوته لا تحرّر الإنسان، بل تجعله دائم الاعتماد عليه. وهنا تتجلى المفارقة: فبدل أن يرتقي البشر إلى مقام العلو، يعودون إلى عبادة المخلّص الذي ينقذهم في كل أزمة دون أن يُعلّمهم كيف يكونون أحرارًا.
فلسفة بارادايم القرآن: الإنسان المؤتمن لا المخلّص
الإنسان في بارادايم القرآن ليس كائنًا يتدرج نحو كمالٍ بيولوجي أو تفوقٍ وظيفي على غيره، بل هو كينونة مخصوصة صيغت على عين السنن، لتكون نقطة التوازن بين الغيب والشهادة، بين الطين والنفخة، بين القهر والحرية، تسمى (الإنسان السامي).
هو مشروع وجودي قائم لا على المقارنة ولا على المنافسة، بل على العروج الذاتي الذي لا يستلزم سقوط أحد، ولا يُقاس بنجاح أحد، بل بانسجام الكائن مع غايته، واستقامته على سننه. ففي ميزان القرآن، هو ليس الإنسان “الأسْمى” الأعلى على الناس، بل هو “السامي” الأوفى مع الله؛ لا يصعد على أكتاف الآخرين، بل يبني سُلَّمه من تواضعه، من تزكيته، من صمته حين يكون الكلام رياءً، ومن فعله حين يسكت الجميع. إنه الإنسان الذي لا تغويه القوة الظاهرة، لأنه يعلم أن السمو لا يتحقق خارج الذات، بل في بنائها وتهذيبها.
هذا السمو لا ينبع من نزعة الهيمنة ولا من شعور النقص، بل من ثقافة داخلية يتربى عليها جيل كامل، جيل لا يتنمّر ولا يتفاخر ولا يُقارن نفسه بأحد، لأن مقياسه في التقدم ليس ما عند الناس، بل ما تحقق من مقصوده هو. لذلك، لا تكون إنسانيته رد فعل على غيره، بل فعلًا أصيلًا من ذاته.
وهذا هو الإنسان الذي يقدّمه بارادايم القرآن: خليفة لا مستبدًا، فاعلًا لا متفوّقًا، ناطقًا بالحق لا مستعرضًا للحق، صانعًا للميزان لا متسلّقًا عليه. ومن هنا فإن “السامي” في القرآن هو الإنسان الذي أدرك أنه ليس في سباق ضد بشر، بل في امتحان مع نفسه، على مدرجٍ يُقاس فيه الوعي لا المظهر، والإخلاص لا الانتصار.
هو الإنسان الذي يُجيد التوقف حين يغويه البريق، ويُحسن التقدم حين يكسل الناس، ويصغي لصوت الله لا لصدى الجماهير.
وهكذا، يكون “السامي” تجليًا بشريًا للقدرة على أن تكون إنسانًا في عالمٍ يدفعك أن تكون شيئًا آخر.
ومن هنا، فإن السمو القرآني لا يُغذي نزعة البطولة الفردية، بل ينقضها، ليقيم مقامها روح المسؤولية الجماعية، ويبدل من منطق “المنقذ الخارق” إلى منطق “الإنسان المؤتمن”، حيث يُوزع المجد، ويُعقل النصر، وتُزكّى القوة.
سوبرمان كعقيدة مدنية: وهم الخلاص بلا إصلاح
في أفلام سوبرمان الحديثة، يتكرر نفس القالب: أزمة وجودية، تهديد كوني، بطل خارق يظهر ، الناس تهتف، تنقذ المدينة، يُنسى كل شيء، وتبدأ الحلقة من جديد.
هذا التكرار الدرامي ليس بريئًا، بل يُكرّس في اللاوعي الجماعي عقيدة خلاصية تستبطن أن الحلول الكبرى لا تأتي من الناس، بل من كائن أعلى، فرداني، لا يحتاج إلى ديمقراطية ولا إلى أخلاق عامة، بل إلى “قوة صافية”. هي نزعة أقرب إلى انتظار المهدي العلماني، لكنها تُنتج شعبًا بلا إرادة.
في المقابل، يُلحّ القرآن على “العمل”، “النية”، “السعي”، وعلى سنة الابتلاء والتمحيص، فالهزيمة ليست شرًا مطلقًا، والانتصار لا يُقاس بحجم القوة بل بحجم المبدأ، كما في قوله تعالى: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 249].
الوجه الآخر لسوبرمان: القصور لا الألوهية
سوبرمان، رغم قدراته، يبقى عاجزًا أمام سؤال الشر الحقيقي: لماذا يعود الظلم كل مرة؟ لماذا لا يستطيع إنقاذ الجميع؟ لماذا لا يستطيع أن يعيش حياة عادية؟ هو بطل تراجيدي في جوهره، يعيش صراعًا دائمًا بين قوته وغربته.
وهذا يعيدنا إلى المعضلة الوجودية: هل يمكن لبشر أن يحتمل أن يكون إلهًا؟ نيتشه قال: “إذا نظرت طويلًا إلى الهاوية، فإن الهاوية تنظر إليك أيضًا”. سوبرمان ينظر إلى البشر فيراهم ضعفاء، والبشر ينظرون إليه فيرونه غريبًا، وهنا تنقطع صلة الإنسان بالإنسان.
في حين أن النموذج القرآني يرفض تأليه الفرد، ويؤسس لمجتمع من الأنبياء الصغار: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾، أي أن البطولة موزعة لا متمركزة، متاحة لا محتكرة.
السوبرن الإسلامي: الخلاص المزيف في لبوس ديني
لم يتوقف أثر “السوبرن” عند بوابات هوليود، بل تسلل إلى تصورات دينية داخل الثقافة الإسلامية الحديثة، حيث اختلطت مفاهيم النبوة والكرامة بالخوارق والأسطرة. لقد تلبّست الذاكرة الإسلامية بمفاهيم المخلّص، لا بوصفه مصلحًا أخلاقيًا من جنس الناس، بل بطلًا خارقًا يشبه سوبرمان، يظهر في آخر الزمان أو يأتي من الماضي ليحلّ الأزمات دون سنن أو تمهيد.
كل فئة صنعت “سوبرنها” الخاص:
- فالمتصوفة رأوا في الكرامات تجلّيات خارقة يتعالى بها الوليّ على قوانين الطبيعة.
- والشيعة الإمامية أعطوا الأئمة صفات فوق بشرية في العلم والتصرف، حتى صار بعضهم أقرب إلى الألوهية.
- وبعض التيارات السنية، بل والجماهير الشعبية، ضخّمت معجزات الرسول الجسدية والخوارق المنسوبة للصحابة، حتى باتوا يُروَون كأبطال أسطوريين أكثر منهم نماذج بشرية قابلة للاقتداء.
وفي كل تلك الصور، تم تحويل المفهوم القرآني للسمو – وهو سمو في التزكية والقيام بالقسط – إلى بطولة تَخرج عن السنن، وتتجاوز الإمكان البشري، مما يضعف ثقة الإنسان العادي بنفسه، ويُبقيه رهين الانتظار.
وهكذا، بات المسلم ينتظر “سوبرمانه الإسلامي” بدل أن يكون هو “الإنسان السامي القرآني”. ينتظر الكرامة بدل السعي، ويتعلق بالخارق بدل الفاعلية، ويتغذى على الحكاية بدل السنن. بينما القرآن لا يقدّم المنقذ كمخلّص فرداني، بل يقدّم الإنسان المؤتمن، ويستدعي قيام الناس بالقسط لا الاتكال على الغيب المعطَّل.
بارادايم القرآن يرفض هذا المنطق، ويقدّم رؤية خلاصية من نوع آخر: خلاص يبدأ من الداخل، من تربية جيل لا ينتظر، بل ينهض؛ لا يرى في الغيب ملاذًا سلبيًا، بل وعدًا أخلاقيًا مشروطًا بالاستحقاق.
السوبرن وتشوّه قيم التغيير في الخطاب النهضوي المعاصر
إن أخطر ما أنتجه نموذج “السوبرن” الخلاصي ليس فقط هوس انتظار البطل أو الشخص المخلّص، بل ما تسرب منه إلى قيم التغيير ذاتها، حين تحوّلت من فعلٍ سننيٍّ تراكميّ إلى قفزة علوية خارقة. لقد استعارت بعض المشاريع النهضوية — من حيث لا تدري — بنية التخييل السوبرناني، حين جعلت “التفوق التقني” معيارًا للمستقبل، و”المنقذ الإداري” هو أفق التغيير، بدل أن تجعل الإنسان الرسالي المزكّى هو مركز التحوّل.
فصار الإنسان النهضوي أداةً للتخطيط لا ضميرًا للغرس، ورُفعت شعارات الكفاءة والعقلانية والإنجاز، على حساب مفاهيم مثل التزكية، والمعنى، والمقام الأخلاقي. وبذلك، تحوّل الإنسان من “فاعلٍ بالمعنى” إلى “منفّذٍ بالأداة”، ومن “سالكٍ في مدارج السنن” إلى “مسرّعٍ بقفزات استراتيجية”، وهذا — وإن بدا حداثيًا — إلا أنه في جوهره صورة عقلانية مموّهة من نموذج السوبرن: صورة تتفوق على الواقع لا تتفاعل معه، وتُبهر لكنها لا تُزكّي.
بل إن كثيرًا من خطاب “الإلهام القيادي” السائد اليوم، يتكلم عن التمكين الذاتي و”تجاوز المحدود” و”كسر السقف” بلغة مشبعة بنَفَس السوبرن، لا بلغة السمو القرآني الذي يبدأ من معرفة النفس ومجاهدتها. وهذا الانحراف في فهم العلو والتفوق، قاد إلى الإعلاء من شأن إنسان الإنجاز، على حساب إنسان الرشد.
أما بارادايم القرآن، فإنه لا يُعرّف التغيير بأنه اختراق سحري للواقع، بل انتقال تدريجي محكوم بالسنن، يبدأ من النفس وينعكس على المجتمع، لا العكس. التغيير فيه لا يتحقق إلا عندما تتجذر القيم في النفوس، وتُترجم الأمانة إلى مشروع، ويصبح “الإنسان السامي” ليس آلةً تنهض، بل شاهدًا على النهوض.
خاتمة: ما بعد السوبرن… والعودة إلى الإنسان
في عمق كل سردية خلاص، يكمن سؤال عن الإنسان لا عن الخارق، عن النقص لا عن الكمال. وبينما سعت الأساطير إلى مخلّص يأتي من كوكب آخر، ومنحته أفلام الحداثة عباءة طيّارًا خارقًا، يكشف بارادايم القرآن أنّ الخلاص لا يكون إلا من الداخل: من إنسانٍ تزكّى لا تطهّر بالأساطير، وتدرّج لا طار، وآمن بأنه لا يُنقذ العالم لأنه أقوى، بل لأنه أصدق.
ليس الإنسان السامي حلمًا ميتافيزيقيًا، بل مشروعٌ واقعيّ، يبدأ من مواجهة هشاشته، وينطلق من التزكية لا من التفوق، ويتحرر من أسر “السوبرن” حين يدرك أن التغيير لا يصنعه امتلاك الأدوات، بل ترسيم القيم التي تُوجّه تلك الأدوات. فلا حضارة تنهض بعقل أداة، ولا نهضة تدوم بنموذج مزيّف.
إنها ليست معركة بين “الخير والشر” كما تُصورها القصص، بل معركة بين الزيف والحقيقة، بين الخرافة والمعنى، بين إنسان يُستدعى ليؤمن بنفسه، وآخر يُضلّل ليظلّ ينتظر بطله.
ولذا، فإن “بارادايم القرآن” لا يقدّم خلاصًا فرديًا، بل بعثًا جمعيًا، لا يُبنى حول خارق، بل يتحقق حين يُقرّ كل امرئٍ أنه مسؤول عن موضعه من القسط. تلك هي القفزة التي لم يفهمها السوبرن… وفهمها الأنبياء.
الدوحة 23/11/2025