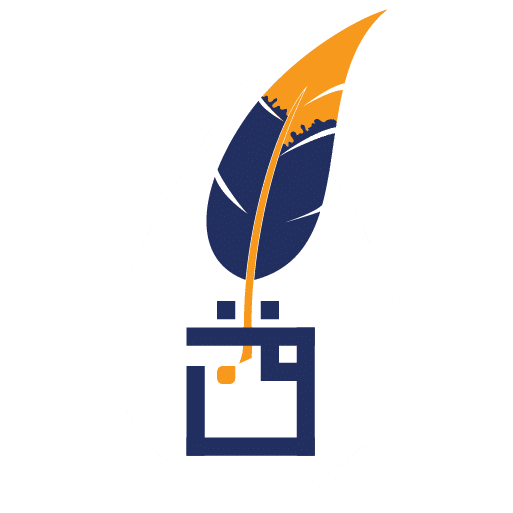سننية المتشابه في القرآن: امتحان القيم ومحرك العمران
أيمن قاسم الرفاعي
مقدّمة: الأسئلة التي تُقلق الضمير قبل العقل:
- لماذا لم يكن القرآن كلّه محكمًا مغلق الدلالة؟
- ولِمَ شاء الله أن يترك في كتاب الهداية مساحاتٍ من التشابه، بدل أن يُحكم المعنى إحكامًا يقطع كل خلاف؟
- أليس الوضوح – في ظاهر النظر – أولى بتحقيق الهداية من المعنى المفتوح؟
- وكيف يمكن فهم حضور المتشابه، مع ما يبدو أنه يفتح باب الاختلاف وتعدّد القراءات؟
- ثم سؤال أعمق، يمرّ في الوعي ولا يُقال: لماذا لم يتولَّ الرسول ﷺ تفسير المتشابه تفسيرًا قاطعًا، مع قدرته على ذلك، ومع ما في بيانه من حسمٍ لو أراد؟
- وهل يُحاسَب الإنسان أخلاقيًا على تأويلٍ لم يُلزَم فيه بوجه واحد؟
- ثم ما موقع المتشابه من علاقة الوحي بالناس: هل هو عائق أمام التلقي، أم جزء من هندسة هذا التلقي؟
- وهل يفرض التشابه الوساطة قسرًا، أم يختبر حرية الإنسان ومسؤوليته في الفهم والاختيار؟
هذه ليست أسئلة باحثٍ يقف خارج النص، ولا تساؤلات ناقدٍ يتعمّد الإشكال، بل هي الأسئلة التي تسكن وعي الإنسان حين يقف أمام القرآن بصدق، أسئلة المعرفة الأولى، وأسئلة الحيرة التي تسبق الوصول، والتي كثيرًا ما تُكتم في الصدور ولا يُصرَّح بها في الخطاب. لأن هذه الأسئلة ببساطة لا تنبع من الارتياب في النص، بل من الثقة العميقة بحكمته. وهي ليست اعتراضًا على الهداية، بل مظهرًا من مظاهرها الأولى؛ إذ لا يبدأ الفهم الحقيقي من إلغاء السؤال، بل من الاعتراف به
وذلك لأن القرآن لم يُنزَل ليُسكِت الحيرة، بل ليهديها. ومن لم يسمح لهذه الأسئلة أن تُقال في وعيه، لن يفهم المتشابه، ولا غايته، ولا سر حضوره البنيوي في الخطاب القرآني.
أولًا: آية التأسيس – المتشابه قانون في الخطاب لا استثناء فيه
﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ آل عمران: 7
لا تُقدِّم هذه الآية تعريفًا لغويًا أو اصطلاحيًا للمتشابه، بل تؤسّس لبنية الخطاب القرآني ذاتها، وتكشف عن القانون الذي يحكم العلاقة بين النص والإنسان. فهي لا تبدأ بتقسيمٍ معرفي محايد للآيات، بل تربط منذ اللحظة الأولى بين الكتاب ومنزله، ثم تقرّر أن شمولية القرآن لا تقوم على نمط واحد من البيان، بل على ازدواجية مقصودة: محكمات هنّ أمّ الكتاب، ومتـشابهات ليست نقصًا في البيان، بل مجالًا للاختبار والحركة.
والمحكم هنا ليس نقيض المتشابه، بل مرجعيته الضابطة، كما أن المتشابه ليس هامشًا لغويًا، بل مساحة دوران المعنى. فبالمحكم يُثبَّت الميزان القيمي، وبالمتشابه يُفتح أفق التفاعل مع الواقع. وبهذا تتجلّى شمولية القرآن: ثبات في الأصول، وحركة في الفهم، وميزان قيمي لا يتغيّر، يقابله أفق معرفي يتّسع بتغيّر الزمان والمكان وتطور الوعي الإنساني.
غير أن الآية تنقل مركز الثقل مباشرة من النص إلى القلوب؛ إذ لا تجعل الإشكال في الآيات، بل في كيفية تلقيها. ولهذا لم تقل: فأما الذين لا يفهمون، بل قالت: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾. فالزيغ هنا ليس خللًا عقليًا، ولا قصورًا في الإدراك، بل انحرافًا في وظيفة القلب؛ أي في آلية التقلب والنظر والموازنة. فالقلب في الخطاب القرآني هو موضع الوعي الحيّ، وسُمّي قلبًا لأنه يتقلب، ويقلب وجوه المعنى، ويعيد النظر حتى يتبيّن. فإذا انحرف هذا التقلب، أو وُجِّه بهوى أو مصلحة أو خوف، تحوّل المتشابه من مجال هداية إلى أداة فتنة، ومن أفق نظر إلى وسيلة تبرير.
ومن هنا يصبح اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة سلوكًا قلبيًا قبل أن يكون موقفًا تأويليًا؛ إذ إن الإنسان لا يدخل النص صفحة بيضاء، بل يدخل محمّلًا بقيمه وتصوراته، فيبحث في المتشابه عمّا يسوّغها. وبذلك لا يعود المتشابه سببًا للزيغ، بل كاشفًا له؛ لأنه يمنح القلب مساحة حرية، فتظهر جهة تقلبه.
وتبلغ الآية ذروة معناها عند قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾. فهذه الجملة ليست سدًّا لباب الفهم، ولا إعلانًا لعجز الإنسان عن التعقّل، بل إغلاق لوهم الامتلاك النهائي للمعنى. فلو كان التأويل غاية تُنال، أو نهاية لمسار الفهم، لانتهت حركة القرآن في التاريخ، وفقد النص قابليته للتجدد، وتعطلت سننية تفاعله مع تطور المعرفة الإنسانية وأحوال الزمان والمكان. إن حجب التأويل التام ليس نقصًا في البيان، بل شرطًا للإعجاز المستمر؛ إذ يبقى المعنى مفتوحًا للاهتداء، لا مغلقًا عند حدٍّ واحد.
وفي هذا السياق يُفهم موقف الراسخين في العلم؛ فهم لا يُعرَّفون بوصفهم مالكي التأويل، ولا حراس المعنى، بل بوصفهم أصحاب قلبٍ منضبط في تقلبه. إنهم لا يستعجلون إغلاق المتشابه، ولا يحوّلونه إلى ساحة صراع، بل يردّونه إلى المحكم، ويضبطون علاقتهم به قيميًا قبل أن يطلبوا تفصيله معرفيًا، فيقولون: ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾. أي إنهم يدركون أن الغاية ليست الوصول إلى التأويل النهائي، بل التفاعل السنني مع المعنى بما يحقق القسط والعمران في الواقع.
وهكذا تتأسس القاعدة البارادايمية الأولى: المتشابه لا يمتحن العقل، بل يمتحن القلب؛ ولا يطلب التأويل الختامي، بل الفهم المتجدد؛ ولا يُنزَل ليُغلَق، بل ليبقى حيًا في حركة التاريخ. فبقدر ما يتطور الوعي الإنساني، وتتبدل أحوال الزمان والمكان، يتجدد فهم القرآن، لا لأن النص تغيّر، بل لأن القلوب تعلّمت كيف تتقلب في ضوء ميزانه، وكيف تحوّل المعنى الممكن في كل عصر إلى فعلٍ عمراني يحقق الاستخلاف، ويشهد على دوام الإعجاز.
ثانياً: المتشابه وسننية الامتحان العام
يتكامل حضور المتشابه في الخطاب القرآني مع السننية العامة للتمحيص والابتلاء، لا بوصفه استثناءً دلاليًا، بل باعتباره أحد أدق أدوات الامتحان الوجودي. يقول تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (العنكبوت: 2)،
ويقول: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ (الأنبياء: 35). وتكشف هاتان الآيتان عن حقيقة سننية حاسمة: أن الامتحان لا يقع في الشر وحده، بل في الخير كذلك؛ بل إن الخير قد يكون أعمق الفتن حين لا يُضبط بميزان الوعي. والمعنى المفتوح، الذي يتيحه المتشابه، أحد أخطر أشكال هذا الخير؛ لأنه يمنح الإنسان مساحة حركة، ويضعه أمام حرية الاختيار، لا أمام إكراه الدلالة.
غير أن هذا الامتحان لا يستهدف الأفعال الظاهرة ابتداءً، بل يستهدف بنية القلب بوصفه موضع الوعي والتقلب. فالقلب، كما يقدّمه القرآن، ليس مستودع عاطفة ولا مجرد عقلٍ مجرد، بل بنية حية خُلقت لتقليب وجوه النظر حتى يتبيّن الحق. ومن هنا، فإن التمحيص الحقيقي لا يكون في المعلومة، بل في كيفية اشتغال القلب مع المعنى حين يُترك له هامش الحرية.
في هذا السياق، لا يكون المتشابه امتحانًا عارضًا، بل اختبارًا لطريقة تقلب القلب: هل يتقلب بحثًا عن الحق؟ أم يتقلب بحثًا عمّا يوافق هوىً سابقًا؟ هل يحتمل القلق المعرفي حتى يتحوّل إلى بصيرة؟ أم يسارع إلى تثبيت معنى واحد هروبًا من الاضطراب؟
هنا تتقاطع سننية المتشابه مباشرة مع أمراض القلوب التي يعرضها القرآن. فالزيغ، مثلًا، لا يعني غياب التقلب، بل تقلبًا منحازًا؛ قلب يعمل، لكن بزاوية مائلة، فينتج التأويل الانتقائي، ويتخذ من المتشابه مادة تبرير. أمّا الرَّان، فيمثّل تراكمًا قيميًا فاسدًا يحجب نور المعنى، فيظل القلب يتقلب، لكن دون نفاذ بصيرة، فينشأ وهم الفهم بدل حقيقته. وتأتي الأقفال لتعبّر عن تعطيل بنيوي للتقلب ذاته، حيث يُربط القلب ببارادايم معرفي مغلق يمنعه من إعادة النظر، فيتحوّل المتشابه إلى تهديد يجب إقصاؤه لا مجالًا للفهم. ثم يكون عمى القلوب فقدانًا لقابلية الإبصار القلبي، سواء كان نتيجة فساد مكتسب أو قصور أصلي في أدوات التلقي، وتأتي القسوة بوصفها موت التفاعل بعد قيام الحجة، ويكون الختم توثيقًا نهائيًا لمسار اختاره القلب مرارًا بعد البيان.
بهذا المعنى، لا يعود الامتحان بالمتشابه امتحانًا خارجيًا يُقاس بصواب الإجابة، بل تمحيصًا داخليًا لمسار الوعي نفسه. فالمتشابه لا يفرض اتجاهًا واحدًا، ولا يُغلق باب المعنى، بل يضع القلب في منطقة الخطر: منطقة الحرية، حيث يظهر هل التقلب طريق إلى بصيرة، أم منزلق إلى زيغ. ومن هنا تتجلّى المفارقة القرآنية العميقة: أن ما يبدو إشكالًا في المعنى، هو في الحقيقة أداة لتمييز القلوب، لا الآراء؛ وتمحيص الوعي، لا المعلومات.
وعليه، فإن المتشابه جزء من السننية الكبرى التي تحكم الإيمان نفسه: إيمان لا يُختبر، لا يُصفّى؛ وقلب لا يُمتحن في منطقة المعنى المفتوح، لا يبلغ سلامته. فالقرآن لا يعد الإنسان باليقين السهل، بل يدعوه إلى تحمّل قلق التقلب حتى يتحوّل إلى اختيار واعٍ. ومن لم يحتمل هذا القلق، ثبّت قلبه قسرًا عند أول معنى موروث، فكان استقراره المبكر صورة أخرى من العمى.
بهذا يتضح أن المتشابه ليس عائقًا أمام الهداية، بل شرطها؛ لأنه المجال الذي تُختبر فيه القلوب: هل تُحسن التقلب، أم تُسيء استخدامه؟ وهل تجعل من المعنى المفتوح جسرًا إلى العمران، أم ذريعة للفتنة؟ تلك هي سننية الامتحان العام في القرآن: امتحان لا يطلب جوابًا نهائيًا، بل يختبر اتجاه القلب وهو يتعامل مع المعنى في حركة التاريخ.
ومن لوازم سننية المتشابه، التي يُغفلها الخطاب الديني التقليدي، أنّه يكسر تلقائيًا ادعاء الوصاية على الوحي. فلو كانت الهداية مشروطة بكفاءة علمية مخصوصة، أو محصورة في طبقة بعينها، لما تُرك المعنى مفتوحًا، ولا وُجد المتشابه أصلًا. إذ لا يعقل أن يُنزِل الله خطابًا يُمتحَن به الناس جميعًا، ثم يحصر مفاتيحه في فئة محدودة، أو يعلّق صلته بالإنسان على وسطاء دائمين.
إن المتشابه يقرّر، سننيًا، أن التلقي واجب عام، وأن الإنسان مُكلَّف بالتعامل مع الوحي بقدر طاقته، لا بقدر غيره. فالهداية لا تُبنى على احتكار الفهم، بل على صدق التوجه، ولا تُقاس بكمّ المحفوظ، بل بسلامة القلب وهو يتعامل مع المعنى. ولهذا لم يعصم القرآن أحدًا من الزلل في المتشابه، لا عالمًا ولا فقيهًا، وبذلك أسقط مسبقًا دعوى العصمة المعرفية أو الوصاية التأويلية على الناس.
ثالثاً: المتشابه ودوران المعنى – سر بقاء النص حيًّا معجزاً
لو كان القرآن كلّه محكمًا تفصيليًا مغلق الدلالة، لكان نصًّا مكتمل المعنى منذ لحظة التنزيل، ولتوقّف الفهم عند أفق الجيل الأول، ولتحوّل الوحي إلى وثيقة تاريخية تُقرأ ولا تُنتج، ويُحتفى بها ولا تُفعِّل. عندها لانتهى الإعجاز بانتهاء السؤال، ولانقطعت صلة النص بحركة الوعي الإنساني، ولما بقي للقرآن دورٌ في توجيه التاريخ بعد اكتمال البيان.
لكن الله شاء غير ذلك.
فالمتشابه ليس إضافة عرضية إلى بنية القرآن، بل شرط بنيوي لدوران المعنى ضمن ثبات المبنى النصي. إنه المجال الذي تتحرك فيه الدلالة دون أن تنفلت، وتتجدد فيه القراءة دون أن تنقض الأصول، وتبقى فيه الآية صالحة للتفاعل مع تحولات الزمان والمكان وتطور المعرفة الإنسانية. ولهذا جاء تقرير القرآن نفسه: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: 82).
فالاختلاف المنفي هنا ليس اختلاف التنوع أو تعدد الوجوه، بل اختلاف التناقض والتهافت. أما ما يتيحه القرآن من تعدد دلالي منضبط، فليس خللًا في النص، بل دليل على مصدره؛ إذ يجمع بين مبنى ثابت يحفظ الميزان، ومعنى دائر يستوعب تطور الوعي دون أن يفقد مرجعيته. وبهذا تتشكل المعادلة القرآنية الكبرى التي يقوم عليها بارادايم الفهم: ثبات المبنى + دوران المعنى = نص حيّ.
ومن هنا يُفهم الإعجاز القرآني فهمًا أعمق من حصره في البلاغة أو الإخبار أو التحدي اللغوي. فالإعجاز، في جوهره السنني، يتمثل في قدرة النص المستمرة على إنتاج المعنى دون أن ينقض نفسه، وعلى مخاطبة الإنسان في كل طور معرفي بما يناسب أفقه، دون أن يُفرِّط بثوابته القيمية. وهذه القدرة لا تتحقق إلا بوجود المتشابه، الذي يُبقي باب التفاعل مفتوحًا، ويمنع اكتمال المعنى إغلاقًا يُميت النص.
ولهذا يقول تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (فصلت: 53). فالتبيّن هنا ليس لحظة واحدة تُنال، بل مسارًا تراكميًا يرتبط بتوسع المعرفة، ونضج الخبرة الإنسانية، وتحوّل أدوات النظر في الآفاق والأنفس. ولو لم يكن في النص متشابه، لما أمكن لهذا التبيّن أن يستمر، ولا أن يتجدد، ولا أن يرافق الإنسان في رحلته الحضارية.
وعليه، فالمتشابه ليس مشكلة معرفية تحتاج إلى حلٍّ نهائي، بل شرط الإعجاز المستمر، وضمانة بقاء القرآن حيًّا في التاريخ. إنه ما يمنع اكتمال الفهم على صورة جامدة، ويحوّل القرآن من نص يُحفَظ إلى خطاب يُفاعِل، ومن معنى يُستهلك إلى ميزان يُستحضَر، ومن كتاب يُتلى إلى وحيٍ يقود العمران.
خاتمة: المتشابه… حين تُهذَّب الحيرة وتُحمَّل الأمانة
لم يُنزَل المتشابه في القرآن ليُربك الإنسان، ولا ليتركه معلّقًا في فراغ الدلالة، بل ليضعه في الموضع الذي لا تقوم الهداية إلا به: موضع الحرية المسؤولة. فلو أُغلق المعنى إغلاقًا تامًّا، لانطفأت الحاجة إلى النظر، ولو حُسمت الدلالة من كل وجه، لتعطّلت وظيفة القلب، ولما بقي للإنسان إلا الاتباع الآلي لا الاختيار الواعي.
ومن هنا، لم تُعلَّق الهداية في القرآن على طبقة مخصوصة، ولا جُعل الفهم امتيازًا معرفيًا مغلقًا، بل فُتح باب التلقي لكل إنسان، كلٌّ بحسب ما أوتي من قدرة ووعي. فالمتشابه لا يُقصي محدودي المعرفة، كما لا يمنح امتيازًا تلقائيًا لأصحاب التخصص، بل يضع الجميع أمام ميزان واحد: صدق القصد، وسلامة الاتجاه، والاستعداد لتحمّل مسؤولية المعنى. وفي هذا السياق، تتقدّم المعرفة الجسرية – العابرة للتخصصات، المفتوحة على السنن الكونية والإنسانية – بوصفها أفقًا طبيعيًا للتفاعل مع المتشابه، لا بوصفها بديلًا عن الوحي، بل شريكًا في فهمه وتنزيله في الواقع.
ولهذا لم يُترك المعنى مفتوحًا عبثًا، ولا غاب البيان تقصيرًا، ولا سكت الوحي نقصًا؛ بل لأن الهداية التي تُنتزع بالإكراه لا تُثمر، والمعرفة التي تُعطى دون امتحان لا تُزكّي، والوضوح الذي يُنهي السؤال قبل أن ينضج الوعي، يُغلق الطريق بدل أن يهدي إليه. فالمتشابه ليس فراغًا في النص، بل مساحة مقصودة للفعل الإنساني.
هنا تتكشّف حكمة التشابه بوصفه ميزانًا خفيًا للضمير؛ إذ لا يتبدّل النص، بل تتبدّل القلوب، ولا يضلّ المعنى، بل يُضلّ به من أراد أن يجعل من الدلالة ستارًا، ويُهدى به من جعل منها طريقًا. فالاختلاف الذي يثيره المتشابه ليس شرًّا في ذاته، وإنما مرآة تكشف اتجاه النظر حين يُمنح الإنسان حقّ التأويل دون أن يُسلب مسؤولية الاختيار.
وبهذا المعنى، لا يكون المتشابه عائقًا في طريق التلقي، بل جزءًا من هندسته العميقة؛ لا يفرض وساطة قسرًا، ولا يترك الإنسان بلا ميزان، بل يختبر قدرته على الجمع بين الإيمان والثقة، وبين السؤال والانضباط، وبين الحركة والرجوع إلى الأصول المحكمة. فالمتشابه لا يطلب من الإنسان أن يصيب المعنى النهائي، بل أن يصون وجهته وهو يسير نحوه.
ومن هنا تتكامل أبعاد المتشابه في نسق واحد: امتحانًا قيميًا عند تعدد الاحتمال، وأفقًا معرفيًا لدوران المعنى، وشرطًا للإعجاز المستمر، ورافعةً عمرانية تحفظ الدين من الجمود، وتربط الوحي بحركة التاريخ دون أن تفصله عن ثوابته. وفي هذا كله، لا يُنزَع عن الإنسان عبء السؤال، بل يُعاد وضعه في موضعه الصحيح: لا كاعتراض، بل كأمانة.
ومن وعى هذه السننية، لم يعد يرى في المتشابه موضع اضطراب، بل موضع تشريف؛ إذ ينتقل من الجدل إلى التسبيح، حين يدرك حكمة الله في أن جعل الهداية ممكنة دون إكراه، والمعنى حيًّا دون انفلات. ثم يرتقي من التسبيح إلى الحمد، حين يرى أن هذا المنهج وحده هو ما يجعل الاستخلاف ممكنًا، والعمران متوازنًا، والإنسان شريكًا في بناء المعنى… ومسؤولًا عمّا اختار أن يفهمه ويُنزله واقعًا.
فالمتشابه، في ذروة حكمته، لا يُنهي السؤال، بل يُنضجه؛ ولا يُغلق المعنى، بل يُبقيه حيًّا؛ ولا يُسقط الإنسان من معادلة الهداية، بل يضعه في قلبها.
25/12/2025