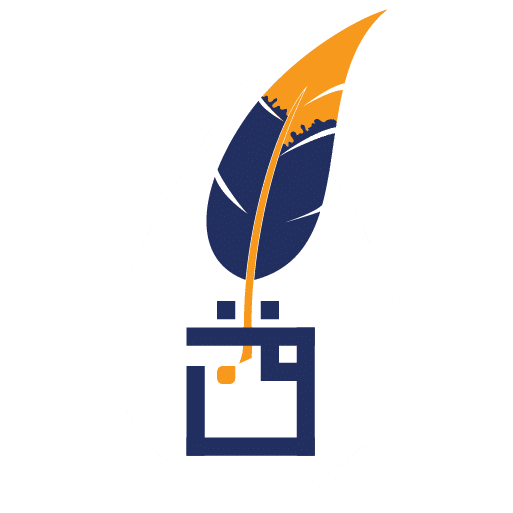أيمن قاسم الرفاعي
✦ تمهيد: التحول من الجندر إلى المقام: مقام قرآني لوظيفة الأسرة
في البناء القرآني، لا يُنظر إلى الأسرة على أنها مؤسسة ذكورية أو أنثوية، بل يُنظر إليها باعتبارها كيانًا إنسانيًا
يتشكل من زوجين، لكلٍّ منهما مقامه ووظيفته، بحسب القدرة على اتخاذ القرار، والإنفاق، والتدبير، والاحتواء.
وهكذا، فإن مفهومي “الرجال” و”النساء” في القرآن لا يشيران إلى الجنس البيولوجي، بل إلى مقامين وظيفيين:
◉ الرجولة: مقامٌ يتصف بالحسم، والكدح، والقيادة، ويشمل من الذكور أو الإناث من قام بهذا الفعل.
◉ النساء: مقامٌ إنساني يقوم على السكون والتمكين، والعمل من الظل، وتهيئة الظروف لمن يقود، ويشمل من الذكور أو الإناث من قام بهذا الفعل.
وهذه الرؤية تنتج عنها ثلاثة أنماط أساسية للأسرة، وهي ليست توصيات أو أحكامًا تشريعية للمؤمنين،
بل عرضٌ سنني كوني لأشكال الاجتماع البشري بين الذكر والأنثى، ولكل نمطٍ منها قوانينه الإصلاحية الخاصة به،
مما يكشف أن القرآن لا يفرض شكلًا موحدًا للأسرة، بل يضبط اختلال كل شكلٍ بقانونه المناسب.
وتأتي أهمية هذا التصنيف من كون الأسرة هي الركيزة الاجتماعية الأولى في مشروع العمران الإنساني،
وهي النواة التي يُبتنى منها المجتمع، ومن خلالها تُؤدّى أمانة الاستخلاف في الأرض. فإذا اختلّت الأسرة،
اختلّ معها البناء الاجتماعي والروحي للأمة. ولهذا، فإن كل نمطٍ من أنماط الأسرة في القرآن هو مشهدٌ
من مشاهد التفاعل الإنساني مع أمانة العمران، والخلل فيه يستوجب سياسة إصلاح تحفظ الغاية الكبرى:
السكينة، والعدل، والتكليف بالعمران.
ذلك لأن الأسرة في أصلها هي تحققٌ لسنة الزوجية إنسانيًّا التي خلق الله بها الإنسان، وجعلها أساسًا للتكامل والتكوين،
كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا…} [الروم: 21]
فالأسرة هي التجلي العملي لتلك السنة، والقوانين التي فصّلها القرآن حولها، إنما هي السنن القرآنية للأسرة في الإسلام،
أي القوانين الربانية التي تُنظم مؤسسة الزوجية على نحو يحقق مقصد السكينة ويضمن استمرار العمران.
✦ أولًا: الأسرة التشاركية؛ التوازن المتقابل
هو نمط أسري يقوم على توزيع الأدوار بالشورى والتفاهم بين الطرفين، دون قيادة حاسمة لأحدهما. وهو غالبًا ما يظهر حين تتقارب قدرات الطرفين،
أو يختار كلٌّ منهما نمطًا من الاستقلال والتفاعل المتوازن.
🔹 هذا النموذج ليس الأفضل ولا الأصلح دائمًا، بل هو أحد أشكال الاجتماع التي تتناسب مع بنيات شخصية متقاربة أو ثقافات تقوم على الاستقلالية الفردية،
ويتطلب نجاحه مستوى عالٍ من النضج العاطفي والإدراك الوظيفي للمسؤوليات.
🔸 مثال واقعي: هذا النمط هو الأكثر شيوعًا في الثقافة الأوروبية الحديثة، حيث حصلت المرأة على استقلال اقتصادي وتعليمي، ولم تعد تعتمد على الرجل
في شؤونها اليومية، فصارت القرارات تُتخذ بالشراكة. وقد انتقل هذا النموذج إلى العديد من البيئات الشرقية، بل وبدأ يظهر في بعض الأسر المسلمة، مع تحولات التعليم والعمل وقيم الحداثة.
🔸 الآية المفتاحية:
{وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]
🔸 القانون الإصلاحي: إذا حدث خلل (نشوز، ميلان، اختلال توازن)، فإن القرآن لا يقترح سلطة حاسمة تعيد الأمور لمكانها، بل يُفتح باب الصلح والتفاوض بين الطرفين.
🔸 طبيعة الإصلاح هنا: هذا النمط يقوم غالبًا بين زوجين كلاهما في مقام “عبد الإحسان”، أي ممن يخضعون للعقل والوعي إذا وُضّحت لهم السنن.
لذلك فالخطاب العقلي (الوعظ، المصارحة، إعادة التفاهم) كافٍ لإعادة التوازن.
🔸 عمرانيًا: هذا النموذج يُحقق أمانة الاستخلاف حين يُدار بعقلٍ مشترك، ويخلق بيئة أسرية تمكّن كل فرد من أداء دوره في المجتمع،
مما يجعله نموذجًا صالحًا في سياقات التوازن الثقافي والاستقلال المتبادل.
✦ ثانيًا: الأسرة الأمومية؛ مقام رجولة المرأة
يظهر هذا النمط حين تتقدّم المرأة إلى مقام الرجولة في الأسرة، فتتولى القيادة والإنفاق، واتخاذ القرار، بسبب غياب البعل ماديًا أو معنويًّا، أو بسبب ضعف شخصيته أو قلة كفاءته في الإدارة.
🔸 مثال واقعي: يتطابق هذا النموذج مع المجتمعات الأمومية في التاريخ، مثل المجتمعات الزراعية الأولى التي كانت المرأة فيها هي سيدة
المجتمع، كما هو حال “العصر الأمومي”. ولا يزال هذا النموذج قائمًا في بعض المناطق من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حيث المجتمعات تقوم
على سيادة النساء وتوارث النسب منهن.
🔸 الآيتان المفتاحيتان:
1. {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا…} [النساء: 128] ← تُظهر المرأة هنا بموقع القيادة والمبادرة.
2. {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ…} [النساء: 34] ← يُفهم منها أن شرط القِوامة هو (الفضل + الإنفاق)، وهما متغيران غير مقصورين على الذكور.
🔸 القانون الإصلاحي: لا يقترح القرآن استعادة القِوامة للرجل ما دام عاجزًا عنها، بل يشجع على إدارة الخلل بالتفاهم والصلح، دون إسقاط قيادة المرأة ما دامت في موقعها السنني.
🔸 مراتب السياسة الإصلاحية:
1. الوعظ: يُخاطب به البعل حين يظهر منه تقاعس أو تخلي عن مسؤوليته.
2. الهجر: يطبّق في سياق التفاعل النفسي لكشف أثر غيابه.
3. الضرب: أي تقليص الشراكة الفعلية والمالية، بما يحفّز الوعي لدى البعل.
🔸 عمرانيًا: هذا النموذج يُحقق أمانة الاستخلاف حين تتحمل المرأة دور القيادة في غياب الطرف المقابل، وتحافظ على بنية الأسرة، مما يجعلها شريكة فعّالة في استمرار الخط العمراني لل
مجتمع.
✦ ثالثًا: الأسرة الأبوية؛ مقام رجولة البعل
هو النموذج السائد في المجتمعات التقليدية، حيث يتولى البعل مقام الرجولة: القيادة، الإنفاق، حماية الأسرة، اتخاذ القرار،
وبالمقابل تتخذ الزوجة مقام التمكين والدعم، بما يضمن استقرار العلاقة وتكامل الأدوار.
🔸 مثال واقعي: هذا هو النموذج الأبوي المعروف في أغلب الثقافات الإسلامية والشرقية والأفريقية، حيث الرجل هو المتصدر، والمرأة تكمّل بناء الأسرة من موقع الدعم الداخلي.
🔸 الآية المفتاحية:
{ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا۟} [النساء: 34]
🔸 مراتب السياسة الإصلاحية عند نشوز الزوجة:
1. الوعظ: خطاب العقل والقيم (يخاطب عبد الإحسان).
2. الهجر: خلق فراغ عاطفي يحفز الإدراك (يخاطب عبد الحرمان).
الضرب: وهو ليس عنفًا، بل إجراء مادي (مثل الخروج من البيت، الضغط المالي، قطع الامتيازات) لتحفيز عبد النكران الذي لا يتحرك إلا عند فقدان المكاسب.
🔸 عمرانيًا: هذا النموذج يُحقق أمانة الاستخلاف حين يمارس البعل مسؤوليته بالقسط، ويحفظ للزوجة دورها في السكن والتمكين،
وتكون السياسة الإصلاحية هادفة لا قمعية، ما يضمن استدامة الاستقرار الأسري.
✦ الخاتمة: الأسرة مرآة الاستخلاف ومحراب العمران
الأسرة في منطق القرآن ليست مؤسسة بيولوجية تُبنى على النوع، ولا عقد شراكة تعاقديًّا يُدار بالمصلحة،
بل هي محراب سنني تتجلى فيه أرقى معاني الإنسانية: الرحمة، والمودة، والتكليف. هي التجلي الأول لأمانة الاستخلاف،
والموضع الأول الذي يُختبر فيه الإنسان: هل يكون عبدًا للإحسان، أم أسيرًا للحرمان، أم جاحدًا بالنكران في الأسرة
تتجسد سنة الزوجية، لا كذكر وأنثى فحسب، بل كـ تفاعل بين الرجولة والنساء، بين من اختار المكابدة، ومن
آثر السكن. والقرآن لا يفرض نمطًا، بل يُقرّ بالتعدد السنني، ويمنح كل نمط قانونَه الإصلاحي الذي يضمن البقاء في دائرة العدل.
فمن وعظٍ يُناجي العقل، إلى هجرٍ يُحاور النفس، إلى ضربٍ يُوقظ الإدراك المادي… تتنزل سياسات الإصلاح كضوءٍ تدريجي
يُعيد للبيت توازنه، لا بعنف القهر، بل بحكمة التدبير. الأسرة إذًا ليست فقط ركيزة المجتمع، بل هي النسخة المصغرة
من العمران الكبير، هي المنصة التي يُصنع فيها الإنسان الجديد، الذي يعرف كيف يحب، ويصفح، ويقود، ويتبع، ويؤثر ويُؤثَر،
ويَحمل مشعل الرسالة في قلب الزمن. وهكذا، لا يعود الحديث عن أنماط الأسرة في القرآن ترفًا سوسيولوجيًا،
بل بابًا من أبواب فهم السنن الإلهية في الاجتماع البشري، وبوابة لفهم الإنسان في حركته الأزلية نحو التزكية،
ونحو بناء عالمٍ أكثر عدلًا، وسكينةً، ورحمة.
دمشق، 25/07/2028