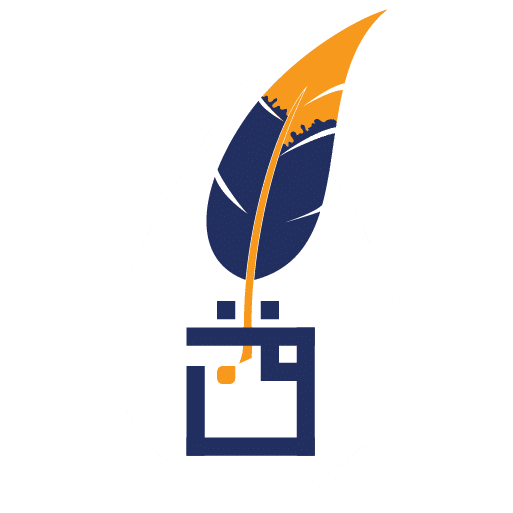الأوديسيا تعود؛ بين ميثال أوديسيوس وسنن يوسف
فهل ضاع العالم من جديد؟!
أيمن قاسم الرفاعي
تمهيد:
في عالم يضطرب مجددًا بالأسئلة الكبرى حول الهوية والوطن والمصير، يعود كريستوفر نولان — أحد أكثر المخرجين المعاصرين استغراقًا في الزمن والوعي والمفارقة الوجودية — ليُعلن عن فيلمه الجديد: “الأوديسيا” لهوميروس.
لا يعتقد أي متابع لنولان أن اختياره عبثيًا، ولا النص اعتباطيًا، ولا التوقيت بريئًا؛ فحين يتداعى النظام الدولي، وتُكسر خرائط المألوف، ويضيع الإنسان المعاصر بهويته بين أمواج التقنية والتيه السياسي والفراغ الروحي، يبرز سؤال: من أنا؟ وإلى أين أنتمي؟ وكيف وإلى أين أمضي؟
لذا في عالم تتشظى فيه فكرة الوطن، ويتآكل فيه مفهوم “المواطنة العالمية” الذي بشّر به النظام النيوليبرالي، ويعيش الإنسان فيه غريبًا عن ثقافته وجسده وذاكرته، يعود أوديسيوس إلى المشهد اليوم، لا ليحكي قصة ماضٍ ميثولوجي، بل ليعكس تيه الحاضر.
الأوديسيا، في عمقها، ليست مجرد ملحمة شعرية عن بطل تائه، بل هي استعارة عن إنسان يبحث عن وطنٍ مفقود، في عالم تحكمه قوى غامضة. واختيار نولان لها، بهذا التوقيت، ما هو إلا إسقاطًا رمزيًا على زمن الانهيارات الغربية، حيث تفقد الحضارة وجهتها، ويبحث الإنسان الغربي عن خلاصه من الرماد الفكري والسياسي الذي أنتجه بنفسه.
لكن، وسط هذا الاحتفاء العالمي المرتقب بهذه الأسطورة القادمة من الماضي بالخلاص للحاضر، تبرز أسئلة جوهرية:
- هل تبقى الأوديسيا ببعدها الفلسفي هي النموذج الأقصى لفهم الهوية والوطن؟
- هل نعود إلى الحكاية والأسطورة لتفسير التيه؟
- وهل الخلاص – فعلًا – مشروط بدهاء البطل، لا بكينونة الإنسان الصادق؟
لقد مضيتُ في تأمل هذه الأسطورة، محاولاً تفكيكها ليس لنقدها أدبياً، بل لأفهم فلسفتها ولماذا سحرَت ملايين البشر على مر الزمان، ولماذا تُستعاد اليوم بهذا الزخم بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام. وحتى يستقيم التفكيك المفاهيمي لن أقرأها في أشعار هوميروس فقط، بل سأستعين بنص آخر، نص فكك الأساطير واستعاض عنها بعبر القصص الإنساني، إنه القرآن، وانا لا استدعيه هنا من باب العقيدة، بل من باب البحث الوجودي الحر، اتساقاً مع الموضوع.
يظهر القرآن في استدعائي ضمن هذا السياق، لا ليُنازع أسطورة أوديسيوس في رموزها، بل ليتجاوزها بمنطق السنن وقوانين الاجتماع الإنساني في قصة يوسف النبي. من هنا، لا نقرأ الأوديسيا منافِسةً للقرآن، بل نقرأها كمُعادل رمزي للوعي الميثولوجي القديم، الذي جاء القرآن ليتجاوزه لا ليُزيّنه، من خلال كشف ضعف الميثال أمام سنن الحق، ويعيد تشكيل صورة الإنسان، من الملك التائه في الفجاج إلى الخليفة على الصراط المستقيم.
ربما أدرك نولان، بما له من ولع بالزمن والوعي، أن الإنسانية تعيش اليوم أوديسياها الخاصة:
- تيه في بحار رقمية بلا مرسى،
- إغواءات استهلاكية بلا قيمة،
- هويات سائلة لا تمسكها أرض،
- وانهيار بطيء للمعنى والقيم تحت ركام الكثرة والشهرة.
وهنا يبدأ التحول في المقارنة: بين أسطورة تُغوينا بجمال رمزي، ونصٍّ يبني وعينا على التكوين والعدل.
الأسطورة كحاجة وجودية
الأسطورة ليست نتاج خرافة، بل تعبير مبكر عن محاولة الإنسان لفهم الوجود قبل تشكل النُظُم العقلانية. وقد أدّت الميثولوجيا عبر التاريخ خمس وظائف كبرى:
- تفسير الظواهر الغامضة (الطبيعة، الموت، الحب، الحرب)،
- تكوين هوية جمعية رمزية،
- بثّ القيم عبر المجاز والرمز،
- تخفيف القلق الوجودي بالتماهي مع البطل،
- شرعنة الأنظمة والسلطة عبر نسب الأسطوري للمقدس.
لكن هذه الوظائف ظلت محكومة بعقل رمزي لا يُنتج قانونًا ولا يقود فاعلية، بل تظل رهينة الخوف من المجهول ومحاولة إضفاء المعنى على واقع لا يُفهم.
وحين نعود إلى القرآن، نجد أنه يواجه هذا الميل الإنساني نحو “الأسطرة” بوصفه عائقًا إدراكيًا، ويفضح كيف يتحول اللجوء إلى “أساطير الأولين” إلى وسيلة للهروب من مواجهة الحقيقة والالتزام بالفعل.
إن مفهوم “الأسطورة” في القرآن ليس محايدًا، بل يُفكَك ضمن سياق أخلاقي ومعرفي: فالأسطورة في الفهم القرآني هي الحكاية التي لا تنتج وعيًا، ولا تُفضي إلى سلوك. إنها خطاب يُشبع الخيال لكنه يُميت الضمير، يُبهج لكنه لا يُرشد. ومن هنا نفهم التكرار القرآني لوصف موقف المعاندين لرسالة التوحيد بأسطرة القرآن: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ المطففين 13 – 14، أي أن ما يُعرض عليهم ليس سوى سرديات ماضية لا تحمل إمكانية للتغيير أو الهداية، هنا يأتي الرد القاطع بـ «كَلَّا»: نفي مباشر للأسطورية، وبيان أن المشكلة في قلوب المغلفة بمكتسباتهم المعرفية والقيمية الباطلة، أي بالبارادايم الخاص بها لا في النص نفسه.
وفي المقابل، يتبنى القرآن منهجية قصصية قائمة على مبدأين جوهريين:
- مبدأ السننية: حيث لا سرد عبثي ولا مشاهد معزولة، بل بيان لقوانين تحكم الأفراد والمجتمعات. لكل فعل نتيجة، ولكل مسار عاقبة، ولكل اختيار أثر لا يُمحى.
- مبدأ العبرة التكوينية: لا تُروى الحكاية من أجل التسلية أو العظة المجردة، بل من أجل تأسيس رؤية للفعل البشري في سياق التاريخ والكون. العبرة ليست لحظة عاطفية بل تحول في الوعي يُفضي إلى الفعل.
القصص في القرآن لا يدور حول بطولة فردية منعزلة، بل حول تجارب إنسانية تشكّل ملامح القانون الكوني الذي يحكم حركة الإنسان والمجتمع. القصص القرآني يُحرر الإنسان من وهم الحتمية الأسطورية ليمنحه مساحة الفعل الحر ضمن نظام مضبوط بالعدل.
بهذا يصبح القصص القرآني نقيضًا للميثالوجيا: لا سردًا للدهشة، بل إدهاشًا بالمعرفة؛ لا تكرارًا للغموض، بل تأسيسًا للبصيرة؛ لا تماهٍ مع البطل الفرد، بل هداية للإنسان الكلي الذي لا يُعرف قدره إلا بفهمه للسنن التي تحكمه.
أوديسيوس ويوسف بين الأسطرة والسنن
عبر التاريخ، ظل الإنسان مشدودًا إلى الحكاية بوصفها مرآةً لقلقه ووسيلةً لإعطاء معنى للعالم الذي يحيط به. ومع نشوء الميثولوجيا، وجد العقل البشري نفسه أسير أسطرة المصير: حيث تتحول الحياة إلى لعبة قوى غيبية متقلبة، وتصبح البطولة نتاج الحيلة أو المصادفة. في هذا السياق، تشكل الأوديسيا مثالًا كلاسيكيًا لهذا النمط من التفكير: الإنسان الفرداني الذي يُحكم عليه بالتيه ويُنقذ بدهائه في عالم بلا سنن.
أما القرآن فقد جاء ليعيد صياغة هذه العلاقة بين الحكاية والمصير. لقد جاء ليحرر العقل من سطوة الأسطرة ويؤسس لنمط جديد من الفهم يقوم على “السنن”: أي على قوانين يمكن إدراكها، والتفاعل معها، وتحمل تبعاتها.
هنا لا يعود الإنسان رهينة أهواء غيبية أو حكايات مكرورة، بل يصبح مسؤولًا عن مصيره ضمن شبكة من العلاقات الأخلاقية والكونية المحكمة. ومن هذا المنظور، فإن المقارنة بين “الأوديسيا” و”قصة يوسف” ليست مجرد مقارنة بين نصين، بل هي مقارنة بين رؤيتين للعالم: واحدة تؤبد التيه والعبث، والأخرى تؤسس للعدل والفاعلية.
في الأوديسيا، لا يقود الإنسان مصيره بناءً على مبدأ أخلاقي أو سنني، بل على تقلبات الآلهة، ومكر الفرد، ومصادفات المصير. إنها سردية ممتعة، لكنها في العمق، تعكس تصورًا عبثيًا لمصير الإنسان. حيث تقوم الأوديسيا على سبعة مفاهيم ومبادئ ضمنية:
- أن البطولة حيلة لا تزكية: يظهر ذلك في لجوء أوديسيوس إلى المكر والخداع مرارًا، كما في خداعه للعملاق بوليفيموس (السيكلوب) بتسمية نفسه “لا أحد”، لينجو بالحيلة لا بالقيمة الأخلاقية.
- أن المجد لا يُنال إلا بعد رحلة تيه: أوديسيوس لا يصل إلى مجده إلا بعد عشر سنوات من الضياع والمعاناة بين الجزر والمحن، في رحلة عبثية الطابع، يصبح فيها التيه شرطًا لا مفر منه.
- أن مصير الإنسان مرتهن برضا قوى غيبية مزاجية: الآلهة في الأوديسيا، وأبرزهم بوسيدون، يتحكمون بمصير أوديسيوس على نحو مزاجي لا يخضع لمنطق أخلاقي.
- أن الهوية يجب إخفاؤها للبقاء: طوال عودته، يُضطر أوديسيوس إلى التخفي، وإخفاء هويته الحقيقية، سواء أمام الأعداء أو حتى عند عودته إلى بيته، حيث لا ينتصر إلا بإخفاء شخصيته.
- أن الزمن يُستهلك لا يُستثمر: السنوات الطويلة التي يقضيها أوديسيوس في الأسر أو التيه (كما في جزيرة كاليبسو) تمثل وقتًا ضائعًا لا يثمر إلا الانتظار والشكوى.
- أن الفتنة بالأهواء معيار للفوز: المغريات التي يواجهها — من السيرينات إلى كاليبسو — تمثل اختبارات يفوز فيها ليس بالتحول الأخلاقي بل بالفرار أو التغلب بالمراوغة.
- وأن العودة الكبرى هي إلى البيت لا إلى الحق: ذروة الأوديسيا هي العودة إلى إيثاكا واستعادة العرش والزوجة، دون تحول وجودي أو معنى متجاوز، فالنصر مادي مكاني لا معنوي.
- العفّة السلبية والغواية المغفورة: تمثّل العلاقة بين أوديسيوس ونساء الحكاية—من بينلوب الصامتة إلى الساحرات الإغوائيات—انعكاسًا لمفهومٍ ميثولوجي يرى العفّة كحالة انتظار سلبية، والغواية كاختبار يُجاز فيه البطل بانتصاره المادي لا الأخلاقي. فلا بينلوب تملك فعلاً يُبدّل المصير بعفتها الصامتة، ولا أوديسيوس يُحاسب على مروقه وعلاقاته الصاخبة، بل يُحتفى بهما بوصفهما رمزين لشهوة الأرض لا لسموّ الإنسان.
في المقابل، تقدم قصة يوسف في القرآن صورة نقيضة تمامًا لهذه الرؤية الأسطورية، حيث يُعاد بناء مفهوم الإنسان والمصير ضمن شبكة دقيقة من السنن والتزكية والغاية. وتستند هذه القصة إلى سبعة مفاهيم قرآنية كبرى:
- البطولة بالتزكية لا بالحيلة: يوسف لا ينجو بدهاء أو خداع، بل بصبره وطهارته الداخلية التي تجعله يرتقي فوق فتنة الإغواء (﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ يوسف:90).
- التمكين بعد تجربة الابتلاء لا بعد اختيارات التيه: المجد في قصة يوسف لا يأتي من ضياع عبثي بل من سلسلة ابتلاءات تُختبر فيها النفس ثم تُعطى “تمكينًا” (﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ يوسف:56).
- مصير الإنسان رهين بسنن العدل لا بمزاج الآلهة: قصة يوسف تكشف أن المصير مرتبط بسنن أخلاقية ثابتة، لا بقرارات اعتباطية أو حظوظ عمياء (﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ يوسف:90).
- الهوية المعلنة لا الهوية المتخفية: يوسف لا يختبئ خلف قناع أو يخفي نسبه، بل يُعلن هويته بقوة في اللحظة الحاسمة (﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي﴾ يوسف:90).
- الزمن كطريق للتكوين لا كاستهلاك فارغ: الزمن في قصة يوسف ليس تيهًا بل مسارًا سننيًا يُبنى فيه الوعي ويُثمر فيه الصبر من بداية سيارة يوسف وسجنه وتمكينه، إلى حزن يعقوب على يوسف ولكذب ابنائه ثم بنيامين ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ يوسف:83).
- الفتنة كاختبار لا كمعيار للفوز: في اللحظة التي يقع فيها أوديسيوس ضحية فتنة الساحرات، ينتصر يوسف بصفاء الداخل ويخرج من ابتلاء زليخة أكثر صفاءً ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ يوسف:23).
- العودة إلى المعنى لا إلى المكان: في ذروة قصة يوسف القرآنية، لا تكتمل الرحلة بالعودة المكانية فقط، بل بالعودة الوجودية إلى جوهر الغاية التي من أجلها كُوِّن الإنسان: العدل، الرحمة، واكتمال الرؤية. فاللحظة التي يجمع فيها يوسف شمل العائلة ويرفع أبويه على العرش ليست لحظة انتصار مادي أو استرداد أرض غابت، بل هي لحظة اكتمال معنى واستيفاء دورة وجودية كاملة. كما قال: ﴿يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (يوسف:100). وهنا تتبدّى المفارقة القرآنية العميقة: فالوطن الحقيقي ليس الأرض التي يُولد فيها الإنسان ولا المساحة التي يعود إليها جسدًا، بل هو اللحظة التي يتحقق فيها معنى الوجود، حين يلتقي الفعل بالتزكية، والمحنة بالحكمة، وتغدو العودة عودة إلى الذات المستنيرة، لا إلى المكان المجرد. إن الأرض وعاء العيش، أما الوطن في الرؤية القرآنية فهو تحقق الإنسان في مسيرته الأخلاقية نحو كماله الإنساني ورضا ربه. بهذا تتحول قصة يوسف إلى نموذج قرآني يعيد تعريف البطولة والمصير والتاريخ والهوية ضمن رؤية تُمكّن الإنسان لا أن تُضيّعه، وتربطه بقوانين الوجود لا بأهواء الحكاية. وتكشف هذه القصة كيف يُبنى الإنسان لا بوهم الخلاص، بل بحقيقة الكدح نحو الحق.
- العفّة كاختيار والغواية كمحنة: تقف قصة يوسف بوصفها إعلانًا سننيًا بأن العفّة ليست انتظارًا بل اختيارًا واعيًا. ففي لحظة الغواية، لا تُختبر زليخة وحدها بل يُختبر يوسف ذاته، وتصبح العفّة فعلًا يُعيد تشكيل المصير لا مجرّد صبر. وهكذا تتحرر الهوية من لعبة الرغبة، ويُعاد تعريف البطولة بوصفها سموًّا أخلاقيًا لا مجرد نجاة أو انتصار جسدي.
القفلة:
وهكذا، يعود لنا نولان بالأوديسيا… لا كحكاية من زمن غابر، بل كمرآة معلقة في وجه العالم، في حاضرٍ تهاوت فيه خرائط اليقين، وضاعت منه معالم الوطن، وتكسرت في يديه بوصلات الإنسان في بحار العدم. فلا مدنَ مستقرة، ولا هويات صلبة، ولا رؤى تؤوي الروح في زمن تُستبدل فيه الحقيقة بالفراغ، والمعنى بالمظهر، والإنسان بالسلعة.
لكن على الضفة الأخرى في رؤانا، لا ينهض يوسف كرمز ديني فقط، بل كمعادل وجودي لإنسان يبحث عن خلاص يتجاوز المكان إلى المعنى، يتجاوز الحكاية إلى القانون، ويتجاوز العبث إلى العدالة.
ما بين الأوديسيا وسورة يوسف، تتأرجح البشرية، وتنفصل الطريقان: طريقٌ يعيد إنتاج التيه تحت ألف قناع، وطريقٌ يُعيد بناء الإنسان على سنن لا تخون.
وهنا لا تُطرح الأسئلة عن الأبطال..
بل عنّا نحن: هل نحن الراحل الأبدي خلف سراب الحكاية، أم العائد إلى جوهره، إلى تأويل رؤياه، إلى وطنه الحق؟
بل قل عن العالم بأسره الذي نعيش فيه: هل يستمر في كتابة أسطورته القديمة بأقلام جديدة، أم سيجرؤ – ولو مرة – على كتابة حكايته بلغة الحق؟
ستظل الأوديسيا ملحمة أسطورية تعود وتعود،. هذا قدر الحكاية..
لكن يبقى السؤال الحقيقي: متى يعود الإنسان إنساناً؟
الدوحة
06/07/2025