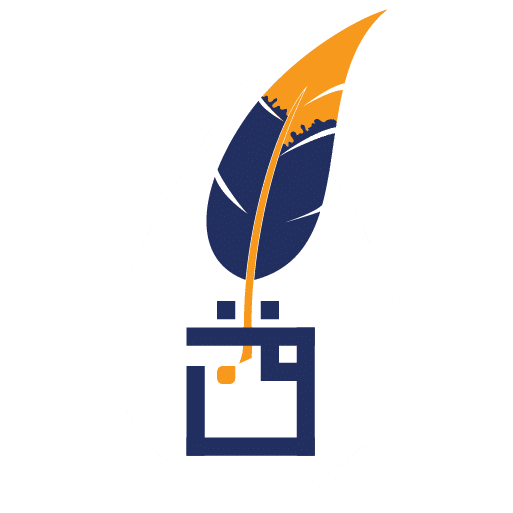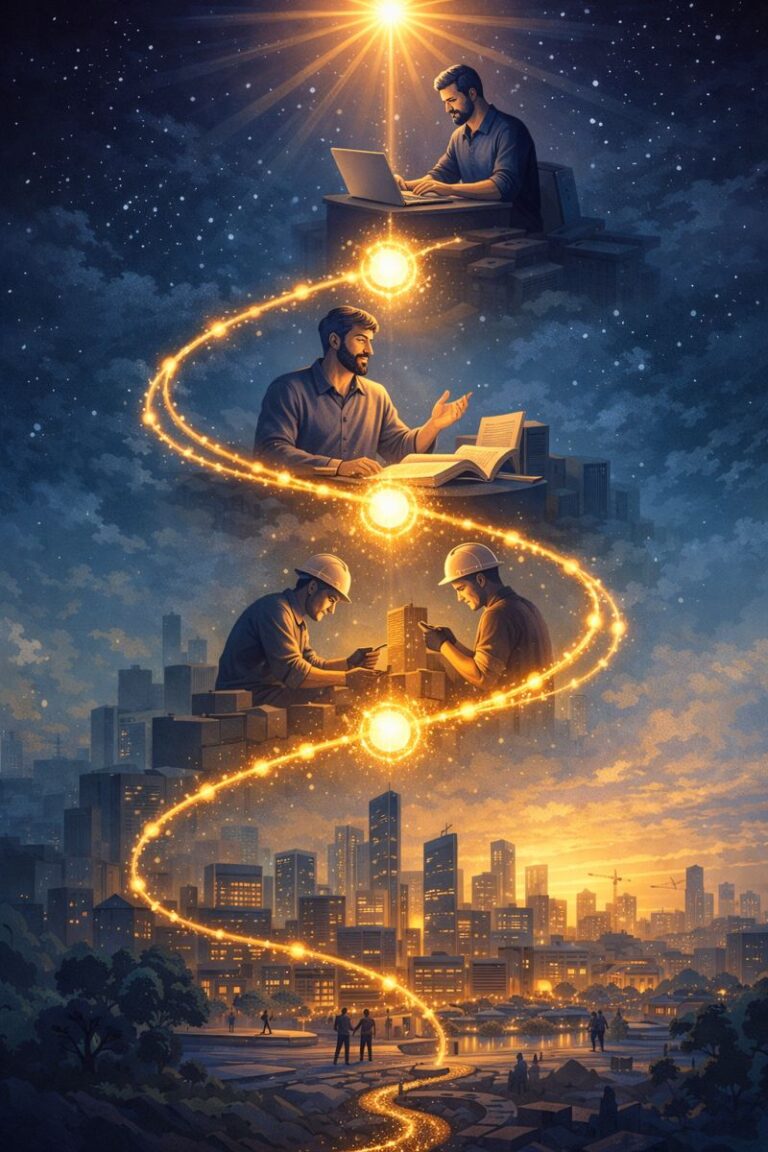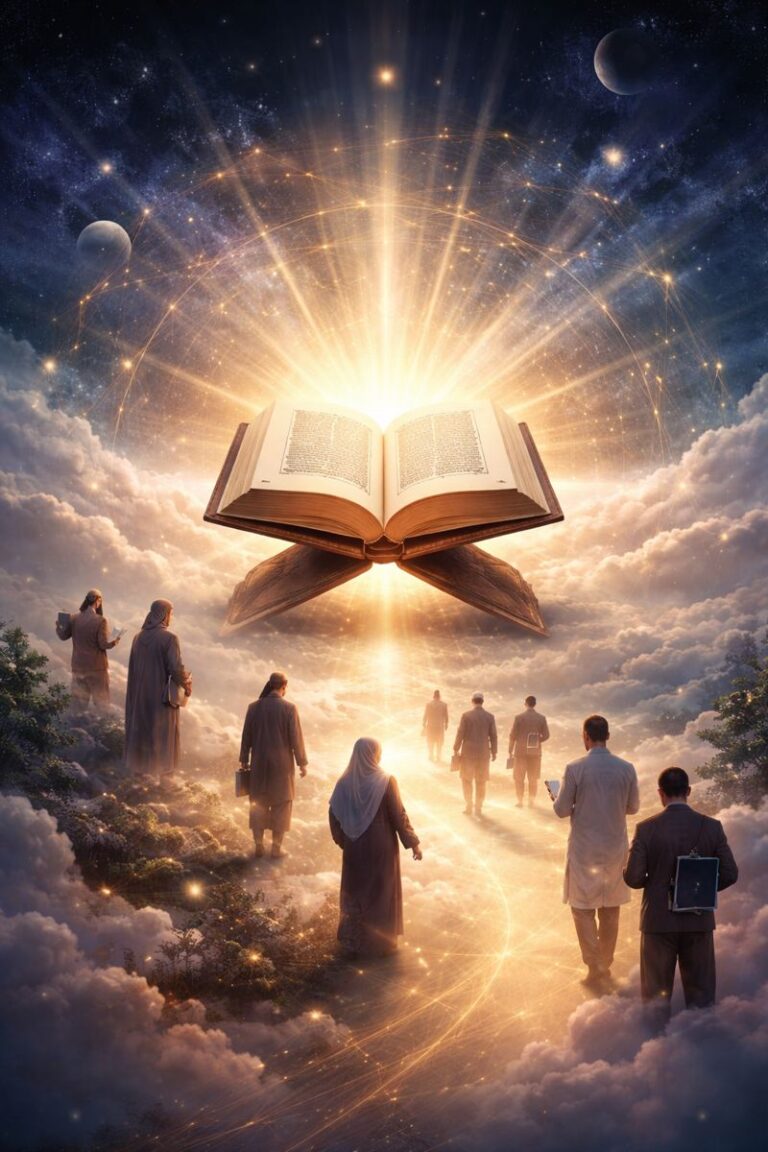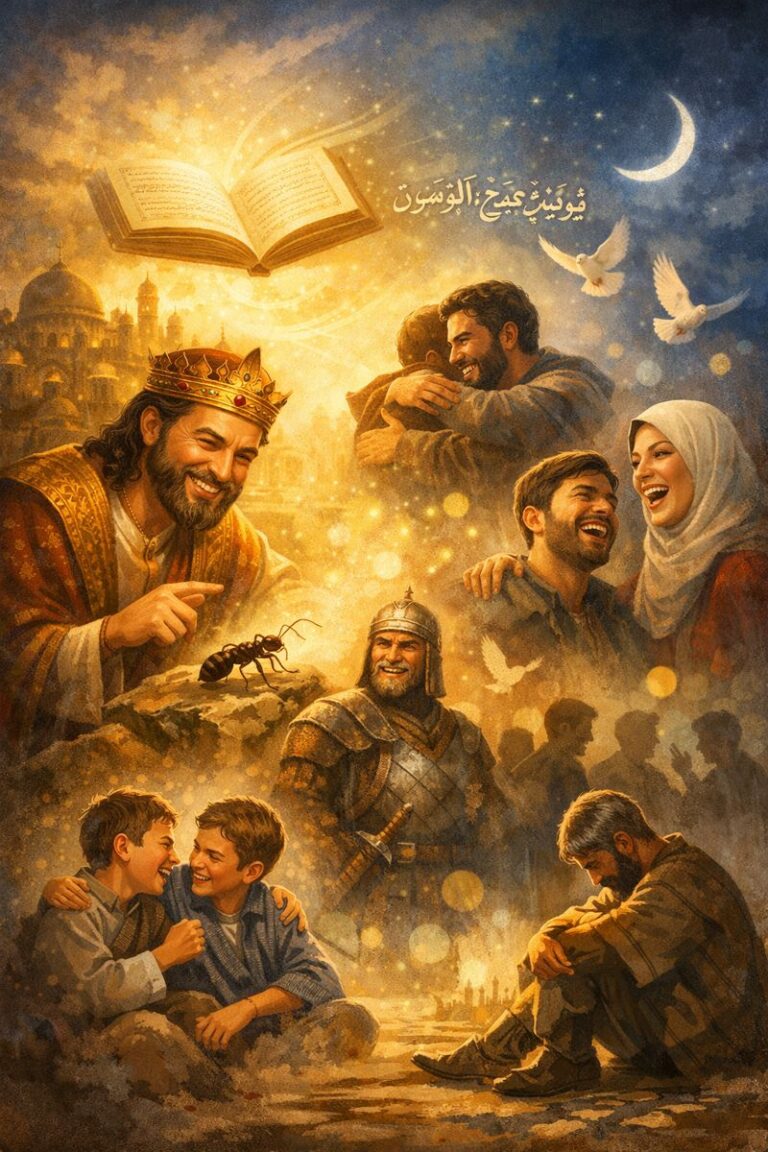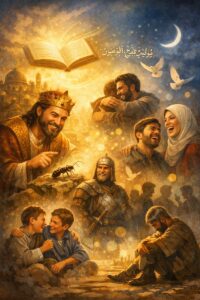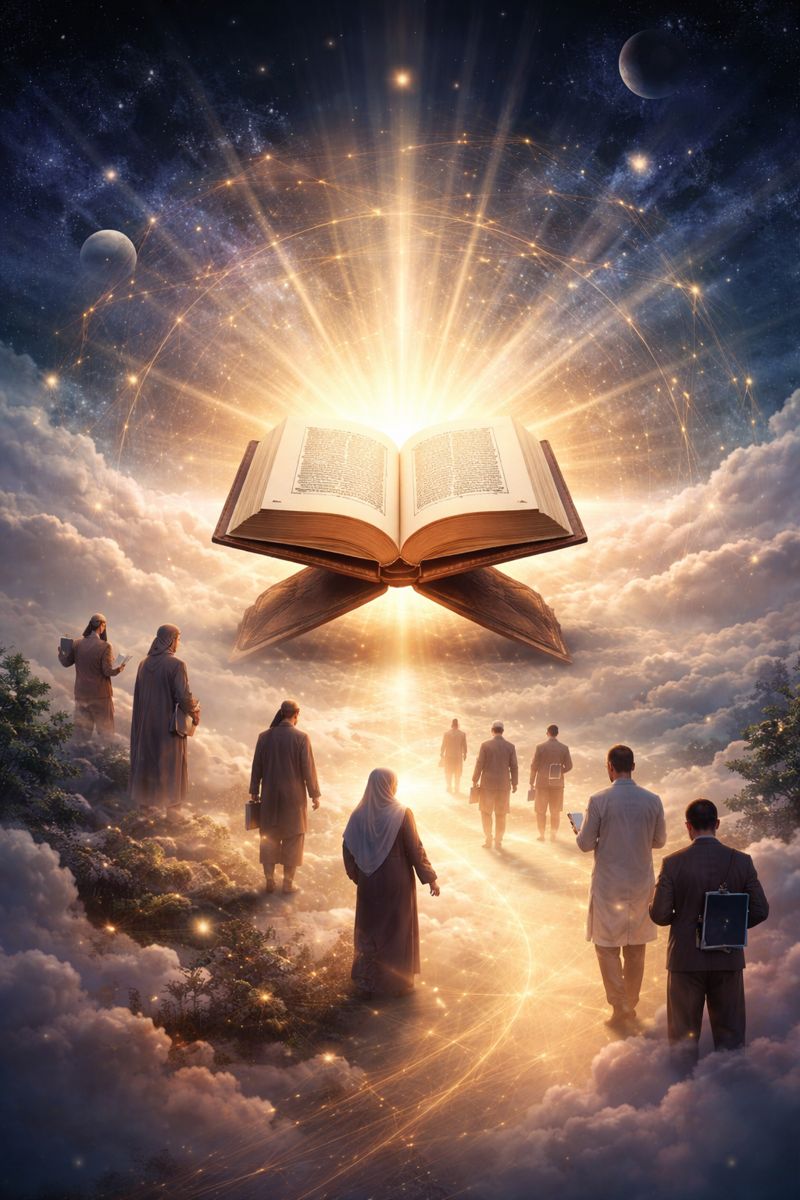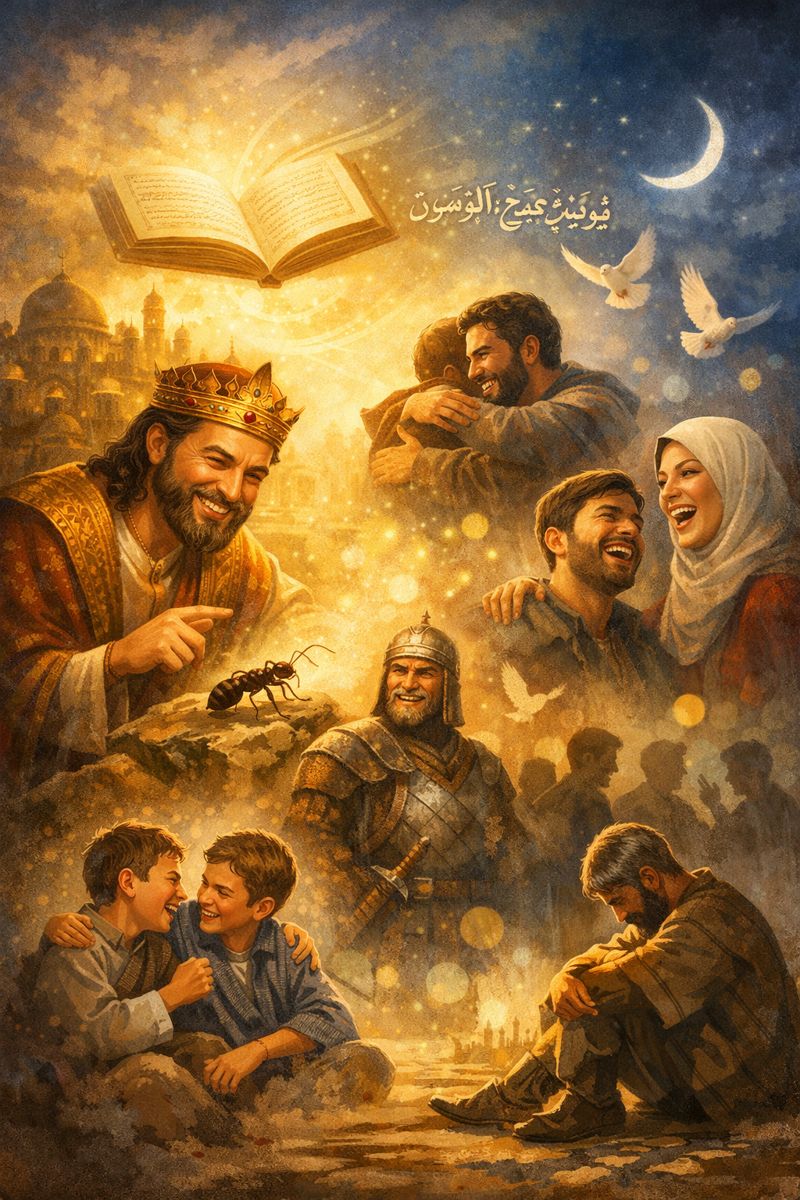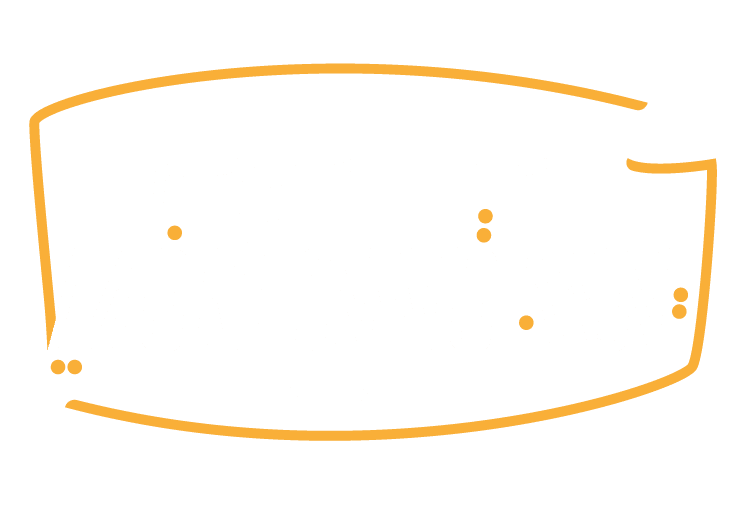الإنسان: من فطرة الهلع إلى سننية الصلاة
أيمن قاسم الرفاعي
أولأ: من الطقس إلى الأثر… كيف تتحوّل الصلاة إلى معمار لتطهير الفعل الإنساني
1) المنظور
﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾. (المعارج: 33)
هذه الآية خبرية، بالتالي فهي سننية ذات نسق ناظم لمكوناتها وعناصرها وفق ناموس إلهي واضح النص ميسر الفهم لمن يسر الله له ذلك. إذن نحن أمام قانون سنني لا أمام حكم أخلاقي.
فهذه الآية لا تتحدّث عن “طبعٍ نفسيّ” ثابت للإنسان، بل تكشف قانونًا بنيويًا في السلوك البشري: أن الإنسان، في أصل تكوينه، قابل للاختلال الانفعالي بين الهلع عند الشرّ و المنع عند الخير. وهذا ليس توصيفًا قيميًا بقدر ما هو توصيف لنقطة الضعف المركزية في البنية البشرية؛ نقطة العطب التي تُبنى عليها كل مسارات التزكية.
2) الترتيل
- الهلع
ورد الجذر (ه ل ع) في القرآن مرة واحدة فقط في هذا الموضع. وهذا الندرة اللفظية تجعل المفهوم محصورًا في هذا السياق، لا متناثرًا في غيره.
و”الهلع” في بنائه اللغوي هو (انهيار مركز التوازن النفسي في الإنسان عند تغيّر الظروف، وشدة درجته تتناسب مع درجة الرصيد الإيماني القيمي لدى الإنسان نفسه)؛
وفي الآيات أنّ الإنسان حين يُمسّه الشرّ، يصبح “جزوعًا”، أي تتحوّل رؤية للعالم لديه من سعة مشاركة ظروف طبيعية الحياة مع الآخرين إلى ضيق التهديد في فرده، فيتحول حاله من السكون إلى التوتر، ومن الاتزان إلى التشتّت.
وحين يُمسّه الخير، يصبح “منوعًا”: إذ تتحول رؤيته للعالم لديه أيضاً من سعة مشاركة موارد طبيعية الحياة مع الآخرين إلى ضيق الخصاصة في نفسه، فيتحول حاله من التبسط إلى التعالي، ومن التواصل إلى الاحتجاب،
وفي كلا الحالين يتبدّل البناء الأخلاقي من سعة الإنسان إلى ضيق الفرد، وبالتالي الهلع اختلال في استقبال المقادير، سلبًا على مستوى الإنسان، وذلك في الحالة غير المترقية إلى إنسان القيم الإنسانية السامية.
- الجزع والمنع
الجزع = انهيار في قيم الصبر وحسن الظن المنع = انهيار في قيم التشارك والكرم
وهما قطبا الاختلال عندما لا يكون الإنسان مضبوطًا بمنهج أعلى من ذاته.
3) التدبّر – كشف العلاقات البنيوية
القرآن هنا لا يصف الإنسان لينتقص منه، بل ليكشف الحالة الأولية قبل التزكية. وكأنّ الآية تقول: هذا هو الإنسان في صورته الخام، قبل دخول قيم الوحي بالمعرفة الإلهية عليه، هو كائن يتأرجح بين الانهيارين إنسانيين بسبب انهيارين قيمين: انهيار الجزع، وانهيار المنع.
والعلاقة البارادايمية هنا واضحة: فالتزكية ليست تحسينًا إضافيًا، بل معمارٌ يعيد بناء “بنية الاستقبال”، ولهذا تأتي “إلا الذين” كاستثناء مُنظّم، لا كخبر لغوي.
4) الاستثناء – وظيفة الصلاة في ضبط البنية البشرية
﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾
ليست الصلاة هنا “عادة” أو “فعلًا طقوسياً شعائريًا”، بل اتساق إنساني مع نظام الضبط الكوني. والدوام هنا ليس “كثرة وتكرار” بل اتصال الحال لرسوخ المفهوم، بمعنى الصلاة هنا مرتبطة بمفهوم إقامة الصلاة المفروضة وليس أداء الصلاة المكتوبة فحسب.
﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠ البقرة﴾
أي أن الصلاة بمفهوم الإقامة – والتي يؤكد عليها القرآن في معظم مواضعها – تعني الصلة الدائمة بالله من خلال تطهير الأفعال بربطها بالقيم الإلهية السامية، وهي تُنتج وجودًا نفسياً إنسانياً مستقرًا يواجه أحداث الحياة، لأن من اعتاد تفعيل قيم الأخلاق السامية في سائر أفعاله والتي فيها بطبيعتها يتعدى أثرها للآخر، نفسه ستقيم على اطمئنان فطري لا تلقيني أنها بمعية الله، ومن قدم قيم الخير في أفعاله لم تصبه قيم الشر مهما تبدلت الظروف. وبالتالي تصبح النفس محصنة من القيم السلبية، فلا جزع عند الشر، ولا منع عند الخير.
وبمنظور بارادايمي: إن الصلاة هنا والتي هي نظام إعادة توليف العلاقات بالآخرين من خلال تطهير الأفعال كما رأينا، تصبح بالضرورة مركز التوازن الداخلي بما ينشأ عنها من انعكاس لأفعال الإنسان الخيرة الخارجة منه، إلى قيم خيرة داخلة إليه، وذلك لإن الإنسان الطبيعي: ينكسر عند الألم، وينقبض عند النعمة.
أما المصلي الدائم في الصلاة الوجودية لا المكرر لها في الطقوسية الشعائرية، فقد تحوّلت الصلاة عنده إلى مِعيار استقبال مستدام للحياة. لهذا كان الاستثناء يبدأ منها، ويعود إليها، ويُبنى عليها.
ولأنّ الصلاة في هذا السياق ليست الصلاة المكتوبة الشعائرية، بل الصلاة المفروضة التي يكررها القرآن بشرطين بنيويين: إقامتها واقترانها بالزكاة – أي تطهير الفعل والمال – جاءت الآية: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ 45 العنكبوت﴾
لتكشف قانونًا سننيًا لا علاقة له بالردع الأخلاقي المباشر.
فالنهي هنا ليس وظيفة وعظية، بل نتيجة بنيوية تَنتُج حين يقيم الإنسان الصلاة بمعناها القرآني: تصحيح مسار أفعاله وتطهير أثره من خلال صلته بالله وقيمه.
وبهذا، يصبح الفحشاء والمنكر – في المنظور البارادايمي – اختلالًا في الأثر، لا خطيئة مجردة. وعندما يطهّر الإنسان أفعاله من خلال إقامة الصلاة (لا أداء الشعيرة فقط)، تتشكل داخل النفس بنية وقائية تمنع تشكّل الفحشاء والمنكر قبل وقوعهما، مثلما ان تجسيد إقامة الصلاة من خلال تطهير الأفعال تؤكد عدم حدوث الفحشاء والمنكر أصلاً في الواقع، وذلك لأن الفعل نفسه يصبح مشدودًا إلى ميزان القيم لا إلى اندفاع الحاجة والرغبة.
ولهذا، تتطابق الآية تمامًا مع النسق القرآني العام: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.
أي: طهّروا الأفعال وطهّروا الأملاك، فإذا تطهّر الفعل والمال، استقام الصراط، وإذا استقام الصراط، انتفت أسباب الفحشاء والمنكر من جذورها.
5) التعمّق السنني
في ضوء “بارادايم القرآن” يصبح السؤال: لماذا كانت الصلاة هي أداة الاستثناء الوحيدة؟
والجواب:
لأن الصلاة في البنية القرآنية ليست “عبادة شعائرية شخصية”، بل هي “عبادة سلوكية متعدية” وبذلك تتحول إنسانياً إلى وسيلة لتحديد الصراط، والصراط هو نظام الحياة، فإما تشتت وتيه، او استقامة ومضي. ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 45 العنكبوت﴾
ومَن استقام على الصلاة استقام على الصراط، ومن استقام صراطه عرف الطريقة ومن عرف الطريقة اطمأنت نفسه، ومن اطمأنت نفسه خرج من الهلع. إذن: الهلع ليس مرضًا نفسيًا، بل فراغًا سننيًا. والصلاة ليست مجرد علاجٍ روحيٍ طقسيٍ، بل هي بنية سننية ميتافيزيقية صممها الصانع لضبط الإنسان على قانون الكون.
6) النتيجة البارادايمية
إذا جمعنا عناصر التحليل، نجد:
- الإنسان في أصله قابل للاختلال الانفعالي عند تقلب المقادير.
- هذا الاختلال يتجلى في: جزع عند الشر + منع عند الخير.
- لا يخرج الإنسان من هذا الاختلال إلا بدخول نظام الصلاة.
- الصلاة هنا ليست شعيرة، بل عملية تنظيمية للوعي الإنساني والبناء الجمعي.
- الدوام في الصلاة يعني: أن تكون الصلاة مركزًا لبنية إدراكه لا مجرد أوقات محددة للشعائرية.
- بمقدار التزام الإنسان بالصلاة كصراط، يخرج من ثنائية (جزوع/منوع) إلى حالة الإنسان السامي.
بكلمة بارادايمية جامعة: هذه الآية ترسم الحدّ الفاصل بين “إنسان الطبيعة” و”إنسان الصراط”.
طبعاً هذا الكلام لا يسقط الصلاة كشعيرة، بل يؤكد ويصوب وجودها لكن في دائرة الحاجة الإنسانية لذات الإنسان وليس الواجب عليه، وذلك لضمان استمرار الإنسان على الصلاة المفروضة الواجبة تلك المتعلقة بالسلوك والآخر، وهذا ما يوضح القسم الثاني من المقال في الفقرة التالية.
ثانياً: الصلاة المكتوبة كحاجة إنسانية لا كعبء تشريعي:
حين يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 103 النساء﴾،
تبدو القراءة التقليدية وكأنها تأمر بالفعل الشعائري المحدّد زمنًا، ولكن الآية بمنظور سنني لا تتحدث عن “الوجوب الإجرائي” فحسب، بل عن توقيتٍ تناسبيّ مع حياة الإنسان نفسها.
فالـ “كتابًا” هنا ليست بمعنى الفرض المغلق، بل بمعنى الإثبات والتقدير والجواز ضمن أوقاتٍ محددة، أي أنّ الله لم يفرض الصلاة في لحظة مستمرة، بل جعلها متقطعة، مقطّرة عبر اليوم، لأن الإنسان لا يتحمّل الالتحام الروحي المطلق ، وهذا من رحمة الله وسننيته.
تماماً هذا ما يجعل الصلاة المكتوبة:
- شعيرة قابلة للتحريك والتخفيف والاستبدال جزئيًا
تمامًا كما فعل القرآن في كل مواطن الأحكام المكتوبة:
- الصوم: من فرضٍ إلى فديةٍ عند العجز
- الزكاة: من أصل ثابت إلى نسب متغيرة (آل عمران 134)
- الحج: من وجوبٍ إلى استبدالٍ عند فقدان الاستطاعة
- الوضوء: يُستبدل بالتيمّم
- الطهارة: تُستبدل بالتراب
- القتال: مشروط، يتأرجح بين فرض وتحريم وتعليق
هذا النمط القرآني المتكرر يؤكّد: حين يكون الحكم تعبديًا، تظهر مساحة المرونة – لا التعجيز – لأن الهدف ليس الطقس بل الإنسان.
فالصلاة المكتوبة ليست “واجبًا جبريًا” بل محطّاتٌ وجودية مرنة أُسّست حول طبيعة الإنسان لا حول صرامة الطقس.
- الشعيرة حاجة إنسانية وليست مجرد تكليف
الصلاة ليست “واجبًا يؤديه الجسد”، وإنما خلوةٌ يومية مُنتظمة تمنع الإنسان من الذهاب إلى فوضى العالم بلا نقطة اتزان.
هي خلوة قصيرة لكنها مُنقذة، تشبه في وظيفة النفس ما يشبهه “إعادة تشغيل النظام” في الحاسوب.
الإنسان الطبيعي يضطرب، يتعب، يتشتت، ينفجر غضبه أو يضيق صدره ، والصلاة هنا تعمل كـ مكثّف للطاقة الروحية، ومصفاةٍ للنية، ومهدّئٍ للوجدان.
وهذه الوظيفة ليست رفاهية روحية؛ إنها ضرورة وجودية أشدُّ أصالة حتى في المفاهيم الحداثية من اليوغا والطاوية والتأمّل الشرقي:
- اليوغا تقوّي الهدوء الجسدي
- الطاوية تقوّي الانسجام مع الكون
- التأمل التجريدي يكسر توتر العقل
لكن الصلاة تجمع الجسد، والروح، والقيم، والآخر في حركة واحدة:
- سجود يعيد توازن الجسد
- ذكر يعيد توازن القلب
- حضور يعيد توازن العقل
- تواصل بالقيم يعيد توازن السلوك
ولهذا كانت الصلاة أعمق من كل الطقوس الشرقية، لأنها ليست تأمّلًا داخليًا فقط، بل تأمّلًا يتعدّى إلى العالم عبر إقامة الفعل الخيّر.
- الشعيرة ضمانة لحماية الصلاة الكبرى: صلاة السلوك
الصلاة المكتوبة – في عمقها السنني – ليست النهاية، بل الوسيلة التي تحافظ على “الصلاة الكبرى” التي تحدّثتَ عنها:
الصلاة التي تتحقق في إقامة القيم مع الآخر، والشعيرة ليست بديلًا عن السلوك، بل مذكّرًا دائمًا به.
هي بمثابة:
- علامة الطريق
- نقطة المعايرة
- محطة إعادة الشحن
- تنبيه للضمير
- محراب مراجعة يومي
لئلا تتحوّل حياة الإنسان إلى انزلاق غير محسوس نحو الفوضى الانفعالية.
ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، لا ليكون الذكر مجرّد استحضارٍ لفظيّ أو وجداني، بل ليكون الفعل الإنساني نفسه – بما يحمله من قيم العدل والإحسان والصراط – هو الامتداد التاريخي لذكر الله في الأرض.
فـ”ذكري” هنا تشير إلى معنى خاص ألا وهو ظهور أثر الإيمان في الواقع، وهو ما يجعل إقامة الصلاة – لا مجرد أدائها – آليةً لضبط السلوك الإنساني ليبقى متصلاً بالقيم الإلهية التي تنسج مسار التاريخ الحضاري، وتحفظ أمانة الاستخلاف على أحسن وجه وفق السنن الإلهية.
فالصلاة، بهذا المعنى السنني، ليست طقسًا يُذكر الله به على لسان الإنسان، بل هي خلوة الانضباط التي يُعاد فيها تشكيل الوعي ليخرج المؤمن إلى العالم وقد صار فعله نفسه ذكرًا لله، وشاهدًا على قيمه، وبرهانًا على أنّ العمران لا يُبنى إلا بإنسانٍ مستقيم الصراط.
- الشعيرة الروتينية تسمو فوق الخلوة الطويلة
في الفلسفات الروحية القديمة، الخلوة الطويلة (الاعتكاف، العزلة، سرداب الحكيم، جبل المتأمل…) هي أداة للترقي. لكن القرآن قدّم مفهومًا أعظم من هذا كله: الخلوة الروتينية القصيرة. فهي:
- أقل استهلاكًا للإنسان
- أكثر ثباتًا
- أقدر على بناء العادة
- وأشدّ حفاظًا على التوازن
- وأقرب إلى الحياة اليومية
- وأبعد عن الطقوس النخبوية
إنها “جرعة يومية” تحرس الروح من الانهيار، وتمنع الإنسان من السقوط في فطرة الهلع.
وبهذا المعنى: الصلاة المكتوبة أعلى من الاعتكاف، لأنها خلوة داخل الحياة، لا خارجها.
- لماذا يحتاج الإنسان الشعيرة؟
لأن الإنسان ينسى، يضيع، ينتكس، يتقلّب، ويحتاج لربطٍ بخيط نورٍ ثابت، وهذا الخيط هو الشعيرة.
فالطقس ليس أثراً جانبيًا للدين، بل أداة لضبط الزمن الداخلي. ولهذا جاءت الصلاة “موقوتة”، موزعة عبر اليوم:
- الفجر؛ لحظة اختيار الاتجاه: بداية اليوم التي يُحدّد فيها الإنسان منطلق فعله: من أي نيةٍ يبدأ، وبأي صراطٍ يسير.
- الظهر؛ لحظة ضبط الدافع: التوقيت الذي يُختبر فيه اتساق الفعل مع القيمة وسط ضغط العمل والعلاقات.
- العصر؛ لحظة تصحيح المسار: المفصل الذي يُراجع فيه الإنسان نتائج فعله ويعيد معايرة قراراته قبل أن يتحول الخطأ إلى قدر.
- المغرب؛ لحظة تأويل الفعل: الزمن الذي ينتقل فيه الإنسان من إنجازاته إلى معنى إنجازاته، فيحمّل فعله دلالته الأخلاقية.
- العشاء؛ لحظة إبراء الفعل: ختام اليوم الذي يُسلّم فيه الإنسان أثر أفعاله لله، فينظّف وعيه استعدادًا لبداية جديدة.
- إنها ليست حركات، إنها هندسة روحية للزمن الإنساني.
الخلاصة
كأنّ الإنسان خُلق وفي قلبه فراغٌ صغيرٌ لا يملؤه شيء؛ فراغٌ يسمّيه القرآن هَلَعًا، ذلك الاضطراب الدفين حين يَهجم الألم، وتلك القبضة الصامتة حين يفيض الخير.
ولأنّ الفطرة وحدها لا تُقيم صراطًا، كان لا بدّ من خيط نورٍ يشقّ هذا التقلّب الإنساني، كوتر طهارة يعزف لحن الحياة طيلة اليوم ويضبط دوزانه في اليوم خمس مرّات، لا ليُثقِل الجسد بوثاق الانقياد، بل ليُخفّف الروح ارتقاء على إيقاع التناغم.
وهكذا يتبدّى أن الصلاة في نظام القرآن ليست فعلًا مزدوجًا بقدر ما هي طبقة واحدة بطبيعتين: طقسٌ يوقّع حضور القلب بين يدي ربّه، وسلوكٌ يوقّع حضور الإنسان بين يدي خلقه.
إنها ليست شعيرةً منفصلة ولا سلوكًا بلا سند؛ بل نقطة التقاء بين البعدَين: فحين يقف الجسد تجاه القبلة، يقف الفعل تجاه قيمها، وحين تُقام الصلاة في الزمن، تُقام الأخلاق في الحدث. وهذا ما يجعلها في الآية استثناءً: أنها ليست هروبًا من الطبيعة البشرية الهلوع، ولا قمعًا لها، بل إعادة ضبطٍ لمجالات الاستقبال داخل النفس، كي لا يتحوّل الشرّ إلى جزع، ولا الخير إلى منع.
فالصلاة – في حقيقتها السننية – هي المعمل اليومي لتطهير الأثر، حيث يغتسل الفعل من أنانيته، وتُصفّى النية من ضجيج الجسد، ويتعلم الإنسان أن يخرج من ذاته ليعود إليها أوسع وأكثر اتساعًا. وعند هذا الحدّ نفهم سرّ تكاملها: فهي طقسٌ لأن الروح تحتاج الخلوة، وهي سلوكٌ لأن العالم يحتاج العدل، وهي ذاكرةٌ لأن التاريخ يحتاج أثرًا، وهي تطهيرٌ لأن الإنسان يحتاج أن يظلّ صالحًا لعمارة الأرض لا لامتلاكها.
بهذه البنية فقط تصبح الصلاة ميزان الإنسان، ومركز استقامته، والجسر الهادئ الذي يعبر به من تيه ووحشة الهلع، إلى سكينة وهدى الصراط.
الدوحة 18/11/2025