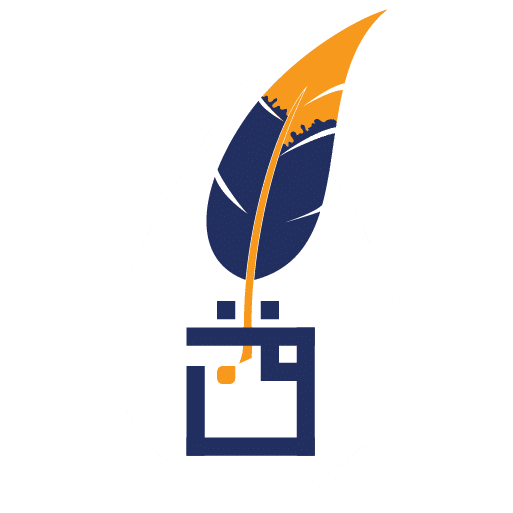أيمن قاسم الرفاعي
في مدارج الفهم القرآني، لم تكن “أسباب النزول” يومًا طريقًا معبدًا إلى المعنى، بل كانت – في أصلها – اجتهادًا إنسانيًا لفهم سياق التنزيل. غير أن هذا الاجتهاد، المشروع في زمن الصحابة على قدر النور المتاح، ما لبث أن تحوّل في عصور التدوين إلى سلطة تفسيرية جامدة، شدّت النص إلى الوقائع، وقيّدته بقيود الرواية، وحنّطت حيويته السننية.
لكن لماذا نعتبر – من منظور بارادايم القرآن – أن اعتماد “أسباب النزول” على هذا النحو قد أضرّ بالفهم، وحنّط المعاني؟ لنفصّل القول، دون تعميم غالٍ، في ضوء ثلاث حججٍ كبرى:
أولًا: القرآن ليس نصًا تاريخيًا… بل خطاب رسالي سنني
القرآن لا يُقرأ ككتاب وقائع، بل كـ هندسة هدى تمضي بقارئها من الظن إلى اليقين، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن الواقعة إلى القانون والسنن. ومن هنا، فإن ربط الآيات بـ”أسباب نزول” تاريخية حصرية يُفسد خاصية “الامتداد الزمني” في النص، ويُحوّله من قانون خالد إلى حادثة منتهية الصلاحية.
فالقرآن كتاب هدايةٍ لا تقف على باب التاريخ، بل تمضي في دروب الإنسان؛ من الحادثة إلى القانون، ومن المشهد إلى النموذج، ومن السؤال إلى الجواب الكلي. ولذلك، فإن اختزال بعض آياته بـ”سبب نزول” واحد، يُصادر أفق التنزيل الذي يُراد له أن يكون مفتوحًا على الزمان، مغروسًا في الإنسان.
فالآيات التي تبدأ بـ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ أو تتحدث عن وقائع، لم تُصغ بلغة الحكاية أو الخبر، بل جاءت في سياق بيان تشريعي أو تربوي أو تحذيري. الله لم يذكر الحادثة، بل ذكر ما أراد من الحادثة أن يكون قانونًا. وإن أراد التنصيص على الواقعة، فعله بصيغة رسالية خالدة:
﴿فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وَطَرًا زَوَّجناكَها﴾ [الأحزاب: 37]
﴿قَد سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّتي تُجادِلُكَ في زَوجِها وَتَشتَكي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌ﴾ [المجادلة: 1]
﴿وَلَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدرٍ وَأَنتُم أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [آل عمران: 123]
﴿وَلَمّا رَأَى المُؤمِنونَ الأَحزابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسولُهُ وَما زادَهُم إِلّا إيمانًا وَتَسليمًا﴾ [الأحزاب: 22]
وكلها تسلك مسلكًا تعليميًا لا حكاويًا؛ إذ إن هذه الآيات – على الرغم من ارتباطها الظاهري بوقائع معينة – لا تُساق في القرآن بقصد السرد أو التأريخ، بل لتؤسس قاعدة تربوية أو تشريعية أو سننية. فذكر زيد، والمجادِلة، وبدر، والأحزاب، ليس لتخليد لحظة، بل لتوليد قانون يُستفاد منه في كل لحظة. وهنا تتجلى عبقرية البنية القرآنية التي تُحوّل الواقعة إلى قانون، والمشهد إلى قاعدة، فتخرج الحادثة من محليتها لتغدو دالةً على سننٍ جاريةٍ في الاجتماع الإنساني ومسار الرسالة..
ثانيًا: أغلب “أسباب النزول” روايات غير قطعية، متضاربة، وتعاني مشكلات إبستمولوجية
من حيث الصناعة الحديثية، فإن أكثر “أسباب النزول” غير متفق عليها، بل نجد للآية الواحدة رواياتٍ متعددة، تحمل تضاربًا في الحدث والزمن والسياق. وهذا يشير إلى أنها لم تكن سببًا أصليًا بل محاولة فهم لاحقة، أو إسقاطًا تأويليًا على النص.
ولعل من أقوى الشواهد على ذلك:
1. آية اللعان (النور: 6): قيل إنها نزلت في هلال بن أمية، وقيل في عويمر العجلاني، وكلاهما من روايات صحيحة لكنها متعارضة، كما ورد في:
الطبري، جامع البيان، 18/118
الواحدي، أسباب النزول، ص: 308
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 3/284
2. آية ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ (البقرة: 189): اختلفت الروايات هل كان السؤال عن تغيّر شكل الهلال، أم عن حكمته الشرعية، مما يُغيّر مقصد التنزيل تمامًا:
الطبري، جامع البيان، 3/516
الواحدي، أسباب النزول، ص: 28
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1/504
3. سورة الكوثر: رُوي أنها نزلت في الرد على العاص بن وائل، وقيل في ذم أحد المشركين، وقيل في بيان فضل النبوة، واختلفوا في معنى “الكوثر” ذاته:
البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الكوثر
الطبري، جامع البيان، 24/702
الواحدي، أسباب النزول، ص: 505
الرازي، التفسير الكبير، 32/201
4. سورة عبس: الرواية الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ابن أم مكتوم، لكن بعض العلماء نفى ذلك:
الترمذي، السنن، كتاب التفسير، رقم: 3331
الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 1/26
الشنقيطي، أضواء البيان، 5/292
5. سورة الفيل: قصة أبرهة محل خلاف تاريخي كبير، ولم تثبت بإسناد متصل، وأشار بعض الدارسين إلى تداخلها مع روايات أسطورية:
الطبري، جامع البيان، 24/654
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/558
الزركشي، البرهان، 1/25
مقارنات نقدية حديثة في: نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص: 57 وما بعدها
والمشكلة هنا ليست فقط في ضعف الإسناد أو غموض المتن، بل في تحوّل هذه الروايات إلى مِفصلٍ حاكم على المعنى، بحيث يُمنع الفقيه أو القارئ من الاستنباط خارج إطار الرواية، ولو كان السياق القرآني يُشير إلى أفقٍ أوسع وأشمل.
بل إن كثيرًا من هذه الروايات نُقلت عن التابعين أو تابعيهم، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تأويلات سياسية ومذهبية، حُمِّلت على ظاهر النص لتخدم غرضًا مخصوصًا، كما حصل في بعض تفسيرات سور مثل “الكوثر” و”المسد”.
وقد قال الإمام الشاطبي: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن المقصد في البيان إظهار القانون لا ذكر الحادثة (الموافقات، ج3).
ثالثًا: “أسباب النزول” تُقيد المعاني وتُغلق السننية المفتوحة للنص
القرآن لا يتحدث عن أفراد لذاتهم، بل عن نماذج بشرية تتكرر في التاريخ، وتُجسد أنماطًا من السلوك الإنساني في مواجهة الحق والرسالة. وأنت إذا قصرت معنى الآية على “السبب” دون “السنن”، ستحرم النص من وظيفته الرسالية.
لنأخذ مثالًا:
سورة الكوثر: إذا فُهمت على أنها “رد على من قال إن النبي أبتر”، ضاقت عن مقصدها الرسالي، وهو بيان فيض الخير، وتجلي الوفرة وترسيخ القيم والأخلاق السامية في بناء الاقتصاد وإدارته.
سورة المسد: إذا قُيدت بأبي لهب كشخص، غاب عنا النموذج السنني لـ”سيد الشرور”؛ الكيان البشري الذي تمثّل فيه الشر لا بوصفه خيارًا عابرًا، بل بنية وجودية منغلقة على العداوة، خالية من التردد، عصيّة على التوبة، وهو ما يفوق حتى التصور الإبليسي في بعض تمثلاته القرآنية.
سورة الفيل: إذا ربطناها فقط بحادثة أبرهة التي لم تصح تاريخيًا، وكانت منسوجة استعارة عن الأساطير البابلية، فقدنا فهمها كـ قانون سنني ضد الطغيان السياسي ومآلات سقوطه.
إن فهم القرآن وفق “أسباب النزول” التاريخية يُحوّل النص من نظام تفكير سنني إلى أرشيف ردود أفعال، ومن رسالة خالدة إلى ملف إخباري.
الخاتمة: نحو تمييز قرآني بين ما أُثبت وما رُوي
ينبغي التنويه إلى أن هذا المقال الموجز لا يهدف إلى الإحاطة الشاملة بكل أوجه الإشكال المتعلقة بمفهوم “أسباب النزول”، وإنما قصدنا به الإشارة المختصرة إلى الدور السلبي الذي تلعبه هذه الروايات في حرف فهم القرآن عن مقاصده وسننه وهداياته. ونؤكد أن هذا الموضوع يستحق بحثًا علميًا مستقلًا ومتكاملًا، يُعاد فيه فحص وتفكيك جميع المرويات الواردة في أسباب النزول نصًا نصًا، ضمن منهج نقدي صارم يميز بين البيان الرباني الثابت والخبر الإنساني الظني، وبين ما هو داخل في بنية الخطاب القرآني، وما هو عارض عليه من تأويلات لاحقة.
إن أسباب النزول التي يُعتد بها هي ما أثبته الله في قرآنه، وذكره بنص واضح وصريح لغاياته التربوية والتشريعية والبيانية. وأما ما سوى ذلك من مرويات خارج النص، فلا يُعد من البيان القرآني، ولا يجوز أن يُبنى عليه فهم أو استنباط.
تلك المرويات – وإن أفادت في تأريخ التنزيل أو تلوين بعض السياقات – فإنها تخضع لمنهجية الأخبار التاريخية، يُقبل منها ما صح، ويُردّ ما لم يثبت، ولا تُقاس على القرآن في حجيتها ولا في وظيفتها. فهي ليست نصًا مبيِّنًا للقرآن، بل تندرج في جنس الخبر، لا في مقام الوحي.
ومن هنا، فإن تحرير الفهم القرآني من قيد هذه الروايات ليس تجاوزًا للتراث، بل عودة للقرآن ذاته، واستئناف للوظيفة الرسالية التي نزل من أجلها: أن يكون كتاب هدى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
إن بارادايم القرآن يدعونا للعودة إلى القرآن من داخله، لا من خارجه؛ من بنية النص، لا من هوامشه؛ من سننه ومقاصده، لا من رواياته المُحتملة.
فإذا أراد الله أن يبيّن سببًا، بيّنه؛ وإذا سكت، فعلمُه أوسع من أن يُقيد بسردٍ ظني.
فالقرآن كتاب هداية لا كتاب حوادث،
وما لم نفكّ أسر النص من قيد الرواية،
فلن نستعيد رساليته… ولا إنسانيته.
دمشق 26/07/2025