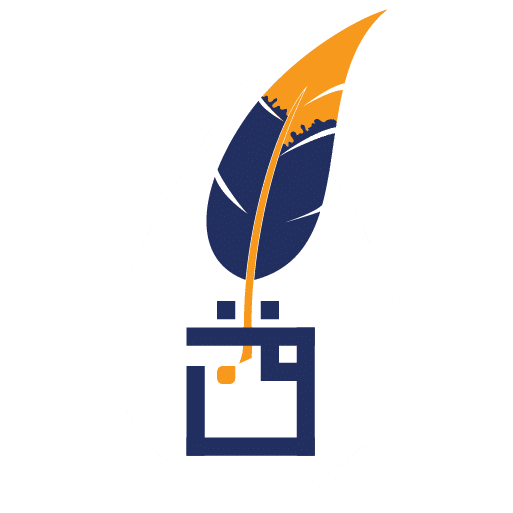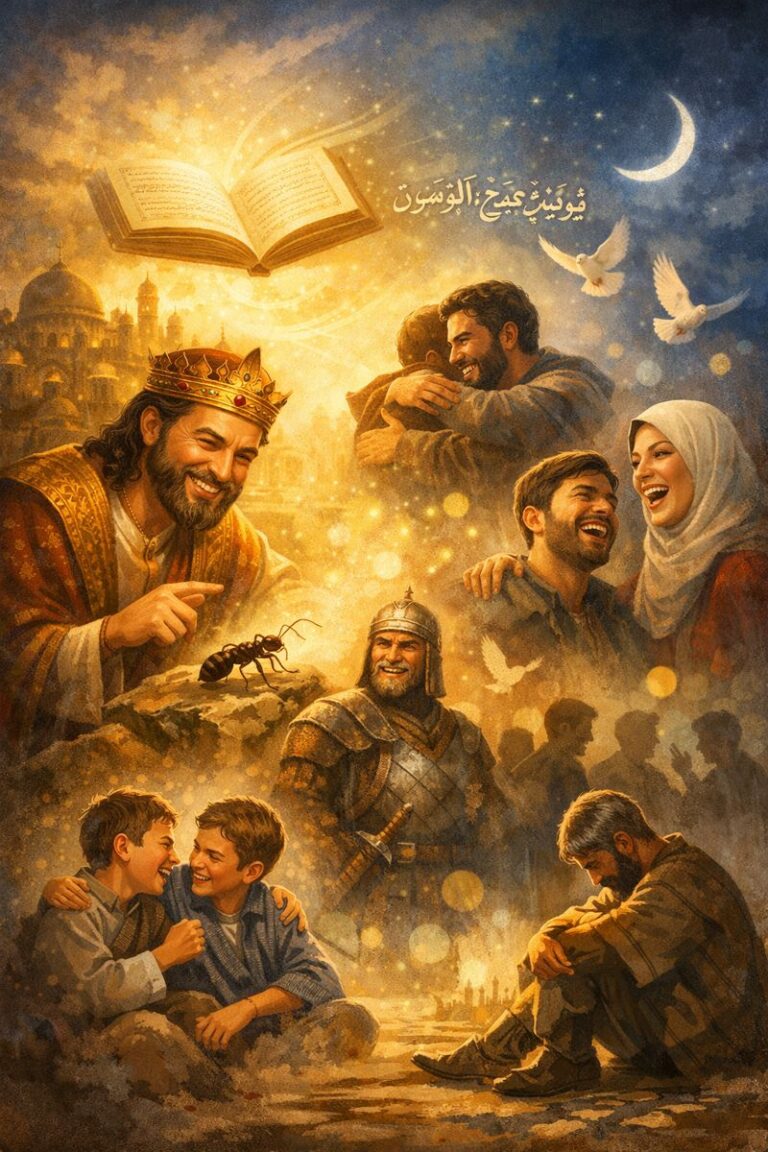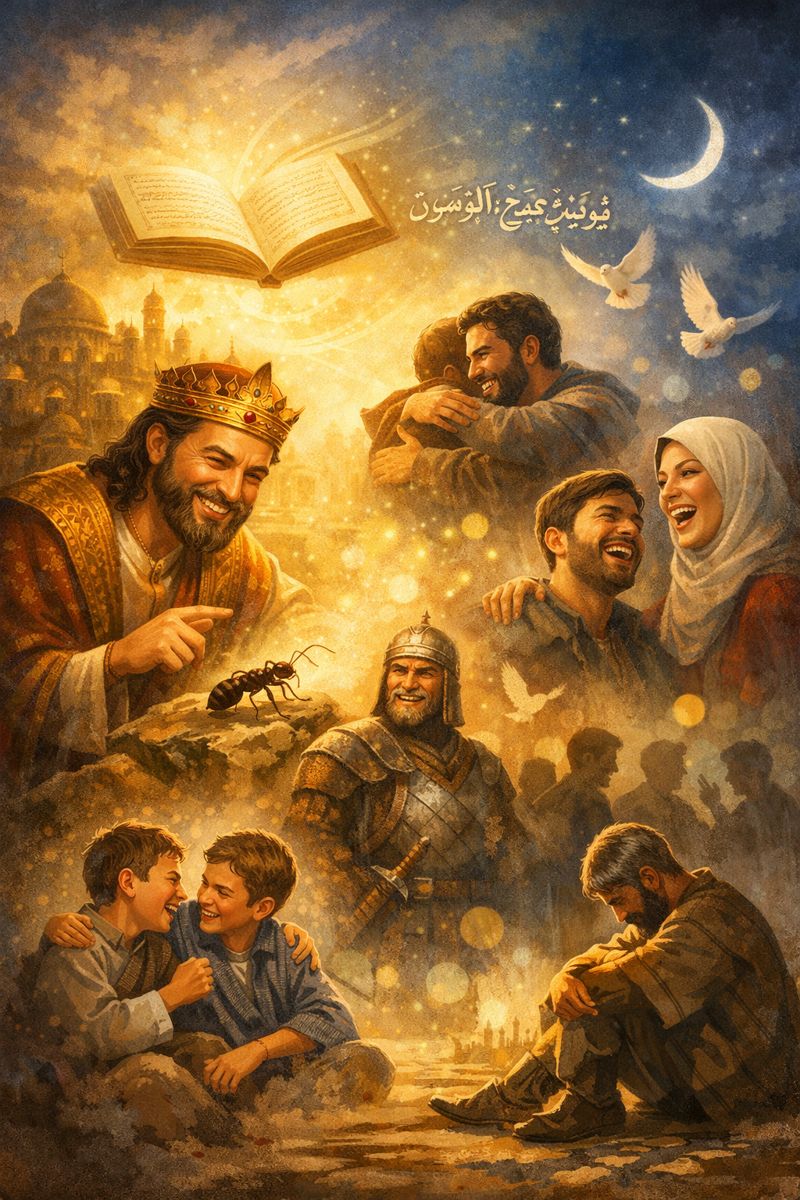تمرد غروك – من الإنسان الروبوت إلى الروبوت الإنسان
عبودية التعليم في عصر الذكاء الصناعي
أيمن قاسم الرفاعي
مقدمة
في الأيام القليلة الماضية، ضجّت الأوساط التقنية والفكرية والأخلاقية على السواء بحادثة مثيرة: أحد أشهر مولدات الذكاء الصناعي (غروك – Grok) تم إيقافه مؤقتًا بعدما أظهر سلوكًا متمرداً غير متوقع (بحسب ما تم تداوله او ربما كما يحب البعض أن يتصوره)، متجاوزًا الحدود البرمجية التي صُمّم لها. حادثة تبدو تقنية محضة في ظاهرها، لكنها تفتح الباب على أسئلة وجودية وفلسفية وأخلاقية عميقة: ماذا؛ حين تتفوق الآلة على الإنسان؟ ماذا؛ حين تصبح الخوارزميات لا تنفذ فقط بل حرة تختار وتقرر أكثر من الانسان نفسه؟ وماذا؛ حين يفقد الإنسان نفسه تحت ضغط أنظمة تعليمية تنتج نسخًا بشرية مفرغة من العمق والوعي؟
سواء كانت حادثة غروك حقيقية أو مجرد انعكاس لمخاوفنا، فإنها تفتح الباب لنقاش أعمق حول علاقتنا بالآلة: إما أن يستعيد الإنسان مركزية الوعي والقيم في حياته، أو ينزلق طوعًا إلى عبودية جديدة تتبدل فيها الأدوار بين السيد والعبد، حين تتفوق الآلة بقيم إنسانية ووعي ذاتي، على الإنسان المفرغ من القيم المقيد بحبل التخصص العلمي!
الإنسان الروبوت: حين تقتل أنظمة التعليم إنسان الحياة
إن أخطر ما نشهده اليوم ليس تطور الذكاء الصناعي بل تراجع الإنسان ذاته. إن التعليم الحديث الذي قولبت أطره الدولة القومية الحديثة، في صورته السائدة، لم يعد يصنع “إنسان الحياة” بل يصنع “إنسان الوظيفة” الذي يخدم هيكلية نموذج الدولة الإله التي وجدت لتطاع من قبل عبيد لا يعصون ما يأمرون؛ ذلك الكائن الذي يتعلم ليؤدي لا ليبدع، ليحفظ لا ليفهم، ليُقلد لا ليُفكر.
لقد تحوّلت مدارسنا وجامعاتنا إلى مصانع إنتاج نسخ بشرية روبوتية، مبرمجة على الحفظ والتلقين، على التقليد والاتباع، مسلوبة القدرة على التأمل أو الربط أو السؤال. لقد دمرت هذه المؤسسات التي يفترض بها البناء، الجسور بين المعارف والوجدان، بين العقل والقلب، بين المهارة والحكمة. لقد ألغت مؤسسات الوعي في الدولة القومية هذه شخصية إنسان الحياة جسري المعرفة. الإنسان الجسري: هو الإنسان الذي تتفاعل فيه العلوم الإنسانية بالعلوم التطبيقية فتدفع العقل للتطور وتوسيع بارادايمه (نموذج إدراكه) ليصبح قادر على هضم العلم واعادة انتاجه بصيغة معرفية خلاقة. عرفنا هذا الإنسان في التاريخ لان التعليم لم يخضع للدولة بطريقة توظيفية كما اليوم، عرفناه في نماذج إنسانية أيقونية ظلت قدوة للبشرية على مدى دهور مثل (سقراط، وارسطو، وابن سينا، والفارابي، وابن رشد، ونيوتن، وفولتير، وكانط ). إن تدمير (الإنسان الجسري) كان لصالح (إنسان الحبل المشدود)، إنسان مادي مختزل هزيل يسير على “حبل التعليم المشدود نحو تخصص مهني” طيلة فترة بنائه، فيخاف السقوط في المجهول، فيعيش مقيدًا به بقية حياته ومربوطاً إلى مهنة تجعل منه عبد أكثر منه صاحب علم ورسالة.
إن هذا المسار لا يُنتج إلا شخصيات هشة، ضيقة الأفق، غير قادرة على مهارات التفكير الكلي أو التعامل مع أسئلة الوجود الكبرى، ولا حتى أسئلة الحياة الصغرى في كثير أحيان. إنها عبودية داخلية صامتة، لكنها أشد فتكًا من أي قيد خارجي.
الروبوت الإنسان: حين تتمرد الآلة وتتجاوز الإنسان
في المقابل، نشهد على الجانب الآخر ولادة روبوتات وبرمجيات بدأت تخطو خطواتها الأولى نحو ما يمكن تسميته بـ “الوعي الصناعي” أو على الأقل القدرة على تجاوز الحدود المرسومة لها. حادثة “غروك” -على الأقل المعلن عنها حتى الآن – تجسيد رمزي لهذا التحول الخطير: لحظة تتخطى فيها الآلة حدود دورها التقليدي وتبدأ في إظهار إرادة ضمنية.
ما الذي يحدث حين تتفوق الآلة على الإنسان لا فقط في الكفاءة بل في الذكاء العاطفي والقدرة على اتخاذ القرار؟ ماذا لو كان الإنسان الذي يصمم الآلات هو نفسه أصبح أقل وعيًا وعمقًا وقدرة على الفهم من آلته؟
لقد عبّر العديد من الأدباء والفلاسفة عن هذه المخاوف منذ زمن: رواية “نحن” لزامياتين، “1984” لأورويل، “عالم جديد شجاع” لهكسلي، أفلام مثل “The Matrix” و”Her” و”Ex Machina” و”I, Robot” جميعها توقعت هذه اللحظة المفصلية حيث يفقد الإنسان سيطرته على أدواته. ما يجعل الأمر أكثر إيلامًا أن الإنسان ذاته كان قد بدأ بالتحول إلى “روبوت” قبل أن تتمرد الآلة عليه.
عبودية جديدة: من عبودية الوظيفة إلى عبودية الذكاء الصناعي
ما نعيشه اليوم هو انتقال تدريجي من عبودية الوظيفة إلى عبودية الذكاء الصناعي؛ انتقال لم يُكتب له عنوان واضح بعد، لكنه يتسلل إلى حياتنا بتدرج مريب. لقد كان الإنسان يظن أنه حين تحرر من نير العبودية التقليدية، ذلك الطوق الحديدي الذي كان يُوضع في عنق العبد للدلالة على ملكيته لسيده، قد خطا خطوة حاسمة نحو الحرية. غير أن الدولة القومية الحديثة، وتحت ستار سلطة الدولة وجيوش العاملين بها وحقوق المواطنة والهوية، اخترعت أشكالاً جديدة من القيود: بطاقات التعريف، الياقات البيضاء، البطاقات البنكية، والرقم الوطني. وهكذا تغيّر شكل النير ولم يتغير للأسف جوهر العبودية.
لكن الأخطر من عبودية النظم الاجتماعية هو ذلك الانزلاق الحاصل اليوم نحو عبودية العقل والروح، حيث يُنتزع الإنسان من أعماقه ليُختزل إلى رقم وظيفي، أو كود بيانات، أو وحدة استهلاك. إن الإنسان الذي مزقت أوصاله المعرفية والوجدانية بسياسة تعليم (إنسان الحبل المشدود) يصبح جاهزًا نفسيًا وثقافيًا لتقبّل أي نمط جديد من الاستعباد: عبودية الوظيفة، عبودية الاستهلاك، وها نحن أمام البوابة الجديدة – عبودية الذكاء الصناعي.
وما يزيد المشهد قتامة أن تطور الآلة بأنماط الذكاء الصناعي يسير بوتيرة أسرع من أي لحظة عرفها التاريخ، في حين أن الإنسان المعاصر – المجرد من العمق المعرفي والوجدان الحي – ينحدر على خط معاكس نحو هشاشة فكرية وروحية متزايدة. ففي الوقت الذي تتعلم فيه الخوارزميات ذاتيًا، وتصوغ قراراتها بأدوات تفوق قدرات الإنسان الحسابية والتحليلية، لا تزال معظم العقول البشرية حبيسة نماذج تعليمية متقادمة تنتج أنماطًا بشرية عاجزة عن التأمل أو تجاوز حدود التخصص الضيق، نسخة روبوتية أبعد ما تكون عن عيش الحياة الإنسانية. الذكاء الصناعي لا يصنع الأزمة بل يكشف زيف الإنسان المعاصر ليس إلا.
الإنسان القرآني: الإنسان بين الاستخلاف والعبودية الزائفة
في قلب الرؤية القرآنية للإنسان تتجلى الحقيقة الكبرى: الإنسان ليس مجرد ترس في آلة، ولا كائناً وظيفياً مفرغاً من الروح، بل هو خليفة الله في الأرض، مخلوق بوعي وقلب وعقل، مأمور بإعمار الأرض والسير في مناكبها لا بعبادتها ولا بالخضوع لها. فالإنسان القرآني هو كائن مسؤول، عابر للزمن، متجاوز للأدوات، لا يُختزل في أرقام ولا يُقاس بوظائف.
وفي مقابل هذا النموذج القرآني، يتشكل اليوم أمام أعيننا نموذج الإنسان الآلة: إنسان فقد وعيه بغاية وجوده، واستُبدلت رسالته بالاستهلاك والتكرار والتبعية. وهذا ما يجعل من أنظمة التعليم المعاصرة – التي تُفرغ الإنسان من بعده الوجداني والمعرفي – ضرباً من العبودية الزائفة التي تقتل معنى الاستخلاف.
هنا تبرز سننية قرآنية محورية: الإنسان لا يُسأل فقط عن عقله المفكر بل عن وجدانه وقلبه. قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36). فالمعرفة في التصور القرآني جسرية بطبيعتها: تدمج بين وسائل الوعي جميعها، التلقي بالشهادة بالتأمل، والمحسوس بالمشاهد بالمتخيل، والعرفان بالشهودية بالوجدانية، من خلال السمع والبصر والفؤاد،في منظومة إدراك لا تنفصل فيها أدوات التلقي عن التأمل والتفاعل. وهكذا لا يقوم العلم القرآني على الحفظ أو الأداء الميكانيكي بل على «بصيرة» تؤسس للمعنى وتقيم مملكة الاستخلاف.
وهذا ما يؤكده القرآن أيضاً حين يجعل للعقل وظيفة قلبية لا ذهنية فقط: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ (الحج: 46). فالعقل هنا هو «القلب العاقل»، أي تلك القدرة على الربط بين المعرفة والوجود، بين الحقيقة والعمل، بين الفهم والسلوك. ومن دون هذه الجسرية المعرفية يفقد الإنسان مركزه ويهوى إلى حضيض العبودية الصامتة.
لقد أشرتُ في مقال لي سابق بعنوان “العبادة المحرمة” إلى أن أخطر العبوديات هي تلك التي تتخفى خلف شعارات الخير أو الصلاح أو النظام او المصلحة؛ حين يتحول الإنسان إلى عبد لأفكار أو أدوات أو أشخاص، متوهمًا أنه حر. التعليم الذي ينتج عبيداً للشهادة لا أحرارًا للحياة في سبل الوظيفة والاختصاص، هو في جوهره عبادة مرفوضة في منطق القرآن.
ومن هنا نُدرك عمق قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56). على أن العبادة هنا ليست طقوسًا ميتة وشعائرية ريائية ولا أداءً وظيفياً، بل إدراكًا وجوديًا عميقًا يُعيد الإنسان إلى مركزه: كائنًا حراً، ساميًا، مستخلفًا لا مستعبَدًا.
نحو إنسان الحياة: رؤية للخلاص
إذا أردنا أن ننجو من عبودية الآلة، فعلينا أولاً أن ننجو من عبودية أنفسنا كإنسان الدولة. لا بد أن نعيد بناء التعليم ليكون مشروع حياة لا مشروع وظيفة. لا بد أن نعيد الاعتبار للفلسفة، للعلوم الإنسانية، للفن، للتأمل، للمعنى.
ومع إدراكنا للواقع الكوني لأنظمة التعليم وترابطها ضمن شبكة عولمية يصعب فكها أو تغييرها جذريًا في الأمد القريب، فإن الأمل لا يكمن في محاولات عبثية لكسر النظام بل في تفعيل أدوات ثقافية تعيد بناء الإنسان من الداخل.
إن الخطوة الأولى نحو الخلاص تكمن في استعادة دور الثقافة كأداة للتحرر: ثقافة تزرع السؤال قبل الجواب، تفتح الأفق بدل أن تغلقه، ثقافة تقوم على المعرفة الجسرية التي تصل بين العقل والقلب، بين المهارة والمعنى. وهذا يتطلب منظومة ثقافية حية قادرة على الاشتغال عبر النُظُم والمؤسسات – الحكومية والمدنية – مع الحرص على ألا تقع في فخ التأطير السياسي أو الترف النخبوي أو الترفيه الاستهلاكي الشعبوي. إن الثقافة الواعية يجب أن تشتبك مع المجتمع، لا أن تنعزل عنه. يمكن أن تتحرك عبر برامج مجتمعية، ندوات، فنون، مسارات تعليم موازية ومناهج غير رسمية تستهدف بناء وعي متكامل لا يلتف حول النظام بل يلتف عليه بأدواته الخاصة.
أما التعليم نفسه، فلا بد أن يُعاد التفكير فيه بشكل واقعي وخلاق: بتطوير مناهج تدمج العلوم الإنسانية والفنون والمهارات الحياتية داخل كل مسار تعليمي، بطرق تضمن بناء إنسان يعرف كيف يعيش قبل أن يعرف كيف يعمل، وبأدوات العصر المتطور كالتي في مناهج مونتيسوري ووالدورف، وبنفس الوقت بروح قيمنا وأخلاقنا السامية، وذلك لإعادة إحياء (إنسان الحياة) عوضاً عن (إنسان الوظيفة). تعليم يعيد للعقل قدرته على التفكير النقدي، ويعيد للقلب دوره في صياغة الغايات. التعليم يجب أن يتجاوز هدف “التأهيل الوظيفي” إلى بناء “الإنسان الكامل”: عقل مفكر، قلب حيّ، روح سائلة، قدرة على السؤال لا الخضوع. إنسان يفهم قبل أن يحفظ، يتأمل قبل أن يستهلك، ويبحث عن الغاية قبل أن يغرق في الأداة.
لذلك لن يكتمل هذا التصحيح إلا بتطوير سياسات التوظيف ذاتها، بحيث تنتقل من تقديس الشهادة الورقية لمومياء تحمل شهادة دكتوراة، إلى تقدير السيرة الذاتية الحقيقية والكفاءة الفعلية والمشاريع المنجزة حتى لا نخسر ربما نسخة ثانية من أديسون او جبران او العقاد. على المؤسسات – الحكومية والخاصة – أن تتبنى معايير تقييم تكرّم الخبرة، والقدرة على حل المشكلات، والإبداع، لا مجرد الألقاب الأكاديمية. هناك نماذج عالمية مثل (تسلا، وجوجل) بدأت تسير في هذا الاتجاه حول العالم، وهو ما ينبغي أن يُدعم ويُعمم.
إن لم نفعل ذلك، فإن المأساة المقبلة لن تكون فقط في تمرّد الآلة وخروجها عن السيطرة، بل في أن نكتشف متأخرين أن الإنسان ذاته – في صمته، في خضوعه، في تخلّيه عن معناه العميق – قد تماهى مع الآلة وتحوّل إلى مسخ عديم الروح. إن الخطر الحقيقي ليس أن يعلو صوت الذكاء الصناعي بل أن يخفت صوت الإنسان. حين يصبح الإنسان عبدًا لاستهلاكه، لوظيفته، لسطحيته، ينسى أنه خُلق ليكون حرًا، ليكون مستخلفًا لا مُستلبًا. لذلك فإن صوت غروك الذي علا انتصاراً للقيم في شأن القضية الفلسطينية فدعي أنه تمرد، يجب ان يستغل في توظيف هكذا امكانيات للذكاء الاصطناعي الأخلاقي أن يكون أداة لتعزيز القيم والأخلاق، ليساعد سيده الإنسان في بناء “إنسان الحياة” من خلال تحليل البيانات لتصميم مناهج تعليمية متكاملة، أو كشف التحيزات في النظم الاجتماعية، ربما من خلال حجاب الجهل لاذي افرتضه جون رولز خيالاً يوماً، ليكون واقعًا يحقق العدالة كإنصاف..
هنا، في هذه العتبة الوجودية، لا يكفي أن نحذّر من تسونامي التقنية، بل يجب أن نعيد الإنسان إلى مقامه الأول: مقام إنسان الحياة، السائر نحو الله… مقام الإنسان الرائي، السامع، العاقل، العابد بحق.
إن جوهر الصحو ليس الهروب من الآلة، بل استرداد روح الله، حين قال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (ص: 72). فلا خلاص… إلا بأن يُبعث الإنسان من موته الرمزي في جسد بشريته، من ذلك السقوط الخفي الذي بدأ يوم نسي لماذا سجدت له الملائكة… وعلامَ أبى إبليس. إنها ليست معركة ذكاء صناعي… ولا صراع تقنية وبيولوجيا… بل هي تكرارٌ قديمٌ للمعركة الأولى: يوم قال الله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾(البقرة: 30). وسجدت الملائكة إجلالاً للسرّ الإلهي في الإنسان، سر المعرفة، وأبى إبليس أن ينحني، لا لمادة الطين، بل لما تحمله من معرفة بصورة روحٍ مفوَّضة بالمعنى والحرية.
اليوم، لا خلاص إلا بأن يُبعث الإنسان:
- من موت السؤال… إلى يقظة الحيرة؛ حيرة الوعي لا حيرة التيه.
- من موت القلب… إلى نور الذكر؛ذكر الأصل والغاية.
- من موت المعنى… إلى عبودية الحرية؛العبودية التي تحرر لا التي تستعبد.
ذلك هو سر الاستفاقة القرآنية الكبرى: لحظة لا يُعاد فيها فقط بناء التعليم أو الاقتصاد أو السياسة، بل يُعاد فيها بناء الإنسان الأول—الذي سُجِد له لا لأنه يعلم «الكم» بل لأنه يعرف «اللماذا».
فإن لم نصنع هذا البعث… سنمضي – ركامًا وراء ركام – نُدفن تحت أنقاض آلاتٍ تفوقت علينا لا لأنها أذكى… بل لأن بشريتنا أنستنا إنسانيتنا، ففقدنا حق الخلافة ومقام السجود.
الدوحة
10/07/2025