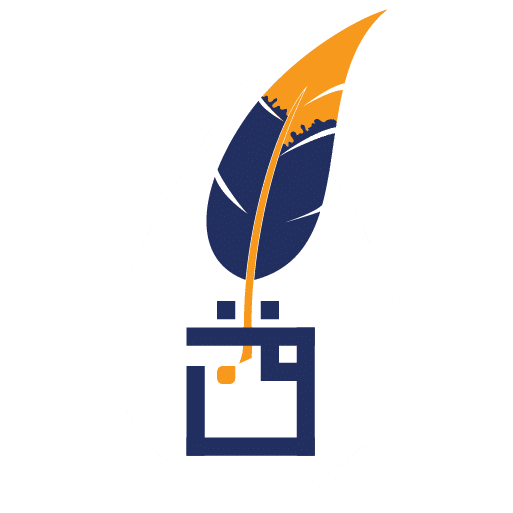سوريا بين انفعالين… ووعيٍ مطلوب
أيمن قاسم الرفاعي
يذكر التاريخ أن البلاد التي تخرج من أتون نارٍ، لا يكون الخطر دائمًا في الرماد والجمرات المدفونة فيه، بل إن أعظم الخطر… يكون في الريح؛ ريحُ الغضب، وريحُ التبرير.
اليوم في شارعنا السوري، هناك صوتان: صوتٌ يقول: كل نقدٍ خيانة، وآخرٌ يقول: كل دفاعٍ سذاجة. وكلاهما إن اشتدّ… لا يخدم حقيقة إلا من لا يريد لهذا البلد أن يقوم.
إن دولة التحرير الجديدة، – والدولة في أصل معناها- ليست صنمًا نُسبّح بحمده عن عمى، كما أنها ليست جدارًا واطئاً في طريق نهضتنا حتى نرميه بالحجارة كل صباح عن جهل. بل هي كسفينة خرجت من أعتى عاصفة، ولا زال أمامها الكثير للوصول إلى مرفئ الأمان والاستقرار. وإن من يوسع ثقوب القاع اليوم باسم الغضب ليلفت انتباه الناس إليها، يُغرق نفسه قبل أن يُغرقها، والذي يمنع فيها صوت التحذير عن ثقوب قاع السفينة باسم الولاء… او عن قيادة الدفة بلا بوصلة باسم الطاعة .. لا يقل جهلاً عن الأول لأنه ببساطة يتركها لمصير الغرق المحتم أو التحطم بالصخر الرابض على التيه.
ليس من أحد يجهل معركة أُحد. كانت خسارة عسكرية موجعة، لكن القرآن حوّلها إلى مدرسة سياسية في إدارة الانفعال وتدبير الأزمات.
اهتزّ قرار الصف، تخلّف بعضهم، رجع فريق قبل المواجهة، خالف الرماة التعليمات، سقط شهداء، وخُسرت المعركة. ومع ذلك، لم يكن الخطاب الإلهي خطاب جلدٍ أو تشفٍّ، بل دستورًا سننيًا لإدارة الأزمة، الايات (120 -180) من ال عمران تشرح ذلك:
- قال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ :(139)، فمنع الانهيار النفسي الجماعي في كلا الحالين؛ من خلال منع حالة الانكار للحدث من جهة، ومنع تحولها إلى عقدة دائمة به من جهة أخرى.
- قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (140)، فأعلن بأن التداول سنة؛ تداول الحال، وتداول الدول والرجال، فلا خطاب “نحن دائمًا منتصرون”، ولا خطاب “انتهينا”، الهزيمة لا تعني سقوط الشرعية، والنصر لا يعني العصمة. وهذا ينسحب على اليوم فلا خطاب “القائد الخالد” ولا خطاب “الكل فاسدون”،والمسؤول هو موظف لخدمة الناس وهو بشر يخطئ ويصيب قبل كل شيء.
- قال: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ﴾ (152)، فميز بين الخطأ والانتماء؛ الرماة أخطأوا؛ الخطأ تسبب في انكشاف خطير وكلف الكثير، ومع ذلك: عفى الله ورسوله عنهم، لم يُقصوا، لم يُوصموا بالخيانة، لم يتحولوا إلى “تيار داخل الصف”. لذلك التفريق هنا مهم بين: الخطأ في القرار نظراً للظروف – لكن ليس في القيم الأخلاقية – وبين نزع الانتماء، لأن الدولة التي تعاقب بالاجتثاث السياسي للمخطئين – لكن ليس الخونة طبعاً – تخلق معارضة هدامة دائمة.
- قال: ﴿حَتّىٰ إِذا فَشِلتُم وَتَنازَعتُم فِي الأَمرِ وَعَصَيتُم﴾ (152)، فجعل النقد الواضح أساس التصحيح: ثلاث كلمات مباشرة: فشل، تنازع، عصيان، لا تبرير، لا دفن للمشكلة، السياسة الراشدة لا تقوم على التغطية، بل على توصيف دقيق للخلل.
- قال: ﴿وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ﴾ (159)، فقرر أن الشورى أساس راسخ لا بحسب الظروف؛ المشاورة جاءت بعد الانكسار، لو كانت القيادة تريد الاستئثار لقالت: لقد رأيتم نتيجة آرائكم، لكن النص يعيد دمج الجميع في القرار، لإن إعادة إشراك من أخطأ، يمنع تكرار الانشقاق.
- قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَومَ التَقَى الجَمعانِ إِنَّمَا استَزَلَّهُمُ الشَّيطانُ﴾ (155) فعلمنا ضبط الانفعال عند الصدمة؛ لم يُنزع عنهم وصف الإيمان، لم يُطردوا، قيل: زلة. إدارة الأزمة تفرّق بين: الخيانة، وبين الزلة تحت ضغط، وهذا فرق سياسي بالغ الأهمية.
- قال: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ (154)، فمنع صناعة نظرية مؤامرة داخلية: بدأ خطاب: “لو استُشرنا لما حدث”، القرآن لم يقمعه، بل عالجه بالتحليل العقدي: ﴿قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيهِمُ القَتلُ﴾ أي: لا تختزلوا الحدث في قراءة سياسية ضيقة وتتورم بالذات بتضخيم “نظرية المسؤول الوحيد”.
- قال: ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ﴾ (169–171)، فألغى تحويل الشهداء إلى مادة استثمار: لقد قام بإعادة تأطير الخسارة ضمن أفق أكبر وأسمى، لأنه من أدوات السياسة الراشدة التي لا تترك الدم مادة استثمار انفعالي (شماتة) أو (مزاودة).
لذلك نقول هنا، أن ندعم الدولة… يعني أن نؤيدها حين تصيب تمامًا كما نحرسها من أخطائها، وأن ننتقدها… يعني أن نريد لها أن تعيش فننقدها إيجاباً وسلباً، لا أن نتحول إلى معول نقض وهدم. وذلك لأن الولاء ليس تصفيقًا، والحرية ليست شتمًا. وإنه من الحكمة؛ أن تقول الحقيقة وأنت تخاف لأجل البيت… لا منه ولا عليه، فأخطر ما يهدد الدول بعد الولادة، ليس أعداءها في الخارج، بل أن يتنازع أبناؤها خشب سفينتهم، وتذهب ريحهم بما لا تشتهي أشرعتهم، لأنه عندها فقط يتحول النقد إلى شماتة… والدفاع إلى إنكار… فينشطر الشارع، وهناك دائماً من ينتظر لحظة الشرخ هذه ليدخل.
إن صمام أمان هذه الدولة ليس الأمن وحده، ولا الحماس وحده، صمام أمانها وعيٌ يميّز: بين من يُصلح… ومن يترصد أو يُزايد، وبين من يحمي الدولة… ومن يحتمي بها أو يكمن لها.
نريد دولةً لا تخاف من أبنائها، ولا تختبئ خلف الهتاف، كما نريد شارعًا لا يتلذذ بالهدم، ولا يقدّس الخطأ. إن الدولة التي تسمع… تكبر، والشعب الذي ينضج… يحميها، لأنه بين الغضب الأعمى، والولاء الأعمى…تضيع الأوطان.
نحن أبناء سوريا اليوم يجب ألا نكون حدّين متنافريين فيما بيننا، بل حصنًا واحداً تختلف أحجاره، لكنها تجتمع على حماية الوطن.
بالأمس احتفل العالم بالحب – سواء أختلفنا أم اتفقنا معه – ربما يجدر بنا كسوريين أن نعيد تعريفه من منظور سوريا بالنسبة لنا.
فالحب ليس انفعالًا لحظيًّا، ولا ولاءً بلا وعي، ولا دفاعًا بلا مساءلة، الحبُّ الحقّ هو أن تحمي من تحبّ من أخطائه كما تحميه من أعدائه، وأن تصونه من أهوائه كما تسعى ل
أمنياته، وألا تقول له إلا الحقيقة دائما ولو كانت مُرّة.
فالوطن، إن أحببناه حقًّا، لا نُسِمُه غضبنا، ولا نُسلمُه لتبريرنا، لأن الحبُّ الذي لا يحرس ليس حبًّا، بل رغبة في الامتلاك.
15/02/2026