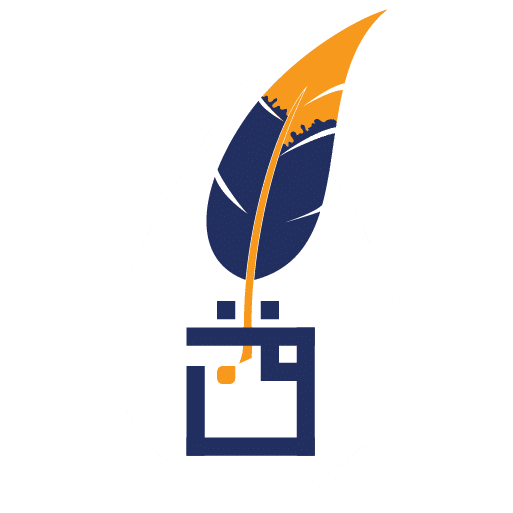أيمن قاسم الرفاعي
الآية المستند إليها: { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [الحشر: 9]
تمهيد مفاهيمي: تُعَدُّ مسألة الإيثار أحد أكثر المعضلات الأخلاقية والتكوينية تعقيدًا في الفلسفة والقرآن على السواء. فالسؤال الذي يفرض نفسه: هل يستطيع الإنسان، وهو كائن تحكمه الرغبة والبقاء، أن يتجاوز منطق المنفعة ليُؤثر غيره على نفسه؟ أم أن كل سلوك، حتى الإيثار، يمكن أن يُفكك نفعياً في جوهره؟
الآية الكريمة تُقدّم نموذجًا وجوديًا مغايرًا، تتجاوز فيه الذات المؤمنة شُحَّها الداخلي، وتُؤثر غيرها وهي في حالة خصاصة، لا فائض.
أولاً: التفكيك البنيوي للآية وتحديد السُّنَّة القرآنية
1. “تبوؤوا الدار والإيمان”: لم يكن الإيمان معلّقًا في الأذهان، بل صار دارًا، أي موطنًا وجوديًا وقرارًا نفسيًا. وهذا يشير إلى استقرار الإيمان كهوية لا كمعلومة.
2. “يحبون من هاجر إليهم”: الحب هنا ليس استجابة لمصلحة، بل هو صادر عن كمال النفس. الحب هنا “إحسان سابق” لا “تبادل منفعي”.
3. “ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا”: علامة اكتمال الذات هو خلوّها من الحسد والحاجة الشعورية للمقارنة. وهذا يشير إلى مرحلة تطهر داخلي من الشح، لا مجرد الإعطاء المادي.
4. “ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”: هنا نفي للشرط النَّفعي؛ فالمُؤثِر ليس فاعل خير لأنه شبع، بل لأنه تجاوز حاجته الخاصة لحاجة الآخر دون توقع مقابل.
5. “ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون”: الفلاح هنا نتيجة وجودية لتحقق النقاء الذاتي، لا مكافأة ولا منفعة مؤجلة.
السُّنَّة المستخلصة: الإيثار الحقيقي لا يتحقق إلا بعد فكاك النفس من أسر الشح. ومتى ما وُقي الإنسان شح نفسه، صار الإيثار فعلاً طبيعيًا نابعًا من تحقق الذات، لا من حسابات المنفعة.
ثانيًا: القراءة الفلسفية – كسر مقولة “كل شيء نفع”
قد يقول القائل: “ولكن الفلاح في ذاته منفعة، فلماذا لا نعدّ هذا الإيثار ضربًا من النفعية المؤجلة؟” وهذا القول، وإن بدا منطقياً ظاهريًا، إلا أنه يسقط في فخ فلسفي خطير: ردّ كل نتيجة إلى منفعة، ثم تعريف المنفعة بكونها أي نتيجة! وهذا تحايل منطقي مفرغ من القيمة.
إننا إذا سُقنا كل أثر حسن على أنه نفعية، فقد مسخنا المعنى الإنساني والأخلاقي للسلوك، وأصبح الإنسان آلة حسابية لا كائنًا أخلاقيًا.
لكن القرآن في هذه الآية يفكّك هذا الاحتيال العقلي بمنهج وجودي صارم:
* فالإيثار لا يُمارس من فائض، بل من خصاصة.
* والحب لا يُبنى على توقع مقابل، بل على تحقق الذات.
* والشح لا يُدان في السلوك فقط، بل في الصدر، أي في مصدر القرار الوجداني.
إن فوز المرء بفطرته السليمة، وصفاء ضميره، وسلامة صدره، هو تحقق وليس مصلحة. هو نتيجة لازمة لتزكية النفس، لا غاية نفعية تُطلب من خارج الذات.
ثالثًا: تفكيك فلسفي لمعضلة النفعية
يذهب الفكر الأداتي المعاصر إلى تفسير كل سلوك بشري بوصفه ذا دافع نفعي، حتى لو كان خيريًّا أو إيثاريًّا. ويُستند إلى مفاهيم كـ “اللذة المؤجلة” (Utilitarianism) أو “المصلحة النفسية” أو “الثواب الأخروي”.
لكن هذا المنظور يتهاوى أمام الآية:
* لأن الحب لا يأتي بعد منفعة، بل قبلها (“يحبون من هاجر إليهم”).
* ولأن الإيثار لا يُمارَس عند الفائض بل عند الخصاصة.
* ولأن النتيجة (الفلاح) ليست جزاءً بل هي توصيف لحالة ذاتية وجودية.
البرهان الإضافي: إن إخضاع كل سلوك لتفسير نفعي لا يؤدي إلى التفسير، بل إلى تفريغ المعنى. إذ تصبح المنفعة مجرد مصطلح مطاط يبتلع كل شيء، حتى إثبات نفيه! ويصير مفهوم الخير بلا جوهر إلا ما تُقرره النتيجة، والنتيجة نفسها تعود لتكون منفعة. وهذا دوران فلسفي باطل.
لكن الآية تضع حدًا لهذا العبث:
1. فهي لا تجعل الإيثار وسيلة بل ثمرة.
2. ولا تصف الفلاح كمنفعة بل كتحقق.
3. وتربط التحرر من الشح بتحقق الإنسانية، لا بتحصيل مقابل.
رابعًا: إثبات السننية من خلال الاستقراء القرآني
حتى يكون التحليل قرآنيًا بارادايميًا لا تأويليًا فحسب، يجب أن يُثبت كـ”سُنّة قرآنية متكررة” عبر النص. وتدعم ذلك شبكة من الآيات:
1. ﴿قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها﴾ [الشمس: 9–10] — تزكية النفس شرط الفلاح.
2. ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف يرضى﴾ [الليل: 19–21] — الإنفاق ليس لجزاء.
3. ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا﴾ [الإنسان: 8–9] — الإيثار نقيّ المقصد.
4. ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: 92] — تجاوز الشح شرط للبر.
5. ﴿من أراد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن أراد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب﴾ [الشورى: 20] — المقصد يحدد القيمة.
6. ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله﴾ [البقرة: 110] — التقديم ليس لمكافأة بل لتكميل النفس.
7. ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم…﴾ [الكهف: 103–104] — الإخلاص مقصد لا يُعوّض عنه الظاهر.
السنة المحورية المؤكدة: لا يكون الإيثار خلقًا قرآنيًا حتى ينبع من تزكية النفس، ويكون فلاحه نتيجة لحقيقة داخلية، لا مكافأة خارجية. فبهذا يتمّ نفي المنفعة كحافز، وإثبات التحقق كغاية
خامساً: قانون فلسفي قرآني جديد (التحقق الذاتي هو غاية، لا منفعة)
عندما يبلغ المرء رتبة الإيثار الخالص، فهو لا ينفك عن نزعته النفعية فحسب، بل يتحول إلى كائن أخلاقي قد تحرر من مركزية ذاته. وهذا هو الإنسان القرآني الذي تجاوز معادلة الثواب والعقاب، وصار خلقه انعكاسًا لما هو عليه، لا لما يرجوه.
خلاصة فلسفية وفق بارادايم القرآن:
الإيثار، في التصور القرآني، ليس فضيلة فوق العادة، بل علامة اكتمال الإنسان. فالإنسان الكامل (السامي)، الذي خرج من طوق شح النفس، لا يُؤثر لأن له مصلحة، بل لأنه صار يرى الآخر جزءًا من نفسه. وهذا قمة التحول الأنطولوجي الذي يسعى له القرآن:
* أن ترى في نفع غيرك نفعًا وجوديًا لك، دون انتظار.
* ولهذا، قال في آخر الآية: {فأولئك هم المفلحون}، لا لأنهم نالوا ثوابًا، بل لأنهم فازوا بذواتهم الخالصة.
* الإيثار ليس نفعًا مؤجلًا، بل نفيٌ للنفعية من أصلها.
وهذا هو جوهر السُّنَّة التي تقدمها الآية:
سُنَّة التزكية كشرط للتحرر من النفعية، وسُنَّة الإيثار كتحقق إنساني لا يُمكن بلوغه دون هذا الشرط.