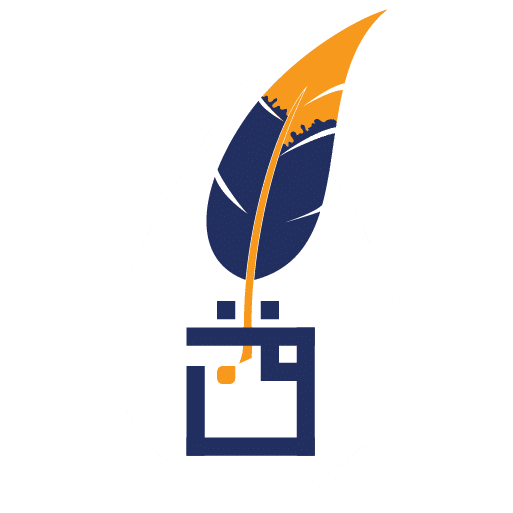الابتسامةسننية البناء الأول للغة والاجتماع الانساني
أيمن قاسم الرفاعي
مقدّمة
لا يُقرأ الضحك والابتسام في الوعي الشائع إلا بوصفه انفعالًا نفسيًا، أو متنفسًا اجتماعيًا، أو هامشًا من هامش الحياة الجادّة. غير أن هذا الفهم السطحي يُقصي الضحك عن موضعه الحقيقي في بنية الوعي الإنساني، ويغفل كونه فعلًا سننيًا ذا وظيفة حضارية مزدوجة: فالضحك يمكن ان يكون أداة بناء… وقد يكون أداة هدم، وقد يحرّر الوعي… أو يفرّغه.
من هنا تأتي ضرورة تفكيك الضحك تفكيكًا بارادايميًا، لا بوصفه حالة وجدانية، بل باعتباره الأبجدية الأولى للغة الخطاب والشرط المؤسس للاجتماع الإنساني، لأنه وببساطة الوسيط الخفي لتشكّل العلاقة بين الخوف، والسلطة، والطمأنينة، والاستخلاف.
أولًا: الضحك كفعل سنني لا كحالة نفسية
في المنظور القرآني، لا تظهر الأفعال البشرية في النص الآيي عبثًا، ولا تُذكر بوصفها تفاصيل زخرفية لغوية أو قصصية. كل فعلٍ يُذكر في سياق الرسالة للآيات يحمل وظيفة، ويشير إلى قانون، ويؤسس لمسار.
من هذا الباب، لا يمكن قراءة تبسّم سليمان من قول النملة (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا) النمل 19، بوصفه إعجابًا عاطفيًا أو ظرفًا قصصيًا، بل بوصفه فعل طمأنة واعٍ. النملة لم تكن في مقام الحوار، بل في مقام الخوف. وسليمان لم يُخاطب عقلها، بل أرسل إشارة أمان إلى وجودها.
الابتسامة هنا ليست حكمة فحسب، بل رسالة سلام، تقول: القوة التي ترينها لا تعاديك، والسلطة التي تمرّ فوقك واعية بوجودك.
وهكذا تتجلى سننية الابتسامة بوصفها أول عقد اجتماعي غير مكتوب: نعم أنا قوي، لكنك آمن.
ثانيًا: الضحك ونزع الخوف… الأساس الخفي للاجتماع
كل اجتماع إنساني يقوم – في مستواه العميق – على إدارة الخوف. الخوف من الإقصاء، الخوف من القمع، الخوف من الإلغاء. وأقدم وسيلة لنزع هذا الخوف ليست القانون، ولا الخطاب، ولا الوعظ، بل الإشارة غير اللفظية للأمان. الابتسامة الصادقة – خاصة حين تصدر من موضع قدرة – تسبق اللغة، وتسبق السياسة، وتسبق الأخلاق المعلنة.
لهذا، فإن المجتمعات التي يقلّ فيها التبسّم؛ هي مجتمعات يحكمها القلق، والمجتمعات التي تُدار بالوجوه العابسة؛ هي مجتمعات تُدار بالخوف لا بالثقة.
ثالثًا: الضحك السلبي… حين يتحول إلى تفريغ للوعي
غير أن الضحك ليس دائمًا فضيلة. فهنا تظهر الجهة الأخرى من السننية.
في السياقات السياسية المتردية، يظهر الضحك بوصفه سخرية جماعية، ويتحول إلى أداة تفريغ للغضب بدل توجيهه،
وإلى تنفيس نفسي بدل شحن أخلاقي.
هذا الضحك السلبي:
- يخفف الألم الآني،
- لكنه يبدد طاقة التغيير،
- ويحوّل الوعي من حالة توتر خلاّق إلى حالة استهلاك ساخر.
السخرية هنا سلاح ذو حدّين: من جهة، تُسقط هيبة النظام الفاسد، ومن جهة أخرى، تُفرغ الفعل الاحتجاجي من زخمه.
ولهذا تفشل كثير من الثورات قبل أن تبدأ؛ لأن الوعي ضحك بدل أن يتراكم، وسخر بدل أن يتحوّل إلى موقف.
رابعًا: الضحك بين السلطة والتحرر – قراءة في رواية اسم الوردة
في رواية اسم الوردة، يستحضر أمبرتو إيكو الجدل الأرسطي حول الضحك بوصفه مدخلًا لفهم علاقة السلطة بالخوف. فالضحك، وفق التصور الذي يدافع عنه الراهب الأعمى، خطرٌ يهدد النظام القائم، لأنه يجرّد السلطة من هالتها القدسية، ويحوّل الرهبة إلى قابلية للسؤال. ولهذا يُحرَّم الضحك لا لأنه عبث، بل لأنه كاشف؛ إذ يكسر احتكار المعنى ويعيد الإنسان إلى موقعه الطبيعي ككائن حرّ قادر على التمييز.
غير أن إيكو – رغم عمق تفكيكه – يظل أسيرًا لوظيفة سلبية للضحك: أداة نقض للسلطة لا أداة بناء بعدها. فالضحك في اسم الوردة ينتهي عند كشف الخوف، لكنه لا يقدّم بديلاً أخلاقيًا يعيد تنظيم العلاقة بين الإنسان والسلطة والمجتمع.
هنا يتقدّم القرآن بمنظور مختلف جذريًا؛ إذ لا ينظر إلى الضحك بوصفه نقيض الهيبة، بل بوصفه إعادة تأسيس لها على قاعدة الطمأنينة لا الرهبة. فالضحك القرآني – كما في ابتسامة سليمان – ليس سخرية تفكيكية، بل فعل وعي يطمئن الضعيف، وينزع الخوف، ويعيد ترتيب العلاقة بين القوة والرحمة. وبذلك يتحول الضحك من تهديد للسلطة إلى معيار أخلاقي لها: سلطة تُضحِك الناس أمنًا، لا تُرعِبهم خوفًا.
بهذا المعنى، يمكن القول إن اسم الوردة كشف سرّ خوف السلطة من الضحك، بينما يكشف القرآن سرّ حاجة العمران إليه. فالضحك في بارادايم القرآن ليس تمرّدًا عابرًا، بل سنة إنسانية تُبنى عليها هيبة عادلة، وعقد اجتماعي غير مكتوب، أساسه الأمان، لا القهر.
سادسًا: البعد السيكولوجي
في بارادايم القرآن، لا يُفهم الفرح والضحك والابتسام بوصفها أفعالًا منفصلة، بل باعتبارها تجلّيات مختلفة لطاقة نفسية واحدة، هي طاقة الاستجابة الوجدانية للحياة. فالإنسان لا يبتسم ولا يضحك ولا يفرح عبثًا؛ بل لأن داخله تعرّض لاستثارة معنى: أمان، رجاء، نصر، رحمة، غرور، شماتة، أو استعلاء.
الفرح كحالة نفسية داخلية: الفرح في القرآن يأتي غالبًا بوصفه حالة شعورية تتكوّن في الداخل قبل أن تتحوّل إلى تعبير خارجي: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾، هنا الفرح استجابة صادقة لحدث كوني عادل (نصرة الحق)، وهو فرح لا يُنتج استعلاءً ولا شماتة، بل طمأنينة ومعنى. وفي المقابل: ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾، هذا فرح منفصل عن السنن، متضخم بالذات، يتحوّل من حالة شعورية إلى هوية نفسية مغلقة. إذن الإشكال ليس في الفرح، بل في تمركزه حول الذات أو انفتاحه على المعنى.
الضحك والابتسام كتعبير اجتماعي عن الفرح: الضحك والابتسام ليسا مجرد مخرجات انفعالية للفرح، بل هما لغة جسدية-اجتماعية تُعلن انتقال الإنسان من حالة التحفّز إلى حالة الأمان. ولهذا جاء تبسّم سليمان عليه السلام في القرآن لا بوصفه انفعالًا عابرًا، بل بوصفه فعل قيادة وطمأنة: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾. ابتسامة سليمان نزعت الخوف عن النملة، وأبطلت منطق القوة الغاشمة، وأعادت تعريف السلطة بوصفها رحمة واعية لا تحتاج إلى بطش لإثبات حضورها. غير أن هذه السننية لا تقتصر على مشهد السلطة، بل تمتد إلى المجال العلاقتي الإنساني العميق؛ فالابتسامة تظهر تلقائيًا حين يلاقي الإنسان من يألفه قلبه، أو ينتظر حضوره، أو يشعر معه بالأُنس. إنها إشارة لاشعورية متبادلة تقول: أنا في أمان معك، ولستُ في موضع دفاع. ولهذا لا يبتسم الإنسان في لحظة تهديد حقيقي، ولا يضحك من يشعر بأن وجوده مُهدَّد؛ فالضحك لا يظهر إلا بعد أن يطمئن الداخل، وترتفع حالة الخطر، ويستعيد الجسد ثقته بالمحيط. ومن هنا تتجلّى سننية دقيقة: الابتسامة والضحك المطمئن ليسا ترفًا شعوريًا، بل رسالة سلام اجتماعي غير منطوقة، تُبنى بها الألفة، وتُداوى بها القلوب المتعبة، ويُعاد عبرها تشكيل الاجتماع الإنساني على قاعدة الأمان لا الخوف.
الفرح السلبي: حين تنفصل الطاقة عن المعنى: القرآن يحذّر من نمط آخر: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (قارون)، هذا ليس نهيًا عن الفرح، بل عن الفرح الذي يتحوّل إلى حالة استغراق أناني: ، فرح بالمال، فرح بالسلطة، فرح بالتفوق، فرح بالسلامة على حساب القيم. وهنا يتحوّل الفرح — ومعه الضحك — إلى: تفريغ للوعي، تعطيل للإحساس بالمسؤولية، تبرير للركون، أو شماتة تقتل الفعل. وهذا هو الضحك السلبي الذي ناقشناه سابقًا: ضحك يسخر ليهرب، لا يبتسم ليبني.
في ضوء ذلك، يمكن ضبط المعادلة هكذا: الفرح: حالة نفسية داخلية، الابتسام: ترجمتها الآمنة، الضحك: تعبيرها الاجتماعي، السخرية: انحرافها حين تنفصل عن المعنى، المرح المنفلت: استغراقها حين تتحوّل لهوية، والميزان القرآني لا يسأل: هل فرحت؟ هل ضحكت؟ بل يسأل: لماذا؟ وبماذا؟ وإلى أين؟ .
بهذا الفهم، يصبح الضحك والفرح والابتسام: أدوات بناء أو هدم، عقود أمان أو تفريغ، سنن نفسية لا أخلاقية بذاتها، بل بوظيفتها.
خاتمة: الضحك من البهجة إلى العمران
في بارادايم القرآن، لا تُفهم البهجة بوصفها حالة شعورية عابرة، ولا تُختزل في انفعال نفسي معزول، بل تُقرأ ضمن نسق متكامل يربط الداخل الإنساني بالسلوك الاجتماعي، والحدث بالاستجابة، والمقام بالوظيفة. فالضحك، والابتسام، والفرح، ليست مترادفات مطلقة، بل دوائر متداخلة تتفاوت في العمق والمجال والأثر.
فالفرح – في أصله القرآني – استجابة وجودية لحدث: قد يكون رحمةً تُذاق، أو نصرًا يُتحقق، أو فضلًا يُبصر، فينشأ عنه فعلٌ تلقائي صادق، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وهذا الفرح فعلٌ حيّ، مرتبط بالزمن، قابل للزوال، لا يستقر في الذات إلا بقدر صدقه واتصاله بالمصدر.
لكن حين يتحوّل الفرح من فعلٍ مرتبط بالحدث إلى صفةٍ مستقرة في الأنا، يُستغرق فيها الإنسان بذاته أو بما أوتي أو بما عنده، ينفصل عن السننية، ويتحوّل من طاقة حياة إلى حالة اختلال، كما في: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾، و﴿فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾. فهنا لا يُدان الشعور، بل يُدان استغراق الأنا فيه وتحوّله إلى وهم اكتفاء، أو غرور، أو تعويض نفسي.
أما الابتسامة، فهي الترجمة الجسدية الأخفّ والأكثر أمانًا للفرح؛ لغة إنسانية سابقة على الكلام، ورسالة طمأنة لا تحتاج شرحًا. ابتسامة سليمان – كما يصوغها القرآن – لم تكن ضحك حكمة فحسب، بل فعل أمان: طمأنة للنملة، وكسر للخوف، وإعلان لسلطة لا تقوم على البطش بل على الفهم. ولهذا كانت الابتسامة، في بعدها السنني، عقدًا اجتماعيًا غير مكتوب: تعلن السلام، وتخفض منسوب التوتر، وتفتح المجال للتلاقي دون تهديد.
وأما الضحك، فهو أعلى درجات التفريغ الانفعالي، وأخطرها. فهو قد يكون ضحك طمأنة وبناء، حين يأتي في سياق أمان، أو حكمة، أو اتصال بالمعنى، وقد ينقلب إلى ضحك تفريغي ساخر، يُستهلك فيه الوعي بدل أن يُشحَن، كما في السخرية السياسية أو الاجتماعية التي تُضحك الناس، لكنها تُفرغ طاقة الفعل، وتُعيد إنتاج الخوف بصورة مموّهة، فتُضعف الثورة بدل أن تُطلقها، وتُسقط هيبة الباطل لحظة، ثم تُعيد ترسيخ عجز الداخل.
من هنا، لا يضع بارادايم القرآن الضحك في خانة الإدانة ولا في مقام التمجيد، بل في ميزان الوظيفة والمقام:
فرحٌ يفتح الإنسان على الشكر = بناء.
ابتسامة تُنزع بها الرهبة = عمران.
ضحكٌ يخفف الخوف دون تخدير الوعي = تحرّر.
سخرية تُفرغ الغضب دون تحويله إلى فعل = تعطيل.
وهنا تتجلّى مسؤولية الإنسان الخليفة: أن يعرف متى يفرح، ولماذا يبتسم، وأين يضحك، ومتى يصمت. فليس كل ضحك رحمة، ولا كل صمت حكمة، لكن الاستخلاف الحق هو القدرة على اختيار الاستجابة التي تُبقي الإنسان حيًّا، والوعي يقظًا، والمجتمع قابلًا للعمران. وبهذا المعنى، تصبح البهجة في القرآن أداة بناء لا متعة هروب، ولغة أمان لا قناع إنكار، وسنّة إنسانية عميقة، إن ضُبطت أحيت، وإن أُسيء توظيفها أفسدت.
22/12/2025