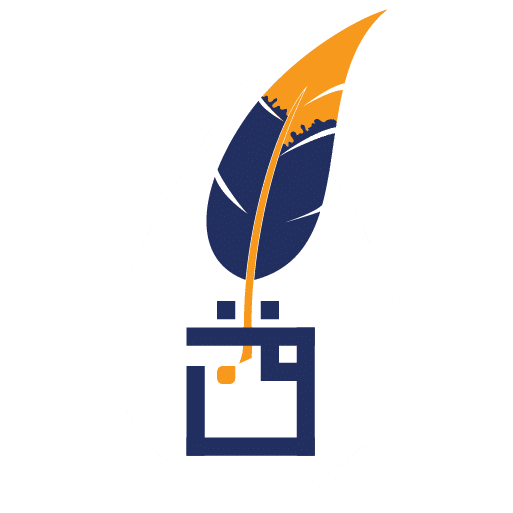القلب السليم: سننية الوعي بين التقلب والاختيار
أيمن قاسم الرفاعي
المفهوم
القلب في القرآن ليس موضع العاطفة كما يستخدم عادة، ولا مرادفًا مجرداً للعقل كما يصور في بعض القراءات المعاصرة، بل هو بنية الوعي الحيّ؛ سُمّي قلبًا لأنه يتقلّب، أي يعيد النظر في الأشياء من وجوهها المتعددة حتى يتبيّنها حقّ التبيّن، ثم يبنى عليه قرار الاختيار سواء موقفاً او قولاً. لذلك عمى القلوب ليس فقدان الرؤية، بل توقّف القلب عن التقلب، أي تعطّل وظيفته الأصلية في مساءلة المعنى، (إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) الحج – 46
الإشكال البنيوي: لماذا «قلب» مع «سليم»؟
لفظ سليم في العربية من ألفاظ التضاد، وبحسب المعاجم:
- يدل على السلامة والاستقرار،
- ويدل كذلك على اللدغ والتسمم والاضطراب الداخلي.
واجتماع هذا اللفظ الثابت بمعنيين متضادين، مع القلب (المتقلب بطبيعته) ليس تناقضًا لغويًا، بل اعجاز بلاغي فائق للفظتين ثابتتين تحملان معنى التقلب والتضاد، وهو كذلك إشارة سننية دقيقة: أن الوعي الحقيقي لا يولد في منطقة الأمان، بل يتخلق بالتجربة في منطقة الخطر.
تفريق سياقي هام
﴿إذ جاء ربه بقلب سليم﴾ و ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾
لا يتحدّث القرآن عن «القلب السليم» بوصفه حالة واحدة تُنقل من موضع إلى آخر، بل يعالجه ضمن سياقات متباينة يغيّر فيها الفعل، والجهة، والدلالة، ليكشف مسار الوعي الإنساني لا نتيجته الجاهزة.
في مقام إبراهيم، يقول النص: ﴿إذ جاء ربه بقلب سليم﴾.
و«جاء» هنا لا تفيد مسيرًا اختياريًا نحو غاية، بل مثولًا قهريًا في موقف كاشف؛ لحظة مواجهة لا يختارها الإنسان بقدر ما تُفرض عليه. والمرجعية هنا ليست الله بوصفه الغاية النهائية، بل «ربه» بمعناه التربوي القريب: الأب، والبيئة، والنسق الثقافي الذي نشأ فيه. أمّا «القلب السليم» في هذا الموضع فلا يدل على استقرار أو طمأنينة، بل على قلبٍ لُدغ من الداخل؛ قلبٍ أصيب بسمّ التناقض، فلم يعد قادرًا على التعايش مع الزيف الموروث، فبدأ السؤال والاحتجاج والكسر. هنا تكون السلامة سلامةَ الحسّ من البلادة، لا سلامةَ الاستقرار.
أمّا في موضع الحساب، فيقول القرآن: ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾.
ويتغيّر كل شيء: الفعل «أتى» يفيد حركة اختيارية ممتدة في الزمن، والجهة هي «الله» بوصفه المرجعية العليا النهائية، لا المرجعية الاجتماعية القريبة. و«القلب السليم» هنا ليس قلبًا ملدوغًا، بل قلبًا اجتاز التقلب وخرج إلى الاستقرار؛ قلبًا اختار بعد الاضطراب، ووعى بعد الحيرة، واستقر بعد رحلة الوعي.
بهذا التفريق، لا يعود «القلب السليم» وصفًا أخلاقيًا ثابتًا، بل مسارًا سننيًا: سلامةٌ أولى تُولد من اللدغ والاضطراب، وسلامةٌ أخيرة تُتوَّج بالاختيار والاستقرار. والخلط بين الموضعين يُفرغ النص من حكمته، ويحوّل القرآن من خطاب يصف حركة الوعي إلى خطاب يعرض نتائج جاهزة.
لذلك فإن سننية الوعي القرآني يمكن تلخيصها في أربع مراحل متتابعة:
- اللدغ: القلب يتألم حين يرى التناقض بين الواقع والحق.
- التقلب: إعادة النظر، السؤال، القلق، كسر المسلّمات.
- المثول: مواجهة المرجعية (الأب، المجتمع، السلطة، الفكرة السائدة).
- الاختيار والاستقرار: إمّا شفاء يتحوّل فيه السمّ إلى وعي، أو عمى ينتج عن تثبيت القلب قسرًا قبل اكتمال التقلب.
الخيط السنني
حين يصف القرآن القلب بوصفه موضع العمى أو البصيرة، فهو لا يحيل إلى خللٍ إدراكي، بل إلى تعطّل وظيفة التقلب؛ إذ خُلق القلب ليقلب النظر في الأشياء حتى تتكشف حقيقتها. من هنا، فإن الاضطراب الذي يصيب الإنسان في بدايات وعيه ليس عارضًا مرضيًا، بل علامة حياة داخلية، ودليل على أن القلب بدأ يعمل. القلق، في هذا المقام، لا يكون نقيض الإيمان، بل نقيض البلادة؛ فهو اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بأن ما ورثه لم يعد قادرًا على تفسير العالم أو تبرير التناقض الذي يعيشه.
لهذا، لا يُمدح الاستقرار الذي يسبق السؤال، لأنه استقرار قائم على التلقّي والتعوّد، لا على الفهم والاختيار. الطمأنينة التي لم تمرّ بالشكّ هي طمأنينة جامدة، تشبه السكون الذي يسبق العمى. أمّا الطمأنينة التي تأتي بعد السؤال، وبعد تقليب النظر، وبعد احتمال القلق، فهي طمأنينة مختارة، لا موروثة، وبهذا المعنى وحده تكون طمأنينة حيّة. فكل قلب لم يُلدغ بعد بتناقض الواقع، ولم يتألم من فجوة المعنى، لم يدخل بعد رحلته الإنسانية، مهما بدا مستقرًا أو واثقًا.
وهذا المسار الإنساني يجد امتداده الطبيعي في البعد الفكري والفلسفي؛ إذ لا انتقال معرفيًا حقيقيًا دون انكسار نموذج سابق كان يفسّر العالم ثم عجز عن ذلك. لحظة الانكسار هذه تُحدث اضطرابًا في البنية الداخلية للإنسان، وتفرض عليه ألمًا معرفيًا لا يمكن القفز فوقه. غير أن هذا الألم ليس عيبًا في الوعي، بل شرطه الضروري؛ فمن لم يحتمل ألم السؤال، ثبّت قلبه قسرًا عند أول يقين وراثي، فتحوّل الاستقرار إلى عمى. لذلك، لا يُقاس القلب السليم بغياب الشك، بل بقدرته على احتمال الشك حتى يتحوّل إلى بصيرة.
ومن هنا تتضح قابلية هذا المفهوم للتوظيف الحياتي. في التربية، لا يكون الخطر في أسئلة الأبناء، بل في إخمادها باسم الطمأنينة المبكرة؛ لأننا بذلك نُعطّل وظيفة القلب قبل أن تبدأ. وفي الفكر والدين، لا تُدان الحيرة الصادقة، لأنها رحم اليقين لا نقيضه، وما لم تمرّ الفكرة بمرحلة الاضطراب، ستبقى سطحية قابلة للانهيار. وفي المشاريع والنهضة، لا تقوم المبادرات الكبرى على يقين مُعلن فقط، بل على قلوب مرّت بمرحلة اللدغ والاضطراب الواعي؛ فكل مشروع لم يختبر نفسه في منطقة الخطر سينهار عند أول مواجهة حقيقية. أمّا في تزكية النفس، فسلامة القلب لا تعني الهروب من الألم أو القفز فوق الأسئلة، بل المرور بها دون خيانة للحق، حتى يتحوّل الاضطراب من سمٍّ قاتل إلى بوصلة هادية.
بهذا المعنى، لا يكون القلب السليم حالة مثالية تُطلب، بل مسارًا يُعاش؛ يبدأ باللدغ، ويمرّ بالتقلب، ولا يستقرّ إلا حين يصبح الاستقرار اختيارًا واعيًا لا ملجأً من القلق.
تشوّهات القلب وسننية تعطيل الوعي في القرآن
حين يستعرض القرآن أحوال القلوب، فهو لا يقدّم أوصافًا أخلاقية معزولة، بل يرسم خريطة سننية دقيقة لتعطّل الوعي الإنساني بوصف القلب موضع تقليب النظر، لا مجرد وعاء شعوري. فالقلب خُلق ليُبصر ويعقل ويتدبّر، وتعطّله لا يكون بفقدان المعلومة، بل بتعطيل آلية التقلب نفسها أو إفساد شروط نفاذ النور إليها. ومن هنا تتعدد أوصاف القلوب في القرآن بحسب نوع العطب: فـ الرَّان يشير إلى تراكم قيمي فاسد يُغشي القلب، فيظلّ يتقلب وينظر، لكن دون أن ينفذ إليه النور، فينشأ وهم الوعي بدل حقيقته. أمّا الأقفال فتعبّر عن تعطيل بنيوي للتقلب ذاته، حيث يُربط القلب ببارادايم معرفي مغلق يمنعه من تقليب وجوه النظر، وهو قصور معرفي قبل أن يكون فسادًا أخلاقيًا. ويأتي عمى القلوب بوصفه فقدانًا لقابلية الإبصار القلبي، سواء كان نتيجة رانٍ متراكم، أو أقفالٍ معرفية، أو قصورٍ أصلي في أدوات التلقي، وهو أعمّ من أن يُردّ دائمًا إلى فساد مكتسب. أما الزيغ فيصف حالة تقلب منحاز، حيث يعمل القلب، لكن بزاوية نظر مائلة تحكمها أهواء سابقة، فينتج الفهم الانتقائي والتأويل المسوّغ. وتأتي القسوة بوصفها تبلّد الاستجابة بعد قيام الحجة، حيث يرى القلب ولا يتأثر، فيموت التفاعل لا الإدراك فقط. ثم يكون الختم خاتمة المسار المرضي، لا بدايته؛ توثيقًا نهائيًا لاختيار متكرر في الإعراض بعد البيان. بهذه الصورة، لا تظهر أوصاف القلوب حالات متجاورة، بل مسارات ممكنة داخل سننية واحدة: من قلبٍ متقلب قابل للوعي، إلى قلبٍ لُدغ فاضطرب، ثم إمّا أن يتحوّل الاضطراب إلى بصيرة، أو ينزلق إلى زيغ، فرَان، فقفل، فعمى، فقسوة، فختم. وبهذا يتضح أن القرآن لا يُدين التقلب، بل يُدين تعطيله أو تحريفه؛ فلا وعي بلا تقلب، ولا بصيرة بلا نفاذ نور، ولا سلامة قلب إلا باجتياز هذا المسار دون تثبيت قسري أو هروب من السؤال.
خلاصة جامعة
بهذا الفهم، لا يعود «القلب السليم» وصفًا أخلاقيًا جاهزًا، ولا حالة مثالية تُستدعى عند النهاية، بل بنية وعي تتشكّل عبر مسار: تبدأ باللدغ، وتشتغل بالتقلب، وتُختبر بالمثول، ولا تستقرّ إلا بالاختيار. سلامته ليست في غياب الاضطراب، بل في عدم الهروب منه، ولا في السكون المبكر، بل في الاستقرار الذي يأتي بعد اكتمال النظر. ومن هنا، فإن كل محاولة لتجاوز هذا المسار، أو اختزاله، أو القفز على مراحله، تُنتج وعيًا هشًّا، وتدينًا شكليًا، ومشاريع لا تصمد أمام لحظة المواجهة. تلك هي سننية القلب في القرآن: لا وعي بلا تقلب، ولا سلامة بلا اجتياز، ولا استقرار بلا اختيار.
22/12/2025