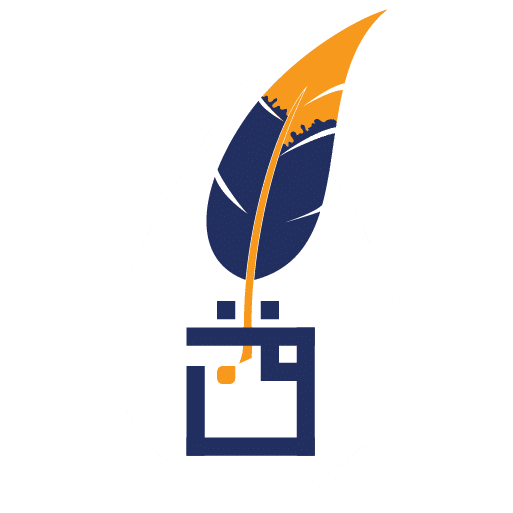سلسلةُ المعنى: البارادايم من تأسيسِ الرؤية إلى عمرانِ الواقع
أيمن قاسم الرفاعي
تمهيد: لماذا لا تكفي الفكرة وحدها؟
ثمّة وَهْمٌ معرفيٌّ شائع، يرى أنَّ الفكرة إذا بلغت قدرًا من العمق الفلسفي صارت مكتفيةً بذاتها، وأنّ الحقيقة متى قيلت بلسانٍ رفيعٍ وجب أن تُثمر أثرها في الناس تلقائيًا. وفي المقابل، يقوم وَهْمٌ آخر لا يقلّ شيوعًا، يزعم أنّ اللغة العالية لا جدوى منها لانفصالها عن لغة الناس، وأنّ التفكير الفلسفي مجرّد تنظيرٍ مثاليٍّ معزولٍ لا يمسّ الواقع ولا يغيّره.
غير أنّ التجربة الإنسانية، وسير الحضارات في صعودها وانكسارها، تقدّمان شهادةً مغايرة لكلا الوهمين معًا؛ إذ لا تُنتِج الفكرة أثرها لمجرّد عمقها أو صحتها، كما لا تصنع اللغة القريبة وعيًا لمجرّد ألفتها وسهولة تداولها. فالأفكار، مهما سمت، تظلّ عاطلة إن بقيت حبيسة التجريد، واللغة، مهما لانت، تظلّ فقيرة إن انفصلت عن المعنى المؤسِّس.
إنّ الأثر لا يتولّد من الفكرة وحدها، ولا من اللغة وحدها، بل من إدخالهما معًا في سلسلةٍ وظيفيةٍ مكتملة، تتدرّج بالمعنى من مقام الرؤية إلى مقام الحياة، ومن أفق المفهوم إلى أفق العمران. فالفرق بين فكرةٍ عظيمةٍ وأخرى مُثمِرة، ليس في صدق الأولى وكذب الثانية، ولا في علوّ لغةٍ وانخفاض أخرى، بل في قدرة الثانية على عبور المسافة الشاقّة بين التجريد والواقع.
وهذه المسافة لا تُقطع بقفزةٍ واحدة، ولا تُختصر ببلاغةٍ أو شعبوية، بل تُجتاز عبر سلسلةٍ من التحويلات المعرفية المتتابعة، لكل حلقةٍ فيها عقلٌ يؤدي وظيفة مخصوصة، ومقامٌ لا يغني عنه غيره. وحين تنكسر إحدى هذه الحلقات، يبقى المعنى معلقًا: لا هو باطل في ذاته، ولا هو قادر على أن يصير حياة.
من هنا يتشكّل سؤال هذه الورقة: كيف ينتقل المعنى من مقام الرؤية إلى مقام العمران؟ ومن هم الفاعلون الحقيقيون في هذا الانتقال؟ وأين تنكسر السلسلة حين تتعطّل الحضارات رغم وفرة الأفكار؟
أولًا: المعرفة القرآنية – من المعلومة إلى الأمانة
في الوعي الشائع، تُختزل المعرفة في كونها تراكمًا للمعلومات، أو امتلاكًا للمحتوى، أو رصيدًا ذهنيًا يُقاس بكثرة الاطلاع وسعة الحفظ. غير أنّ هذا الفهم، على شيوعه، يعزل المعرفة عن وظيفتها الوجودية، ويحوّلها إلى حالةٍ ذهنيةٍ محايدة، لا يُسأل صاحبها عمّا تُحدثه في رؤيته للعالم ولا في أثره داخله.
أمّا في النسق القرآني، فالمعرفة لا تُقدَّم بوصفها “ما يُعرَف”، بل بوصفها أمانةً تُحمَل؛ أمانةً لا تُقاس بعلوّ الخطاب عنها، ولا بقرب لغتها من الناس، بل بما تُحدثه من تحوّلٍ في البصيرة، واستقامةٍ في السلوك، وصلاحٍ في الواقع. ولهذا لا يمدح القرآن العلم من حيث هو تجميعٌ أو تكديس، بل يربطه دائمًا بثنائياتٍ كاشفة لوظيفته:
- إبصارٌ في مقابل عمى
- هدايةٌ في مقابل ضلال
- عملٌ في مقابل ادعاء
بهذا المعنى، لا تكون المعرفة القرآنية حالةً ذهنيةً ساكنة، بل حركةً سننية متدرجة: معنى يُدرَك، ثم قيمةٌ تُختار، ثم أثرٌ يُنجَز.
وكلّ توقفٍ عند مرحلةٍ من هذه المراحل، أو القفز فوق إحداها، يُفضي إلى اختلالٍ في وظيفة المعرفة، إمّا بتحويلها إلى تجريدٍ معزول، أو إلى خطابٍ سهلٍ بلا عمق، أو إلى ممارسةٍ جوفاء بلا بوصلة.
من هنا تنشأ الحاجة إلى ما نسمّيه في هذا السياق “السلسلة المعرفية الوظيفية”؛ إذ إنّ الأثر لا يخرج من المعنى خروجًا مباشرًا، ولا تُنتج الفكرة فعلها بذاتها، بل تعبر ضرورةً عبر وسائط بشرية ومعرفية متتابعة، لكل واحدةٍ منها وظيفة مخصوصة في تحويل المعنى من كونه مفهومًا مُدرَكًا إلى كونه واقعًا مُعاشًا.
ثانيًا: السننية الحاكمة لانتقال المعنى في القرآن
- سنة التدرّج: من الإشارة إلى البيان
المعنى في القرآن لا يُلقى دفعةً واحدة، ولا يُقدَّم في صورةٍ مكتملة منذ البدء، بل يُبنى عبر طبقات متتابعة: مثل، ثم قصة، ثم إشارة، ثم بيان. وهذا التدرّج لا يعود إلى نقصٍ في الخطاب ولا إلى تردّدٍ في المقصد، بل إلى منهجٍ تربويٍّ واعٍ يُدرّب العقل على الحركة، لا على الاستهلاك.
فالإشارة تفتح أفق السؤال، والقصة تُحرّك الوجدان، والمثل يقرّب المعنى، ثم يأتي البيان ليُثبّت الفهم ويضبطه. بهذا المعنى، لا يكون الإبهام عيبًا معرفيًا، بل وظيفةً تربوية تستدعي مشاركة العقل في بناء المعنى، كما لا يكون البيان مجرّد إشباعٍ ذهني، بل تثبيتًا سننيًا يمنع الانفلات والتأويل المنفصل عن المقصد.
ومن هنا، فإن انتقال المعنى في القرآن ليس انتقالًا معلوماتيًا، بل مسارًا تكوينيًا يُعيد تشكيل الوعي خطوةً خطوة.
- سنة وصل القول بالفعل
لا يعترف القرآن بمعرفةٍ معلّقة في حيّز القول، ولا يمنح القيمة لخطابٍ لا يجد طريقه إلى الفعل. فالمعنى، متى انفصل عن أثره، لا يبقى محايدًا، بل ينقلب—سننيًا—إلى حُجّةٍ على صاحبه. ولهذا تُدان الفجوة بين “ما نعلم” و”ما نفعل” لا بوصفها ضعفًا سلوكيًا فحسب، بل انكسارًا معرفيًا وأخلاقيًا في آنٍ واحد.
في هذا الأفق، لا يكون العمل مجرّد ثمرةٍ لاحقة للمعرفة، بل معيارًا لاختبار صدقها ووظيفتها. فالمعرفة التي لا تُغيّر وجهة الفعل، ولا تُعيد ترتيب الاختيار، تبقى ناقصة الوظيفة، مهما بلغت من الدقة أو البلاغة.
- سنة التمايز الوظيفي لا التفاضل القيمي
كما يقوم الكون على تمايزٍ وظيفيٍّ دقيق—ليلٌ ونهار، شمسٌ وقمر، برٌّ وبحر—تقوم المنظومة الإنسانية، في الرؤية القرآنية، على تمايز العقول والأدوار داخل النسق الحضاري. وهذا التمايز لا يُراد به المفاضلة القيمية بين الناس، بل تحقيق التكامل الوظيفي الذي لا يستقيم العمران بدونه.
فليست القيمة في علوّ المقام، ولا في قرب الدور من مركز الخطاب، بل في القيام بالأمانة الوظيفية على وجهها الصحيح. وحين يُقاس الناس بغير هذا الميزان—ميزان العلوّ لا الوظيفة—يختلّ النظام، وتتحول الأدوار من تكاملٍ سنني إلى صراعٍ رمزيٍّ عقيم.
ثالثًا: السلسلة المعرفية الوظيفية — بارادايم تداول المعنى
- السننية القرآنية؛ من الرؤية المطلقة إلى العمران
لا يمكن فهم انتقال المعنى في القرآن—ولا في الواقع الإنساني—دون التمييز الصارم بين مقاماتٍ أربعٍ متغايرة نوعيًا، لا تتفاضل بالدرجة بل تتمايز بالوظيفة. فالخلط بينها هو أصل التشويش المعرفي، في الدين كما في الفكر.
أول هذه المقامات هو كلام الله في اللوح المحفوظ؛ وهو ليس “معرفة” بالمعنى المتداول أصلًا، ولا موضوع إدراك أو تعقّل أو سننية، بل رؤية مطلقة متعالية، سابقة على كل قياس، وفوق كل حكم، وخارج منطق العمق والسطح. هنا لا نتحدث عن معنى يُفهَم، بل عن أصلٍ يُستمدّ منه المعنى. وهذا المقام يقابل—وظيفيًا لا ماهويًا—ما نسمّيه في الواقع البشري مصدر الرؤية، لا أداة التفكير.
ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي الأخطر والأدق: الإنزال. والإنزال ليس نقلًا ولا تبليغًا، بل تحويلٌ لغويٌّ كامل: انتقال كلام الله من لغته القدسية غير القابلة للتلقي، إلى لغةٍ قابلة للتلقي من المخلوقات، من غير أن يُمسّ المعنى في جوهره. هذه العملية ليست تبسيطًا، ولا اختزالًا، ولا تقريبًا بالمعنى الشائع، بل هي ترجمة إلهية محكمة تؤلِّف بين المعاني المطلقة والبنى اللغوية الممكنة. ومن هنا تُفهم دلالة ليلة القدر بوصفها “خيرًا من ألف شهر”: أي أرقى من كل جهد بشري في الترجمة، لأنها تحقّق ما تعجز عنه الترجمات البشرية دائمًا—نقل المعنى الكامل دون فقد.
بعد أن صار المعنى لغةً قابلة للتلقي، تأتي المرحلة الثالثة: التنزيل. وهنا يبدأ الوحي بوصفه نقلًا أمينًا للفظ والمعنى والبيان، عبر ناقلٍ مؤتمن، لا يُنشئ المعنى ولا يُحوّله، بل يحفظه كما هو في لغة التلقي، ويبلّغه باستحقاقاته. هذه المرحلة تمثّل نموذج الأمانة المعرفية الخالصة: لا اجتهاد فيها، ولا تأويل، ولا تجسيد، بل حفظ السلسلة من الانكسار.
ثم تأتي المرحلة الرابعة: الرسول ﷺ، بوصفه المتلقي البشري الأول. وهنا يحدث التحوّل الحاسم: من النص والبيان إلى الفعل والأثر. فالرسول لا يكتفي بتلقي اللفظ، بل يعي المعنى، ويبيّنه، ويعلّمه، ثم يعكسه في سلوكٍ وقدوةٍ وقيادة، فتتحول الرسالة إلى واقع، والمعنى إلى عمران. في هذا المقام، لا يعود السؤال: “ما الذي قيل؟” بل “كيف يُعاش؟”.
بهذه المقامات الأربع—الرؤية المطلقة، وتحويل اللغة، والنقل الأمين، والتجسيد العمراني—يقدّم القرآن النموذج السنني الأعلى لحركة المعنى. ومنه تُفهم السلسلة المعرفية في الواقع الإنساني: فالأفكار لا تُنتج أثرًا لأنها صحيحة، ولا لأن لغتها قريبة، بل لأنها تمرّ عبر هذه السلسلة دون خلط ولا اختصار. وكل محاولة لتجاوز مرحلة، أو دمج مقامٍ بآخر، تُنتج إما معرفةً متعالية بلا أثر، أو خطابًا سهلًا بلا عمق، أو ممارسةً جوفاء بلا بوصلة.
بهذا المعنى، لا تكون السلسلة المعرفية الوظيفية اختراعًا تنظيريًا، بل اقتداءً سننيًا بطريقة الوحي نفسه في تحويل المعنى من مصدره المتعالي إلى عمرانٍ حيّ.
- سننية التداول المعرفي؛ من الفكرة إلى الإنجاز
إذا كانت المقامات الأربع في حركة الوحي تُبيّن كيف انتقل المعنى من الرؤية المطلقة إلى العمران، فإنها تُقدّم في الوقت نفسه ميزانًا سننيًا يمكن به فهم أدوار العقول في تداول المعرفة البشرية. لا على سبيل المماثلة، ولا القياس العقدي، بل على سبيل التماثل الوظيفي: أي تشابه الوظائف مع اختلاف الطبيعة والمصدر.
- العقل المُؤسِّس — وظيفة الرؤية لا أداة الإدراك
يقابل العقل المُؤسِّس، في السلسلة البشرية، مقام كلام الله في اللوح المحفوظ من حيث الوظيفة لا من حيث الماهية. فكما أن كلام الله هو مصدر الرؤية المطلقة لا موضوع التلقي، فإن العقل المُؤسِّس في الواقع الإنساني لا يشتغل على الجزئيات ولا على التطبيقات، بل على بناء الإطار الكلي الذي تُفهَم به الأشياء أصلًا.
وظيفته ليست الشرح ولا التعليم ولا التنفيذ، بل: استخراج الرؤية الحاكمة، ضبط المفاهيم الكبرى، وتحديد السنن التي تُقاس بها الوقائع.
وخطر هذا العقل، حين يُساء فهم دوره، أن يُطالَب بما ليس من وظيفته: أن يبسّط، أو يُجامل، أو يُنتج أثرًا مباشرًا، فيُتّهم بالعجز، بينما الخلل في كسر السلسلة لا في قصوره.
- العقل المُفسِّر — وظيفة تحويل اللغة لا إنتاج المعنى
يقابل العقل المُفسِّر مقام الإنزال من حيث الوظيفة السننية: أي تحويل المعنى من أفقه العالي إلى لغة قابلة للتلقي دون إخلال بجوهره. فالعقل المُفسِّر لا يُنشئ الرؤية، ولا ينقلها كما هي في عليائها، بل يعيد صوغها في بنية لغوية ومفاهيمية يمكن للعقول الأخرى التعامل معها.
وهنا تقع أخطر الوظائف المعرفية: تأليف المجهول بالمشهور، وتقريب المعنى دون تسطيحه، وحفظ الرؤية من الذوبان في اللغة.
كما أن الإنزال الإلهي كان “خيرًا من ألف شهر” لأنه حقّق ترجمة كاملة بلا فقد، فإن العقل المُفسِّر يُمتحن دائمًا في قدرته على الترجمة الأمينة. وخطره الأكبر ليس في القرب من الناس، بل في أن يتحول من مُحوِّل للغة إلى مُفرِّغ للمعنى.
- العقل الإجرائي — وظيفة النقل المنضبط والبيان العملي
يقابل العقل الإجرائي مقام التنزيل من حيث الوظيفة، أي نقل المعنى بعد أن صار لغة قابلة للتلقي إلى صيغ منظَّمة يمكن العمل بها. فكما أن الوحي ينقل اللفظ والمعنى والبيان بأمانة عبر ناقلٍ مؤتمن، فإن العقل الإجرائي لا يُعيد تأويل الرؤية، ولا يُعيد صياغة اللغة، بل يعمل على: تحويل المعنى إلى نظم، وترجمته إلى مناهج وسياسات وبرامج، وضبط استحقاقاته العملية دون أن يتصرّف في جوهره.
هذا العقل يُختبر في أمانته أكثر مما يُختبر في إبداعه. وخطره الأكبر أن يتجاوز وظيفته، فيتصرف في المعنى باسم “الواقعية”، فينقله مشوّهًا، أو يُفرغه من قيمته لصالح الكفاءة الشكلية.
- العقل التداولي — وظيفة التجسيد والاختبار العمراني
ويقابل العقل التداولي مقام الرسول ﷺ من حيث كونه حامل المعنى إلى الواقع. فهنا لا يعود المعنى فكرة، ولا نظامًا، بل حياةً تُعاش. العقل التداولي هو عقل الناس والمؤسسات والممارسات اليومية، حيث تُختبر المعرفة لا بصدقها النظري، بل بقدرتها على الإصلاح والعدل والصمود.
في هذا المقام، لا يُطلب من العقل التداولي أن يؤسِّس أو يترجم أو ينظّر، بل أن: يُجسّد المعنى، ويختبره في الواقع، ويكشف صدقه أو زيفه بالأثر.
وخطر هذا العقل يكمن في الانتقائية: أن يأخذ من المعنى ما يخدم المصلحة، ويترك ما يُقيم القيمة، فيتحول التجسيد إلى استعمال، والعمران إلى توظيف.
ولتقريب هذه الوظائف إلى الذهن، لا على سبيل الحصر بل التمثيل، يمكن النظر إلى العقل المؤسِّس بوصفه صاحب الرؤية الذي يضع الإطار الكلي للمعنى، وإلى العقل المُفسِّر بوصفه الوسيط الأمين الذي ينقل هذه الرؤية إلى أفق الفهم العام، وإلى العقل الإجرائي بوصفه مهندس النظم الذي يحوّل المعنى إلى بنى قابلة للحياة، وإلى العقل التداولي بوصفه الممارس الذي يختبر صدق المعنى في الواقع.
وهذه النماذج لا تتمايز بالقيمة، بل بالوظيفة؛ وقد يجتمع أكثر من دور في شخص واحد، كما قد تتوزع الأدوار على جماعة، والعبرة دائمًا بسلامة السلسلة لا بعلوّ موقعٍ فيها.
رابعًا: الأمانة معيار التفاضل القرآني
وهكذا نى أنه في هذا البارادايم، لا تُقاس القيمة بعلوّ اللغة، ولا بعمق المصطلح، ولا بمركز الموقع داخل السلسلة، بل بالوفاء للأمانة الوظيفية. فالأدوار، مهما اختلفت، لا تكتسب شرعيتها من مقامها، بل من أمانة أدائها.
والأمانة هنا ليست خُلُقًا عامًا يُمدح في المطلق، بل ميزانًا سننيًا حاكمًا يُقاس به صدق انتقال المعنى من حلقة إلى أخرى. وهي أمانة ثلاثية، تتوزع على السلسلة كلها:
- أمانة المعنى: ألا يُحرَّف الجوهر عند النقل أو التفسير أو الإجراء، وألا يُستبدل المعنى المؤسِّس بمعانٍ مريحة أو رائجة.
- أمانة المقصد: ألا يُسخَّر المعنى لمصلحةٍ سلطوية، أو شهرةٍ رمزية، أو هيمنةٍ فكرية، وألا يُستخدم الخطاب غطاءً لانحرافٍ في الغاية.
- أمانة الأثر: ألا يُترك المعنى معلقًا في حيّز القول، وألا يُحوَّل إلى نظامٍ بلا روح، أو ممارسةٍ بلا عدل، بل أن يُمكَّن له في الواقع بما يحقق مقصده العمراني.
بهذا الميزان، لا يعود التفاضل بين العقول تفاضل مراتب، بل تفاضل أمانات؛ وقد يَسقط مؤسِّسٌ في الأمانة، ويَصدق ممارسٌ بسيط، لأن العبرة ليست بمن قال، بل بمن صان السلسلة من الانكسار.
خامسًا: السلسلة بوصفها اعترافًا سننيًا بالتنوّع البشري
لا تقوم هذه السلسلة المعرفية على افتراض تماثل العقول، ولا على توحيد الطاقات، بل على العكس تمامًا: فهي تُبنى على الاعتراف السنني بالتنوّع البشري في القدرات، والميول، والمهارات، والأدوار. فاختلاف العقول هنا ليس خللًا يُعالَج، بل شرطًا يُحتَضَن، لأن المعنى لا يعبر مراحله إلا بتعدّد الحوامل له.
بهذا المعنى، لا يكون التمايز بين العقول تمايزَ تفاضلٍ قيمي، بل تمايزَ وظائف، يتكامل فيه المؤسِّس والمفسِّر، والمنظِّم والممارس، دون أن يُلغِي أحدُهم الآخر أو يستعلي عليه. وهذا ما يمنح لكل فرد—مهما كان موقعه—قيمةً حقيقية في البناء الحضاري، لا بوصفه تابعًا، بل بوصفه حاملًا لأمانة مخصوصة.
قرآنيًا، لا يُقرأ هذا التنوّع على أنه توزيع اعتباطي للقدرات، بل على أنه تنظيم سنني للحياة: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾؛ أي ليُسخَّر الاختلاف للتكامل لا للهيمنة، وللتعاون لا للإقصاء. فالسُّخرة هنا ليست امتهانًا، بل تبادُلًا وظيفيًا يجعل قيام أحدهم مشروطًا بغيره.
بهذا الفهم، تتحول السلسلة المعرفية من نموذجٍ نخبوي مغلق إلى نموذج إنساني جامع، تشارك فيه العقول بحسب ما أُوتيت، وتنهض فيه الحضارات لا حين يتشابه الناس، بل حين يُحسنون العمل باختلافهم.
سادساً: المعرفة الجسرية — من كفاءة التخصص إلى سلامة الفهم
هنا تبرز مسألة حاسمة لا يجوز تركها في دائرة الإيحاء: فالسلسلة المعرفية لا تنكسر فقط بغياب أحد العقول الأربعة، بل قد تنكسر رغم حضورها جميعًا، حين يتحول كل عقل إلى جزيرةٍ تخصصيةٍ مغلقة، تؤدي وظيفتها تقنيًا، لكنها تفقد القدرة على فهم السياق الكلي الذي تعمل داخله. وهذا الخلل لا يعود إلى ضعف في الذكاء أو الكفاءة، بل إلى أحادية البعد المعرفي.
فالعقل التخصصي الإجرائي—كالعقل الرياضي أو الفيزيائي أو الكيميائي—حين يُحاصر نفسه داخل قوانين المنطق الصوري أو التجريب العلمي الخالص، ويعزل تفكيره عن الأدب، والخيال، والقيم، والأسئلة الإنسانية الكبرى، يتحول إلى عقلٍ عالي الدقة فقير الرؤية. يمتلك أدوات قوية، لكنه لا يمتلك أفقًا يوجّه استخدامها. فيفهم “كيف يعمل الشيء”، لكنه يعجز عن سؤال: “لماذا؟ ولأي غاية؟ وبأي كلفة إنسانية؟”.
وفي المقابل، قد يقع العقل الأدبي أو النصّي في اختزالٍ معاكس؛ إذ ينغمس في اللغة، والرمز، والخيال، ويُفرط في الاشتغال على النص بمعزلٍ عن منطق العلاقات، والمعادلات، والسنن الحاكمة للواقع. فيصبح عقلًا غنيّ التعبير ضعيف البنية التحليلية، قادرًا على الوصف والإيحاء، لكنه عاجز عن الانتقال من الجمال اللغوي إلى الفهم البنيوي، ومن التأويل إلى الاستقراء.
هذان النموذجان لا يُمثّلان خللًا في التخصص ذاته، بل خللًا في وحدانية البعد؛ حين يعمل العقل داخل حقلٍ واحدٍ مغلق، ويظن أن أدواته الخاصة كافية لفهم كل شيء. وهنا تحديدًا تتجلّى وظيفة ما نسمّيه المعرفة الجسرية.
فالمعرفة الجسرية لا تعني الجمع السطحي بين العلوم، ولا الادعاء بالإحاطة بكل الحقول، بل تعني القدرة على إبقاء المعنى حيًّا أثناء عبوره بين التخصصات. هي وعيٌ يسمح للعقل:
- أن يمارس التخصص دون أن يتحول إلى سجن،
- وأن يستعمل الأداة دون أن يعبدها،
- وأن يحفظ للمعنى عمقه الإنساني وهو يُنظَّم ويُقنَّن ويُطبَّق.
بهذا المعنى، ليست المعرفة الجسرية عقلًا خامسًا، ولا مقامًا أعلى من العقول الأربعة، بل شرط سلامة داخلي يمكن أن يظهر في أي عقل منها. فقد يكون الفيلسوف أحادي البعد، وقد يكون المهندس جسريًا، وقد يكون الأديب منغلقًا، وقد يكون الممارس اليومي واسع الأفق. العبرة ليست بالمسمّى، بل بقدرة العقل على رؤية ما وراء حدوده دون أن يفقد وظيفته.
قرآنيًا، لا يُفهم هذا الوعي بوصفه ترفًا معرفيًا، بل بوصفه مقتضى لتكامل أدوات الإدراك: سمعٍ لا ينفصل عن بصر، وبصرٍ لا يُغني عن فؤاد، وعلمٍ لا يُثمر بلا عمل. ومن هنا، فإن غياب هذا الوعي لا يُنتج خطأً فوريًا، بل يُراكم تشوّهات صامتة:
- علمًا بلا حكمة،
- ونصًّا بلا سنن،
- ونظامًا بلا روح،
- وواقعًا يفقد المعنى وهو يظنّ نفسه متقدمًا.
ولهذا لا تُستوفى المعرفة الجسرية في هذا الموضع، لأنها ليست تفصيلًا في السلسلة، بل آلية صيانتها، وتستحق معالجة مستقلة تُبنى عليها بوصفها أداة النهضة المعرفية، لا مجرد توصيفٍ إنساني عام.
سابعًا: الانكسار الحضاري حين تنقطع السلسلة
بهذا الميزان، يمكن قراءة كثير من أزماتنا المعاصرة لا بوصفها نقصًا في الذكاء، ولا فقرًا في الأفكار، ولا حتى ضعفًا في الموارد، بل بوصفها نتائج سننية مباشرة لانكسار السلسلة التي تنقل المعنى من الرؤية إلى العمران. فالخلل لا يقع غالبًا في وجود الأفكار، بل في تعطّل الطريق الذي ينبغي أن تسلكه كي تصير وعيًا حيًّا وواقعًا مُصلحًا.
فعندما ينفصل التأسيس عن التفسير، وتُنتَج الرؤى في أبراج مفهومية مغلقة، دون أن تجد من يحوّلها إلى لغة قابلة للتداول، تتكوّن نخبوية معزولة: أفكار صحيحة في ذاتها، لكنها عقيمة الأثر، لأنها لم تدخل مسار الحياة.
وحين يحدث العكس، فيُمارَس التفسير بلا تأسيس، وتُتداول الأفكار بمعزل عن أصولها المفهومية وسننها الحاكمة، تنشأ ثقافة استهلاكية، غزيرة الخطاب، فقيرة المعنى، تتغيّر بتغيّر المزاج العام، ولا تملك معيارًا ثابتًا للتمييز والاختيار.
وحين يُنزَع الإجراء عن القيمة، وتتحول الأنظمة واللوائح والسياسات إلى غايات في ذاتها، منفصلة عن مقاصدها الأخلاقية والإنسانية، تتكوّن بيروقراطية جوفاء: مؤسسات تعمل بكفاءة شكلية، لكنها تُفرغ المعنى من روحه، وتحوّل التنظيم من أداة عمران إلى عبء خانق.
وحين يُترك التداول بلا وعي، ويُختزل التجسيد في مجرد استعمال نفعي، دون اتصال بالرؤية أو بالقيمة، تتحول المعرفة إلى سلعة، ويظهر نمط من الانتهازية المعرفية، حيث يُنتقى من الأفكار ما يخدم المصلحة الآنية، ويُقصى ما يطالب بالمسؤولية أو يفرض كلفة أخلاقية.
في جميع هذه الصور، لا تكمن المشكلة في غياب الأفكار، ولا في ضعف العقول، بل في انكسار السلسلة التي تحفظ للمعنى مساره السنني. فحين لا ينتقل المعنى انتقالًا سليمًا من مقام إلى مقام، لا يفشل لأنه خاطئ، بل لأنه لم يُمنَح فرصة أن يصير حياة.
غير أنّ انكسار السلسلة لا يقع فقط حين يغيب أحد عقولها، بل يقع-وهو الأخطر-حين يغيب الوعي بوجود السلسلة أصلًا. فعندها لا تُكسر حلقة بعينها، بل تُشوَّه الوظائف كلّها، ويُحمَّل كل عقل ما ليس من مقامه.
في هذا السياق، يُطالَب العقل المؤسِّس بأن يُبسِّط الرؤية، وأن ينزل بلغته إلى التداول اليومي، وأن يكون مفسِّرًا وإعلاميًا ومحرّكًا جماهيريًا في آنٍ واحد. فإذا لم يفعل، وُصِف بالعزلة والنخبوية والانفصال عن الواقع. وحين يفعل-إن فعل-يفقد لغته، ويُفرِّغ مفاهيمه من عمقها، ويشتغل بما لا يُتقنه، فيضيع دوره دون أن ينجح في غيره.
هذا العبء غير العادل لا يقتل الفكرة فقط، بل يستنزف صاحبها؛ فينتهي الأمر بندرة العقول المؤسسة، لا لندرة الذكاء، بل لأن البيئة لا تعترف بوظيفة التأسيس، ولا تحمي لغته، ولا تُدرك أن الرؤية لا تُقاس بسرعة تداولها، بل بقدرتها على ضبط المعنى قبل تداوله.
وينطبق هذا الخلل-بصيغ متباينة-على بقية العقول أيضًا؛ فالمفسِّر يُطالَب بالتأسيس، والإجرائي يُطالَب بالإبداع الفلسفي، والتداولي يُطالَب بالتنظير، فيضيع الجميع في تيه وظيفي، لا يُتقنه أحد، وتفقد السلسلة اتساقها من الداخل.
بهذا المعنى، لا يكون فقر الأمة بالأفكار الكبرى، ولا ندرة العقول المؤسسة، دليل عقمٍ حضاري، بل نتيجة سننية مباشرة لغياب الوعي بتوزيع الأمانات المعرفية، ولانكسار السلسلة قبل أن تبدأ.
خاتمة: المعرفة تسبيحًا… والعمران حمدًا
يبيّن هذا المسار أن المعرفة لا تعمل في التاريخ بوصفها فكرةً صحيحة تُلقَى، ولا بوصفها خطابًا يُتداول، بل بوصفها حركةً سننية لا تُنتج أثرها إلا إذا سلكت طريقها كاملًا. فالمعنى لا ينهض وحده، ولا يستقر في عقلٍ واحد، ولا يتحقق بلغةٍ واحدة، بل يحتاج إلى سلسلةٍ تحفظ انتقاله، وتُوزِّع حمله، وتصون وظيفته في كل مقام.
وتكشف هذه السلسلة أن اختلاف العقول والطاقات ليس عائقًا حضاريًا، بل شرطه الضروري؛ إذ لا يُحمل المعنى إلا بتعدّد حامليه، ولا يُترجم إلا بتنوّع لغاته، ولا يُنظَّم إلا بتباين أدواته، ولا يُختبر إلا بتجسيده في واقع الناس. بهذا الفهم، يغدو التنوع البشري تنظيمًا سننيًا للعمل، لا خللًا يُعالَج، ولا تفاضلًا قيميًا يُستثمر.
كما يتبيّن أن الخلل الحضاري لا ينشأ من فقر الأفكار، بل من انكسار السلسلة: حين يُجهَل وجودها، أو تُحمَّل العقول ما ليس من أدوارها، أو تُفصل الوظائف عن مقاصدها، فيُستنزف المؤسِّس، ويُفرَّغ المفسِّر، وتُشكَّل البيروقراطية، ويضيع المعنى في التداول. عندها لا تفشل المعرفة لأنها خاطئة، بل لأنها لم تُمنَح مسارها السنني.
وعليه، فإن استئناف الفعل الحضاري لا يبدأ بإنتاج مزيد من الخطاب، ولا باستدعاء “العقل المنقذ”، بل بإعادة بناء الطريق الذي تسلكه المعرفة، وحماية التمايز الوظيفي بين العقول، وضبط الأمانة في انتقال المعنى من مقام إلى مقام. فحين يُصان هذا المسار، تتحول المعرفة من رأسمال رمزي إلى قوة عمرانية، ويغدو الاستخلاف نتيجةً طبيعية لعمل السنن لا لشعاراتها.
بهذا المعنى، ليست الحضارة صوتًا واحدًا، ولا مركزًا واحدًا، بل جريانًا محفوظًا: كلٌّ يعمل حيث وُضع، وكلٌّ يُسهم بما أُوتي، حتى يبلغ المعنى غايته في الحياة، لا معلّقًا في القول، بل مُثمِرًا في العمران.
27/12/2025