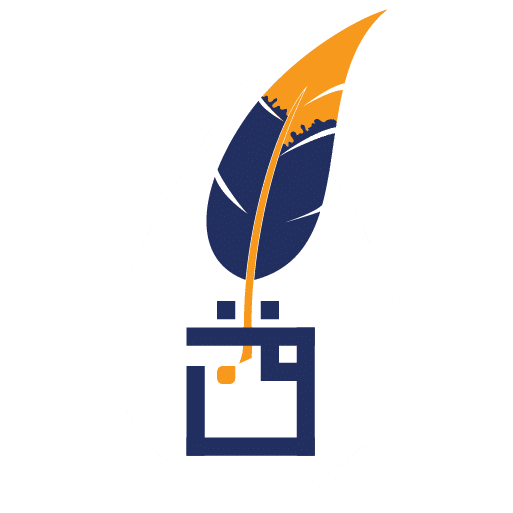في تشخيص فشل العمل المؤسسي في الريف
أيمن قاسم الرفاعي
استهلال لا بد منه
في البلدات الصغيرة، لا يوجع الفشل لأنه فشل مشروع، بل لأنه يكشف صدعًا في علاقتنا ببعضا، ثم نُقنع أنفسنا أن ما جرى كان قضاءً وقدرًا، أو سوء طالع، أو خذلان أشخاص بعينهم. في القرى والبلدات الصغيرة، حيث يعرف الناس بعضهم بعضًا، وحيث الذاكرة طويلة، والحساسية عالية، يصبح الفشل الجماعي أكثر إيلامًا؛ لأنه لا يُسجَّل على مشروعٍ عابر، بل على النسيج الاجتماعي نفسه.
هذه القراءة لا تُكتب لتُدين أحدًا، ولا لتمنح صكوك براءة لأحد. إنها محاولة لفهم لماذا تتعثر المبادرات المشتركة مرارًا، ولماذا يولد كثير من المشاريع واعدًا ثم يذبل بصمت، ولماذا يتحول الحلم الجمعي سريعًا إلى شكّ، ثم إلى انسحاب، ثم إلى صمت ثقيل.
التشخيص هنا ليس ترفًا فكريًا، بل شرط نجاة؛ فلا بناء بلا فهم، ولا ترميم بلا كشف الشقوق، ولا معنى لأي حلٍّ يُلقى من فوق إن لم ينبع من وعي الناس بذواتهم وواقعهم. لإنه هناك فشلٌ بنيويٌّ متراكم، تشكّل عبر عقود طويلة، وتفاقم بفعل الحرب، ينكشف مع أول محاولةٍ جديّة لبناء عملٍ مؤسسيٍّ منظم.
والتشخيص الصادق لا يبدأ من السؤال: من أخطأ؟ بل من سؤال أعمق: ما الذي في البنية نفسها يجعل الخطأ يتكرر، مهما تغيّر الأشخاص؟
أولًا: بنية اجتماعية شبكية
تاريخيًا، قام الريف اجتماعياً على أمرين أساسيين العائلة والعشيرة، والنظام الزراعي التعاوني. فالعلاقة الأساسية فيه علاقة دمٍ وقربى، ونسب ومصاهرة، فما يغفل عنه نسب الرجل، يستدركه نسب المرأة، فهي حكماً ليست علاقة قانونٍ أو دورٍ أو وظيفة او حتى سكن. وهذا النموذج كان كافيًا وناجحاً حقيقة يوم كانت الحياة ريفية بسيطة، والزراعة هي بوتقة العمل، والقرارات محدودة، والمصالح مشتركة وواضحة. فقد قام الريف أساساً على نظامٍ اجتماعيٍّ زراعيٍّ كامل صنعته ظروفُ الإنتاج القديمة:
- الأدوات بسيطة ومتأخرة نسبيًا.
- اليد العاملة قليلة أو موسمية.
- الزراعة تحتاج تعاونًا طبيعيًا لا رفاهية فيه.
- المخاطر مشتركة: ماء، موسم، آفة، قحط، دين.
هذا كله هو ما أنتج مستوىً من (التساوي الواقعي)، ليس تساويًا أخلاقيًا مثاليًا، بل تساويًا فرضته الحاجة؛ وليس نستالوجيا ترفع الماضي إلى مثالية أخلاقية غير واقعية، لأن أحدًا وحده لا يقدر أن يفعل كل شيء، ولأن “الخبز” الذي كان يمثل الحياة كان يمر من قناة التعاون.
لكن هذا التساوي لم يكن تساوي مؤسسةٍ بقانونٍ مكتوب، بل تساوي حقلٍ وحاجةٍ وعُرف. كان الريف ينجح لأنه يعيش ضمن اقتصادٍ يفرض التعاون تلقائيًا، لا ضمن إطارٍ مؤسسي يحتاج قواعد رسمية وإجراءات شفافة ومحاسبة.
ثم حدث التحول الكبير؛ ضعفت الزراعة، وتشوهت صورتها، وفاضت اليد العاملة، وظهرت أشكال رزق جديدة، وهاجرت الكفاءات، ودخل المال من منافذ مختلفة. فانفكّ الضغط الذي كان يفرض التعاون، وبقيت “شبكة العلاقات العضوية” وحدها بلا ضرورة إنتاجية تحفظها. هنا ظهر الريف بنسخته الحديثة المربِكة: لا هو ريفٌ بزراعته التي تضبط إيقاعه، ولا هو مدينةٌ بمؤسساتها التي تضبط مصالحها. فتسرب الفراغ إلى الداخل: الفراغ التنظيمي، وفراغ الثقة، وفراغ المنجز، وفراغ المرحلة. وهنا ظهرت المفارقات:
- المؤسسة تحتاج قواعد عامة، بينما العائلة تعمل بالاستثناء.
- المؤسسة تفترض المساواة الوظيفية، بينما القرابة تفترض الامتياز الضمني.
وهنا يبدأ التفكك. فما إن يدخل الشأن العام حيّز الفعل، حتى تُستدعى الاعتبارات الشخصية: “هذا ابن فلان”، “ذاك لا يجوز تجاوزه”، “لا نريد أن نكسر خاطر أحد”.. فيتحوّل العمل الجماعي من مشروعٍ عام إلى شبكة موازنات شخصية، وتفقد المؤسسة روحها قبل أن تكتمل صورتها.
ثانيًا: قيادة بلا شرعية كفاءة
في كثير من الحالات، لا تُبنى القيادة في الريف على الكفاءة أو الرؤية أو القدرة على الإدارة، بل على واحدٍ من خمسة: (السن، المكانة الاجتماعية، القدرة المادية، شبكة العلاقات الحكومية، القدرة على “إطفاء المشاكل” لا على “بناء نظام”.
فيُسلَّم الشأن العام لمن “هو موجود وراغب”، لا لمن “هو كفء ومؤهل”. وتُختزل القيادة في شخصٍ لا في مشروع. وهكذا تتحوّل المؤسسة إلى هيكل بلا عقل، وتتحوّل الاجتماعات إلى طقوس، والقرارات إلى مجاملات، والعمل إلى استنزاف صامت للناس الجادين.
في القديم، كثير من العلاقات كانت تتوازن بضغط الضرورة: العمل الزراعي يفضح المتكبر، ويُسقط المتقاعس، ويُظهر صاحب الفعل. لكن مع التحولات الحديثة، تقلّصت تلك الضرورة الجامعة، وحلّ محلها ما يمكن تسميته: اقتصاد الوجاهة بدل اقتصاد الحاجة. صار لبعض الناس موارد لا علاقة لها بتعاون البلدة: (وظيفة خارج البلدة، دخل من سفر، تجارة مرتبطة بشبكات أوسع، علاقات تمكّن وتؤمّن). وحين يتسع التفاوت ويضعف معيار الإنتاج الحقيقي داخل البلدة، تتغيّر نفسية المجتمع: لا يعود “الإنجاز” واضحًا أمام الجميع كما كان في الحقل، فتنشأ مساحة رمادية يتسلّل فيها ما يسمى بدقة: روح التحاسد.
وهنا لا بد من إدخال عاملين بطريقة غير متكلفة، لأنهما فاعلان حقيقيان في الريف: (سلطة رجال المال، وسلطة رجال الدين).
المال لا يقود لأنه يحمل مشروعًا، بل لأنه يمسك “أعصاب” حاجات الناس: يدفع، يموّل، يعالج أزمة، يسد نقصًا، فيكتسب شرعية غير معلنة. ثم يتحول التمويل من وسيلة خدمة إلى وسيلة ضبط: من يعارض يُتهم بالجحود، ومن يطلب شفافية يُتهم بأنه “يكسر اليد التي تساعد”.
أما الدين، فإن الريف يحترم الدين بطبيعته، وهذا احترام جميل حين يكون الدين قيمة أخلاقية، وليس تمظهراً شكلياً، وهذه لب المشكلة حين تتحول بعض المرجعيات بحكم وظيفتها الدينية إلى هيبة اجتماعية محصنة عن المساءلة: (لا يُسأل: ما خطتك؟ ما خبرتك؟ ما نظامك؟). بل يُكتفى بهالة: (لا نريد أن نحرجه… لا نريد فتنة… الرجل له مقام).
فتصبح القيادة “رمزًا” لا وظيفة، و”هيبة” لا كفاءة. وتصبح المؤسسة طقوسًا: اجتماعٌ لالتقاط صورة، كلمةٌ طويلة، وعودٌ عامة، ثم لا متابعة ولا محاسبة. والنتيجة الطبيعية حتماً: الأشخاص الجادّون يتعبون ويغادرون بصمت، والذين يحبون الواجهة يبقون لأن الواجهة غذاؤهم.
ثالثًا: التحاسد وعدم الثقة وتناميهما بعد الحرب بوصفه آلية دفاع نفسي واجتماعي
الحسد في المجتمعات الصغيرة، ولا سيما الريفية منها، لا يمكن قراءته بوصفه رذيلة أخلاقية فردية فحسب، ولا باعتباره خللًا في “نوايا الناس”، بل هو في كثير من الأحيان آلية دفاع نفسي جماعي تنشأ حين تضيق مساحات الإنجاز الحقيقي، وتُسَدّ آفاق التقدّم، ويشعر الفرد أن الزمن يمضي من حوله دون أن يترك له أثرًا يُعتدّ به. في ظروف كهذه، لا يعود الإنسان قادرًا على ترميم صورته الذاتية عبر العمل والنجاح، فيلجأ – من حيث لا يشعر – إلى بدائل رمزية أقل كلفة نفسيًا، وأكثر سرعة في الأثر الاجتماعي. وهنا تتشكّل ما يمكن تسميته اقتصاد الانتقاص بوصفه بديلًا عن اقتصاد الإنجاز.
فتُستبدل الأسئلة البنّاءة بأسئلة هدّامة:
- بدل: ماذا أستطيع أن أقدّم؟ يصبح السؤال: لماذا هذا الشخص تحديدًا يتقدّم؟
- بدل: كيف ننجح جميعًا؟ يتحوّل الهمّ إلى: كيف نمنع أحدًا من أن يبرز؟
وتظهر أنماط سلوكية متكررة:
- بدل أن أرفع مستواي… أُسقِط مستوى غيري بالكلام.
- بدل أن أعمل على الفكرة… أُشكّك في نوايا أصحابها.
- بدل أن أنضج وأتحمّل مسؤوليتي… أُحمّل كل ناجح تهمة جاهزة: سياسية، أخلاقية، أو اجتماعية.
بعد سنوات الحرب، يتضاعف هذا النمط لأسباب أعمق: فالحرب لا تدمّر البنى المادية فقط، بل تُخلخل الإحساس بالعدالة الزمنية:
- من ضحّى كثيرًا ولم يحصد، يرى في نجاح غيره تهديدًا لمعنى تضحياته، لا فرصةً للتعلّم منها.
- ومن بقي على الهامش طويلًا، يتعامل مع أي محاولة تنظيم أو بناء بوصفها إدانة ضمنية لفشله، لا مشروعًا عامًا.
- ومن رأى سماسرة الأزمات والمنتفعين والمتلونين يتصدرون ولو جزءا من المشهد ثانية، يفقد أي قيمة لديه بعدالة الحياة والناس.
وهكذا لا يعود أي خلاف هو اختلاف رأي؛ يصبح “تاريخًا” بين الناس. فتدخل المؤسسة إلى ساحةٍ ملغّمة: أي خطوة تُقرأ سياسيًا. أي نجاح يُقرأ كتهديد. أي تمويل يُقرأ كشراء ولاءات. أي علاقة تُقرأ كاصطفاف. ولأن البلدة فضاء ضيّق، والسمعة فيه رأس مال أساسي، يصبح الكلام أداة تأثير خطيرة: همسة واحدة قادرة على إرباك مشروع، وشكّ عابر قد يُسقط ثقةً بُنيت بشقّ الأنفس، وتلميح غير مسؤول قد يُفكّك فريقًا كاملًا. في هذا المناخ، لا يُقاس النفوذ بما يُبنى، بل بما يُعطَّل، ولا تُمنح المكانة لمن يُنجز، بل لمن يُتقن التشكيك، ويتحوّل المجتمع – تدريجيًا – من سؤال: “ماذا سنبني معًا؟” إلى سؤال خفيّ أكثر خطورة: “من سيظهر؟ ومن يجب ألّا يظهر؟”
في ظل هذا الإرث، كثير من الصالحين ينسحبون لأنهم لا يريدون أن يُلوّثوا حياتهم بمعارك لا تنتهي. فتبقى الساحة غالبًا لمن يملك جلدًا على الصراع اللاأخلاقي، لا لمن يملك أخلاق البناء. فالمجتمع الذي لا يحمي فاعليه، يخسرهم واحدًا بعد واحد، ويبقى أسير الحلقة نفسها. وعند هذه النقطة تحديدًا، لا تفشل المؤسسة فحسب، بل يفشل حتى الخيال الجمعي القادر على تصوّر المؤسسة بوصفها قيمة ممكنة.
رابعًا: غياب الوعي الفردي والرؤية الجامعة في ظل انغلاقٍ فكريٍّ موروث
العمل المؤسسي لا ينهض على حسن النوايا وحده، ولا على الرغبة الصادقة في “فعل الخير”. إنه يحتاج قبل كل شيء إلى وعي فردي ناضج، وإلى رؤية جامعة تُجيب بوضوح عن سؤالين بسيطين في ظاهرهما، مصيريين في أثرهما: لماذا نفعل هذا؟ وإلى أين نريد أن نصل؟. في كثير من تجارب العمل الجماعي في البلدات الريفية، يغيب هذان السؤالان أو يُستبدلان بإجابات مطمئنة ظاهريًا لكنها فارغة وظيفيًا: (نريد مصلحة البلدة، نقوم بواجبنا، نمشي الأمور بالبركة)، هذه العبارات لا تحمل أي رؤية حقيقة، بل تقود الناس في غفلة من الوعي إلى الفشل حتماً، لأن الخير حين لا يُنظَّم، يتحوّل إلى فوضى؛ والنية حين لا تُترجم إلى هدف، تتحوّل إلى إنهاك؛ والاستمرار بلا بوصلة لا يصنع مسارًا، بل دورانًا في المكان.
ويزداد هذا الخلل عمقًا حين يُغطّى بغطاء ثقافي جاهز يُسمّى “التراث”. ففي كثير من الحالات، لا يُستدعى التراث – العادات او الأعراف أو التقاليد او اخطرها التقليد المتوشح باسم الدين- بوصفه خبرةً حيّة تراكمت عبر الزمن، ولا بوصفه ذاكرة قابلة للتطوير، بل بوصفه أداة ضبط وإغلاق. فيُرفض الجديد لأنه “ليس من عادتنا”، وتُتَّهَم المرونة بأنها “تفريط”، ويُخلط بين الأصالة والجمود، وبين الهوية والخوف من التغيير، وهكذا، بدل أن يكون التراث جسرًا بين الماضي والحاضر، يتحوّل إلى جدار مصمت. وبدل أن يمنح المجتمع ثقةً بنفسه، يزرع فيه الارتياب من كل فكرة مختلفة، ومن كل محاولة لتنظيم العمل خارج القوالب المألوفة.
المجتمعات الحيّة لا تحفظ تراثها بالتقديس الأعمى، بل بالتجديد الواعي. أما حين يُغلِق المجتمع على نفسه باسم حماية الهوية، فإنه لا يحميها في الحقيقة، بل يختنق بها. وفي مناخٍ كهذا، يغيب الوعي الفردي القادر على السؤال، وتغيب الرؤية الجامعة القادرة على الجمع، ويتحوّل العمل الجماعي إلى جهود متناثرة، صادقة أحيانًا، لكنها عاجزة عن التراكم والبناء.
خامساً: خلاصة التشخيص
ليس فشل العمل المؤسسي في البلدة الريفية سببه “ناس سيئون”، بل بنية لم تُهيّأ بعد لاستقبال المؤسسة. والحل لا يبدأ بحلول جاهزة، ولا بنسخ تجارب مدن أخرى، ولا بتغيير الأشخاص فقط. بل يبدأ من الاعتراف:
- بأننا نعمل بعقلية القرابة لا بعقلية الدور،
- وبأننا نخاف النجاح أكثر مما نفشل،
- وبأننا نحتاج ترميم الثقة قبل بناء الهياكل،
- وبأن التشخيص الصادق هو أول أشكال الاحترام للمجتمع.
وحين نصل إلى هذا الوعي، نكون قد وضعنا القدم الأولى في طريق التصحيح، لا لأن الحل قُدِّم، بل لأن الوعي استيقظ.
سادساً: الحلول ليست وصفات بل تحويلات في القواعد وبناء سنني
لن يكون الحل عبارة عن “إحضار أشخاص أفضل” فقط، لأن الأشخاص الأفضل إذا دخلوا بنيةً مريضة ستُمرضهم أو ستطردهم. الحل الحقيقي هو نقل البلدة تدريجيًا إلى منطق “القيمة تحكم”، دون سحق القرابة أو احتقار التراث. لا أدعي أني املك الحل أو الوصي على آلياته، وإنما رؤية تشكلت لدي من واقع الخبرة الحياتبة بحكم النشأة والمختصة بحكم الدراسة، وما أقدمه آتياً ليس حلولًا سريعة، ولا برنامجًا جاهزًا، بل اتجاهات تغيير إن بدأنا بها، تغيّر الباقي تلقائيًا.
- تحويل القرابة من أداة محاباة إلى طاقة حماية
لا أحد يطلب من الريف أن يتخلّى عن العائلة، لكن المطلوب أن تتغير وظيفة العائلة: بدل أن تكون باب امتيازات، تصبح شبكة حماية للمؤسسة: تحمي الناس من الانتقاص، وتردع التشويه، وتدعم النظام لا الاستثناء. وهذا يبدأ بجملة واحدة يفهمها الجميع:
الخواطر تُحفظ بالعدل، لا بالاستثناء. لأن الاستثناء لي ظلم لغيري اليوم وهو سيرتد وسيُنتج ظلمًا معكوساً مضطراً غدًا، والظلم يقتل الجماعة.
- صناعة شرعية الكفاءة: إعلان قواعد بسيطة لا تُهين أحدًا
الريف يرفض الاستعلاء، ويقبل القواعد حين يشعر أنها عادلة، لذلك تُصاغ الشرعية بكلمات بسيطة:
- المسؤولية تكليف لا تشريف.
- المنصب مدة محددة.
- القرار يُوثّق.
- المال يُعلن.
- العمل يُقاس.
هذه ليست نُخبويّة، هذه “كرامة عامة”: عندما يعرف الناس أن الأمور ليست مزاجًا، يهدأ التنافس ويقلّ التشويه.
- تفكيك التحاسد عبر فتح منافذ إنجاز حقيقية
التحاسد لا يُهزم بالخطب، بل يُهزم عندما تُتاح للناس فرص “ينجحون فيها”. افتحوا مشاريع صغيرة متدرجة: لجنة نظافة شهرية، مبادرة تعليم، ورشة مهنية للشباب، صندوق طوارئ بشفافية، مشروع ترميم بسيط، أي مشروع له قيمة مجتمعية هو جزء من الحل، وكل مشروع صغير ناجح يُنقص مساحة الكلام، ويزيد مساحة الفعل، والأهم: اجعلوا النجاح “مشاعًا”: لا ترفعوا شخصًا فوق الناس، ارفعوا معيارًا فوق الجميع. فالناس لا تحسد معيارًا، لكنها تحسد شخصًا.
- مصالحة ما بعد الحرب: قاعدة “لا نفتح الملفات… ولا نسمح بتكرارها”
ليس مطلوبًا أن يتصالح الجميع عاطفيًا؛ هذا قد يحتاج سنوات، لكن المطلوب عقدٌ أخلاقيٌّ بسيط:
- لا ننبش الماضي لتصفية حسابات.
- ولا نسمح للماضي أن يعيد إنتاج نفسه داخل أي مشروع.
- معيارنا الآن هو السلوك داخل العمل: التزام، شفافية، احترام، إنجاز.
بهذا تُبنى الثقة من جديد كرصيدٍ تدريجي، لا كقرارٍ خطابي.
- إعادة الدين إلى وظيفته الأخلاقية لا إلى هيبته الشكلية
لا تُحاربوا الرموز الدينية، ولا تُقدّسوها، ضعوا الدين في موضعه الطبيعي: كمنظومة رافعة للقيم مرسخة للأخلاق، أي شخص له مكانة دينية مرحّب به حين يكون: قدوة توحّد الناس على الصدق والعدل والأمانة، لا “حَكمًا” يعطّل المساءلة بظاهر القول، ويفرض وجوده بواقع السلطة الرسمية. الدين حين يحرس الأخلاق يُنقذ المؤسسة، وحين يحرس الأشخاص يُعطّلها.
- هندسة الثقة: شفافية بسيطة يفهمها الجميع
الشفافية ليست تقارير معقدة؛ هي سلوك يومي:
- إعلان الإيرادات والمصروفات بوضوح.
- كتابة محضر اجتماع مختصر.
- تحديد مسؤولية كل مهمة.
- موعد مراجعة شهري.
- تقييم عادل: من أنجز يُشكر، ومن قصّر يُستبدل بلا فضيحة.
حين تصبح هذه الأمور عادية، تُشفى البلدة من مرض “التأويل”: لن يعود الناس يحتاجون تفسير النيات، لأن الوقائع واضحة.
خاتمة: الحرّ البسيط لا يطلب معجزة… يطلب قاعدةً عادلة
البلدة ليست عاجزة، لكنها متعبة، وليست فقيرة بالناس، لكنها فقيرة بالقواعد. وأخطر ما في المجتمعات الصغيرة أن الفشل فيها لا يُهزم بذكاء فرد، بل يُهزم بتواضع جماعة: أن نقبل جميعًا أن الإصلاح ليس “انتصار رأي”، بل تصحيح سنن.
إذا أردتَ أن اختصر الرسالة في سطرٍ يصل لكل بيت: نحن لا نحتاج أشخاصًا فوق الناس، بل نحتاج نظامًا يحمي الناس من الأشخاص . إن الإصلاح لا يبدأ حين نتفق، بل حين نتوقف عن تخوين كل اختلاف، وحين يحكم النظام العادل، سيتقدّم الأكفأ تلقائيًا، وسينسحب المستفيد من الفوضى تلقائيًا، وستعود الثقة تدريجيًا… لأن المجتمع حين يرى العدل أمامه، يتوقف عن محاكمة النيات ويبدأ في محبة الفعل.