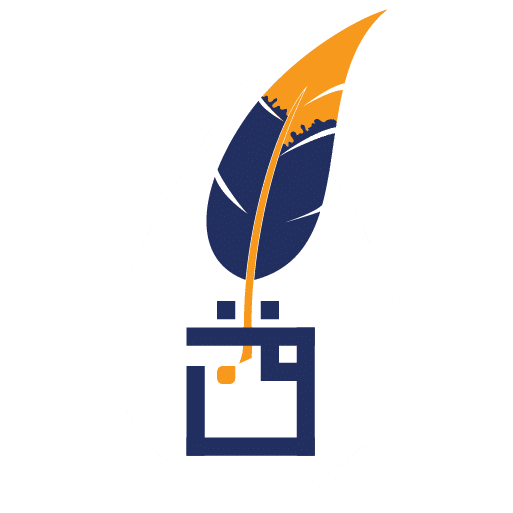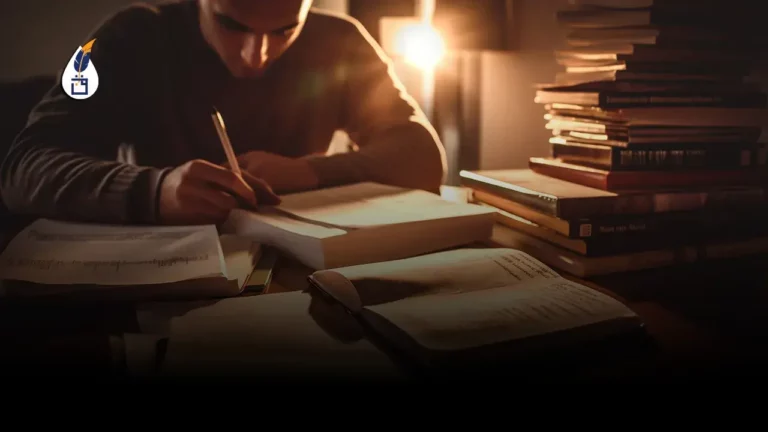أإسلام وأنصاف آلهة..!! كيف يجتمعان؟!
أيمن قاسم الرفاعي
“على أبي سليمان فلتبكي البواكي، والله لقد كان سداداً لنحر العدو ميمون النقيبة”
بهذه الكلمات الممزوجة بالدموع أنهى الفاروق عمر سيرته مع رفيق العمر خالد بن الوليد، وبالوصية ببناته وأهله إليه أنهى سيف الله المسلول سيرته مع ابن الخطاب، لكن العجب العجاب تسمعه حين تتصفح كثير من الكتابات في السير وغيرها حول هذه العلاقة لتجدها حبلى بالتأويلات والشطحات التي تتحدث عن حقد شخصي حمله أبو حفص على أبي سليمان، فيؤوله البعض لسباق جرى بينهما أو لتنافس وروح خصومة وحسد كانت قبل الإسلام وذهب غيرهم إلى سوى ذلك، وسواء أكان ذلك التأويل بسلامة نية أم بفسادها فقد كان يحاول بسذاجة أن يعلل المواقف التي اتخذها عمر تجاه خالد أيام خلافة أبا بكر (رضي الله عنهم أجمعين) والتي وقف فيها ابن الخطاب موقف الناقد لبعض تصرفات خالد دون مواربة حين خرج عن النهج الإداري الذي تبنوه ومشيراً على أبي بكر باستدعاء خالد وسؤاله أو بعزله، ثم ما كان من عزل عمر بعد ذلك لخالد وتولية أبي عبيدة بن الجراح أثناء خلافته، القصة أشهر من أن يفصل فيها، لكن الشاهد هو في العقلية المجانبة للعقل والمنطق “العقلية البارانويدية” التي يضيق صدرها فضلاً عن عقلها الضيق بأي نقد أو تقييم موضوعي فما تلبث أن تجتره وتحوله مباشرة إلى عداء شخصي وتؤول له من الأسباب ما يطرق كل باب سوى باب الموضوعية والنقد البناء الذي أمرنا به سواء من خلال الفريضة الإلهية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أم الوصية النبوية (الدين النصيحة).
هذه العقلية “البارانويدية” التي ابتليت بالتأويل القسري الذاتي، تجاهد دائماً لربط أي نقد، يطالها أو يطال أيما له علاقة بها من أشخاص أو حتى قناعات، بما بات يسمى بـ “الشخصنة”، وسواء ذلك أكان لذاتها أم لذات ناقدها. فإما أن تجعل من النقد الموجه لها يتعلق بالحسد لشخصها أو لشخص من تناصره، أوترده إلى خلل ونقص في شخص الناقد ذاته.
ويحاول أصحاب هذه العقلية دائماً الهروب بالشخصنة من استحقاقات التفنيد الموضوعي أو المواجهة المباشرة بالدليل والحجة رغم فداحة الذنب وعظم الكارثة، متجاهلين تماماً الأمور المعروضة أو المتناولة بالنقد ومدى خطورتها، ولا حتى مجرد مناقشتها على سبيل وجود احتمال ولو بسيط لصحتها رغم عظمها، بل على العكس.!
فإن كان هناك ثمة نقد عن ظاهرة سلبية قام كاتبه بعرضه بأسلوب فكري أو أدبي أو قصصي عام غير مخصص بأحد، فضح هؤلاء القوم أنفسهم وكشفوا دثار الستر الذي غشيهم به الله إمهالاً لهم، وجعلوه وكأنه محسوم الاتهام الشخصي والخصومة لهم، وما دافع كاتبه أو قائله إلا الحقد الكامن في القلوب والحسد، وإن النقد الذي أمرنا به إنما يكون بالتخصيص وبين أهله، “فالنصح بين الملأ تقريع كما يقولون”، ثم إذما تكلم هذا الناقد أو سواه عن قضية أخرى أو حتى القضية ذاتها وتعرض لها بالنقد الموضوعي المهني وفق قواعده وبين أهله المعنين بالظاهرة مسمياً الأسماء بمسمياتها دون تشهير، اجتهد هؤلاء بالتجاهل لهذا النقد والالتفاف عليه من خلال التهجم على الناقد واتهامه بوجود خلل في شخصيته وحبه للتفرد والظهور وحمله الناس على رأيه أيما كان، وفي كلا الحالين لن يسلم هذا الناقد من جهالة سفيههم عليه ولا كيد ماكرهم له.
ولكن ماذا عساي أقول وهذا من أسوء أدواء هذه اﻷمة والذي لم يسلم منه إلا من رحم ربي، فلا أحد يقبل النقد أو التخطئة فضلاً عن أن يتحلى بروح الشجاعة للاعتراف بالخطأ، فكثير من هذه الأمة إما أنبياء أو أنصاف آلهة بأقل تقدير، رأوا لأنفسهم عصمة لا يراه نبي لنفسه لات حين نبي، أو وضعوا أنفسهم المريضة هذه في معارج من القداسة تتخطى أنصاف آلهة أساطير اليونان ولات زمن أساطير.
ولا تكتفي أمثال هذه العقول الضيقة بذلك وحسب، وإنما لا تلبث أن تتحول بعد التجريح والاتهام للغير بالشخصنة، إلى الارتقاء إلى برجها العاجي والتكرم بتزكية نفسها والجود على منتقديها وسواهم بالعفو والمسامحة العامة على الملأ نزولاً على دعوى خلو الصدر والإيمان، وتبرعاً بمنح صكوك الغفران دون أثمان، وما ذلك طبعاً إلا تحايل لإرضاء هوى النفس لديهم مما تلبسه عليهم إبليس لتأكيد صواب موقفهم، وهروب نفسي من استحقاقات محكمة الضمير التي تنعقد حتى في خلجان نفس الشياطين، وليتهم راجعوا ابن الجوزي في ذلك لكان أسلم لهم، ولعرفوا أن الاعتذار لا يكون لمجهول والمسامحة لا تكون عن مجهول.
أما إن كان هناك من إلجاء لهم للاعتراف بالخطأ أمام جلاء الدليل وسطوع البرهان، فلا يكون اعترافهم بالخطأ إلا على سبيل امتصاص النقمة والمناورة، دون أدنى تحمل للمسؤولية ولتبعات الخطأ أو السعي للتصحيح واتخاذ موقف تفرضه المبادئ والقيم والدين والضرورات.
بكل العجب أتساءل، لماذا يستكبر المرء من هؤلاء أن يفكر في مراجعة نفسه ليس فقط في أموره الخاصة التي هي على ما هي عليه من الفشل والخزي، بل حتى في أمور الخلق والمسؤوليات التي تصدى لها دون أدنى مقومات لديه، والتي ينوء بحملها العظماء فضلاً عمن هم أكبر منه همةً وأعظم منه فكراً.
فهلا رجع أمثال هؤلاء إلى ميزان الله الذي جاءهم به الإسلام الذي يدّعوه، فألزمهم اتباع الحق أيما كان أهلوه، ومجابهة الباطل حتى لو كان من ذوي القربي، وتفكروا في الاحتمالات والمآلات قبل الدوافع والشخوص.
هلا استوقفوا أنفسهم قليلاً وسألوها ((ماذا لو)) كان ما يقال صحيح فعلاً، حتى إن كان الأسلوب (بحسب رأيهم) خاطئ، ألا تستحق الحقيقة الوقوف ولو للحظة موقف مشرف، ألا تستحق المواضيع المصيرية والقضايا العامة الإنصاف ومراجعة الذات لإحقاق حقوقها وتعرية كل تزوير وتزييف يتم تحت أسماء كثير خاصة ما كان من أمور البلاد والعباد، أم أن طمي الخطايا والفساد قد غاصت به أقدامهم إذ تلطخت به قلوبهم.
((عن الأغر المزني رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ قال: “إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر اللَّه في اليوم مائة مرة” رَوَاهُ أبو داوود واحمد ومُسْلِم.))، فهل كان استغفاره صلى الله عليه وسلم بالشفاه أم استغفار تفكر وتدبر ومراجعة ومحاسبة وهو المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ألم يحدث صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليعلمنا بالمثال والقدوة.
فإن كان هؤلاء القوم أعظم من أن يقارنوا بابن الوليد بانجازاتهم، وأجل من أن يتعظوا بالفاروق لسمو فكرهم وقيمهم، وأكبر من أن يقتدوا بابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لعصمتهم وقداستهم، فليخرجوا لنا خبيئاتهم لعلنا نتبع القوم إن كانوا هم الظاهرين!!.
وإلا فليتقوا الله.
الدوحة 31/01/2015م