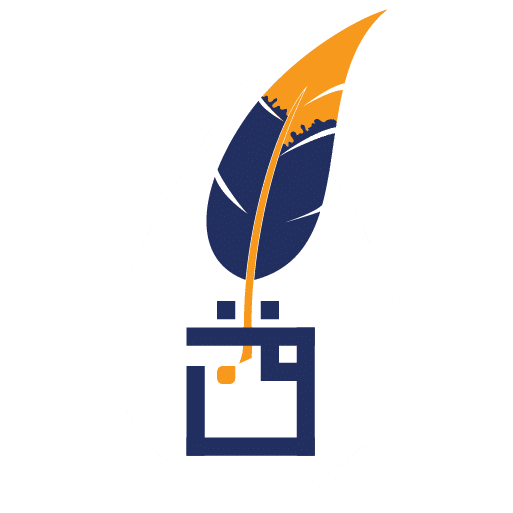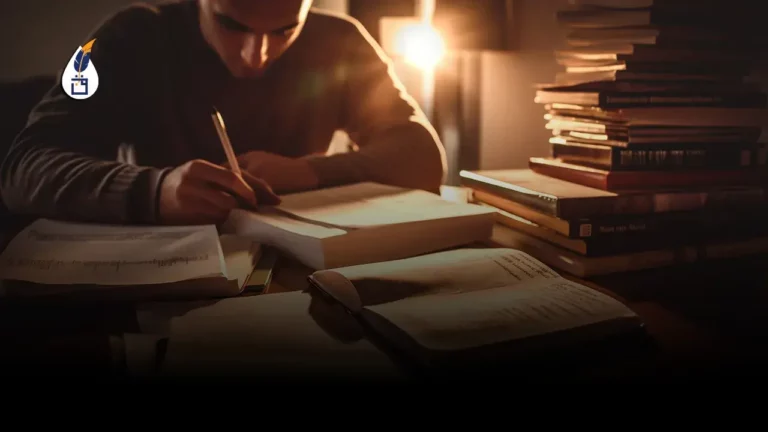المعجزة المهجورة : الجزء الأول – النهج العقيم
1- انشغال لا شغل
يولد الطفل المسلم مصحوباً أغلب الأحيان بتمائم القرآن وآيات الذكر حوله. حتى إذا ما شب شيئاً فشيئاً ونطق باسم والديه، كانت آيات القرآن هي أيضاً أول ما يحاول الأبوان غالباً تعليمه لطفلهما الذي يبغيان بالقرآن أن يكون حارساً له. وقد لا يغير من ذلك كثيراً مدى الالتزام الديني للأبوين في هذا الأمر.
اهتمامنا بالقرآن يكاد يهمين على حياتنا كمسلمين متعلمين وغير متعلمين، ملتزمين وغير ملتزمين. المصاحف المزركشة المسندة على الأرفف تملأ بيوتنا، ومساند القراءة ولوحات الآيات القرآنية تتزين بها الجدران والأرفف بأبهى الحلل في سائر البيوت من أكواخها وحتى قصورها. أصوات المقرئين المجودين ترتيلاً وحدراً، صدى يتردد دائماً في المناسبات وغير المناسبات في البيوت والسيارات وحتى في أماكن العمل والتسوق. كل ذلك وأكثر لنحظى ببركة القرآن ورضا الرحمن، أو ربما كانت للبعض لمجرد المزيد من الحظ والتوفيق كواقع لا مفر منه عند بعض المسلمين.
فإن التفتنا إلى الملتزمين من المسلمين لوجدنا أن الاهتمام الأكبر ينصب بالدرجة الأولى على أمرين؛ الأول عند الشريحة العظمى التي لا تكل ولا تمل جهودها في تلاوة كتاب الله العزيز ليلاً ونهاراً في رمضان وغير رمضان وفي أيام الجمعة وغيرها، لتحقيق أكبر عدد من الختمات للمصحف الشريف، طمعاً بالأجر لكل حرف يتلى منه. أما الثاني؛ فهو عند الذين يعتنون بتحفيظ وحفظ القرآن من خلال مراكز التحفيظ ومسابقات حفظ القرآن التي تلقى كل الرعاية ويصرف عليها بسخاء سواء من مؤسسات المجتمع والحكومات أو حتى على مستوى الأفراد. وكل ذلك طبعاً طمعاً في الأجر العظيم وتيجان النور يوم القيامة.
ثم إذا التفتنا إلى المتخصصين في علوم الدين والشريعة كشريحة معنية بالأمر، وجدنا لديهم في دراسات القرآن هيمنة لأمرين اثنين أيضاً؛ الأول: هو ما يسمى علم التجويد والقراءات، والذي يعنى شيوخه والمشتغلين فيه بمخارج الحروف وضبط لفظ الكلمات على اختلاف اللهجات أو الألسن المعروفة في قراءات القرآن (القراءات السبع، القراءات العشر..)، حتى أصبح البحث عن القراءات الشاذة وبيانها ضرب من ضروب التميز عند البعض في ذلك العلم تحت دعوى العناية بكلام الله وإظهاره.
أما الثاني: فهو ما يسمى علم التفسير؛ حيث بإمكان المرء وبعملية بحث بسيطة أن يحصي عشرات التفاسير التي أُلفت وصُنفت منذ أكثر من ألف عام إلى يومنا هذا. تفاسير بحسب المأثور وتفاسير الرأي وتفاسير الموضوعية والتفاسير البلاغية والبيانية إلى آخر القائمة. لكن ما إن تُبحر قليلاً في هذه التفاسير وتتفقد معاني سورة من السور وتتمعن في متن تفسيرها حتى تلاحظ أنك بالكاد تقرأ في كتاب واحد. الحجج والأدلة والمعاني ذاتها تتكرر ولا فرق إلا في مدى الاستطراد في الاستعانة بالإسرائيليات وأساطيرها وضعاف الأحاديث، أو الإطناب في الشرح والبسط الانشائي العاطفي الذي يشط في كثيرٍ منه عما يمكن أن يحتمله نص الآيات بحدِّ ذاته.
ظهرت في فترة متأخرة بعد ذلك في أواخر القرن العشرين ظاهرة ما يسمى “الإعجاز العلمي في القرآن“، وإن كان لها جذور تاريخية متقدمة تعود إلى الإمامين الغزالي وفخر الدين الرازي. حيث حاول بعض المشتغلين بالفكر والعلم والدين في العصر الحديث البحثَ عن تفسير أو تأويل علمي أو عددي أو حتى بلاغي للقرآن خارج إطار التفاسير التراثية. وقد جاءت هذه الظاهرة كردِّ فعلٍ خجول لرفض التفسيرات والتأويلات التي تفيض بها كتب التفسير لهذه الآيات والتي لا تتوافق مع نظام العقل والمنطق ولا حقائقِ العلمِ المثبتةِ.
لكنه وبكل أسف لم تكن هذه الظاهرة ثورة معرفية حقيقية على مستوى إعادة قراءة القرآن قراءة معاصرة تؤسس لفهم جديد في ضوء المعارف الإنسانية المتطورة والمستجدة، من أجل الاستفادة من هذا الفهم في بناء النظريات المعرفية وحتى العلمية الأصيلة المستندة إلى شواهد وإشارات القرآن. بل كانت مجرد ظاهرة كلامية بحتة غير علمية منفعلة تتعلق بإعادة تأويل الآيات القرآنية بناء على تقاطعاتها مع الحقائق العلمية والظواهر الكونية المثبتة، والتي ربما خان مشتغليها الفهم لها أحياناً أو شط بهم التأويل أحياناً أخرى. حيث أدى عملهم هذا في تلك الحالات إلى تشويه الفهم القرآني أكثر مما خدمته حين ربطوا أن التفسير الحتمي لهذه الآيات هو هذا المعنى.
هذه الاضاءة تدل بما لا يدع لنا مجال للشك بأن القرآن كمادة دينية أو كنص مقدس يشغل حيزاً كبيراً من حياتنا كمسلمين. وإن المسلمين من عامتهم إلى علماء شريعتهم على اتصال ظاهري وثيق في شتى شؤون حياتهم بهذا الكتاب المقدس الذي أنزله الله للبشرية جمعاء كرسالة خاتمة لما سبقها من الرسالات السماوية.
ولكن أمام هذا الواقع تطرح نفسها علينا كمسلمين عدة تساؤلات لا بد منها؛ هل أدى كل هذا الانشغال بالقرآن مراده ومقصده الذي أراده الله؟ هل تحقق بهذا الاتصال تفعيل لدور القرآن في حياة الأمة؟ إن كان القرآن الرسالة السماوية المعجزة الوحيدة الصالحة لكل زمان ومكان، فهل لا تزال معجزته حية وتبرهن على ذاتها في واقعنا؟ فإن كانت فعلا لا تزال حية كما يقال فأين شواهدها في حياة الأمة ونهضتها؟
أسئلة يقف المنصف أمامها بين نارين في الإجابة عنها؛ بين نار الواقع المتردي للأمة الذي يقول حالاً للقرآن في أمته غير الحال الذي يملى علينا ليلاً نهاراً حول معجزته الحية، وبين نار الانشغال بالقرآن عن الشغل به. لأن هذا الانشغال أضاع ولا زال يضيع وقت الأمة وجهودها دون إنتاج أي عمل قرآني حقيقي من وحي القرآن ذاته يكون نواة منهجية علمية وعملية تنعكس في حياة الأمة والإنسانية جمعاء، لتغير حالها كما أخبر ربنا جل وعلا وكما حدث مع الرعيل الأول محمد (ص) وصحبه. فقد جاء عن ابْنَ عُمَرَ أنه قال: «لَقَدْ لَبِثْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ، وَأَحَدُنَا لِيُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ تَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، وَأَمْرَهَا وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمُ السُّورَةَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ يَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، مَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ وَلَا حَرَامَهُ، وَلَا أَمْرَهُ وَلَا زَاجِرَهُ، وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ وَيَنْثُرُهُ نَثْرَ الدَّقَلِ» (1).
2- مرض الأمة
أكثر من ألف وأربعمائة عام ونحن أمة للقرآن، هذا القرآن الذي يملك حقيقةً مفادها أنّه النص الأوحد في التاريخ الإنساني الذي يمتاز بقيمة إعجازية لا تتوفر في أي نص سواه وظاهرة نصية لم تتوافر لأي معجزة نبي من قبل محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك بكلا الدليلين النقلي والعقلي معاً. وهذه الحقيقة هي تحديداً (قطعية ثبوت النص مع خاصية دوران أو تطور المحتوى)، بمعنى أن نصوص هذا الكتاب المنزل من الله عز وجل هي نصوص ثابتة الشكل موثوقة لا يطالها شك ولا تحريف منذ تنزلها على محمد (ص) قبل ألف وأربعمائة عام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أن معاني هذه النصوص ودلالتها تصلح لكل زمان ومكان لقدرتها على التغير بتغير الزمان والمكان والتطور بتطور المعرفة الإنسانية ذاتها.
رغم هذه الحقيقة التي لا يطالها شك، إلا أننا وبعد ألف وأربعمائة عام مرت لا زلنا نقرأ (بمعنى ندرس ونطالع) القرآن بذات الطريقة، ونفهمه بآلية فهم واحدة ونتداوله بكل أسف بمنهجية فهم واحدة أيضاً. لم يتغير شيء في تعاطينا وتوظيفنا للقرآن رغم كل التغيير الزماني والمكاني والحدثي الذي طال العالم منذ عام الفيل الذي يذكروه، إلى عام الذكاء الصناعي الذي نحياه اليوم.
لقد مضى العهد الإسلامي الأول بمحمد (ص) وصحابته الكرام (أمة الأميين) الذي خرج إلى الأمم بكتاب سماوي يحمل لهم ما لم يعهدوه من مبادئ القيم والأخلاق والأسس الجديدة للاجتماع الإنساني وقوانينه وفق ما بلغته المعرفة الإنسانية حينها. فحقق بذلك قفزة معرفية جديدة استفاد منها ذلك العهد وساد العالم بما قدمه للعالم والإنسانية من نقلة حضارية إيمانية معرفية قيمية متطورة أرست قواعد حضارية جديدة جعلت من أصحابها أسياد العالم.
لكن وبكل أسف، ما إن مضى ذلك العهد وخرجت المدارس الفقهية والمراجع المذهبية التي كبلت الفكر مع الوقت بقوانين كهنوتية أدت إلى عملية تحنيط للقرآن وتعطيل لمعجزته عن قدح الفكر الإنساني وتطوير معرفته، لم نخرج مذ حينها بأي علم مثبت قادتنا إليه إشارات القرآن، ولا بأي معرفة حقيقية أرشدتنا إليها آياته تناسب زماننا وأحواله وتصنع لنا مكاننا معرفياً بين الأمم.
بل إن عجز رجالات هذه المدارس والمراجع عن القيام بدور حضاري حقيقي كما فعل الرعيل الأول لأسباب شتى أهمها سياسية، جعلهم يعيشون منكفئين على الماضي المجيد مكتفين بالتدثر بعباءة رعيله الأول شكلاً لكن دون الاقتداء مضموناً بنهجهم التنويري العظيم. وذلك برغم أساطين المؤلفات والمجلدات التي نآت بها أرفف أعظم المكتبات، والتي بكل أسف أيضاً لا تعدو أن تكون اجترار المتأخرين لما أفرزته عقول الأولين في صورة مشوهة للصورة الأولى فضلاً عن تشويهها للقرآن وآياته في كثير من تعاطيها معه.
وأكثر من ذلك، إنه وكلما خرج من أبناء هذه الأمة أحد على قلتهم من أصحاب التجارب الفردية المشتغلين بإعادة قراءة التنزيل الحكيم، بطريقة علمية تأصيلية تتناسب مع التطور المعرفي الذي وصلت إليه الإنسانية بما يناسب القيم والسنن أو القوانين الإلهية التي بني عليها رب العزة قرآنه، للخروج بنظريات وأفهام جديدة تسهم في تطور المعرفة الإنسانية ذاتها وتمهد لإعادة بناء هذه الأمة بناء قرآني يتفق زماناً ومكاناً مع ما تحياه تحقيقاً لمقصد الاستخلاف والعمران وأداء للأمانته التي أرادها الله.
فإن هذه القلة لا تجد من مؤيدين لتجاربهم ممن قد يساعدهم في تحويل وتطوير أعمالهم إلى منهجية علمية متكاملة تنعكس في تطوير فهمنا وعملنا بكتاب الله العزيز. فضلاً عما ستتعرض له هذه القلة من محاربة وهجوم ومصادرة لأعمالهم بدعوى الكفر والإلحاد والزندقة والهرطقة وغيرها من التهم الجاهزة المعلبة لكل من خرج عن اجتهاد الجماعة أو رأي الجمهور “مَن قال في القرآنِ برأيِّهِ ، فليتَبوَّأْ مَقعدَهُ مِن النَّار“(2)، والذي جعله الإكلورسيين (كهنة رجال الدين) قالباً ليحيا فيه القرآن بحسب زعمهم، فكان بكل أسف تابوتاً ذهبياً حنّط القرآن وأماته من حياة الأمة.
ويجب الانتباه في هذا الباب أنه لا يتساوى في هذا الأمر كل من خرج بجديد في كتاب الله بدعوى رفض التراث ورغبة التجديد فيه وتقديم رؤية معاصرة لكتاب الله، فهناك دائماً الغث وهناك السمين ولكل أزمة فكرية ووجودية ما يكفيها من السماسرة والمصطادين في الماء العكر، فالنهج المعوج يبقى معوجاً تحت أي مسمى كان. ولكن يجب أن نميز هنا أمثال هؤلاء المرضى أو المدفوعين عن أولئك المصلحين ممن بنى النظريات وأسس لفكر منضبط ومنهجية بحثية علمية قادرة على فتح المجال لمفكري الأمة على تقصي الإشارات في القرآن الكريم لبناء معارف وعلوم جديدة تسهم في تطوير المعرفة الإنسانية والإيمانية من جهة، ومن جهة ثانية تفيد الأمة وتقود خطاها نحو مرحلة جديدة من التطور مستندة في ذلك إلى قيم وسنن الله في القرآن ذاته.
ولكن من الموضوعية الحقة أيضاً أن نعترف أن أزمة الواقع المحنط الذي خلقناه لعالم القرآن كأمة، هو الذي أوجد الظروف التي دفعت البعض قصداً أو دون قصد للخروج بآراء شاذة في الفهم خلقها أسئلة إشكالية لم يستطع رجال الدين الإجابة عليها بشكل منطقي علمي يروي غليل المستفهم، بل قابلوها بكل تعليل وتبرير يستند إلى مرويات ما أنزل الله بها من سلطان نسبوها إلى رسول الله صلوات ربي عليه أو صحابته الكرام لا يقبلها منطق ولا يقرها عقل وتخالف منهج القرآن ذاته إن لم تخالف نصه إبتداءً. فضلاً عن أن يحرموا السؤال نفسه ويكفروا أصحابه. كل هذا أدى بالبعض من أبناء هذه الأمة وبكل حرقة إلى الإلحاد والعياذ بالله.
وكذلك لا يفوتنا الإشارة أيضاً إلى أن التاريخ قد ظهر فيه الكثير من المفكرين ممن رفضوا ذلك المنهج المعطل للقرآن وقدموا آراء وأفهام قرآنية المنهج كان يمكن لها في عصرها أن تكسر ذلك الجمود وتحيي القرآن في حياة الأمة، ولكن بالتأكيد ما كان لأصوات أمثال أولئك أن تجد صدى لها في واقع غالباً ما تعاضد فيه الفاسدين من رجال السياسة والدين لخنق كل صوت يمكن أن يحرر الإنسان والإيمان ويطلق العنان للعقل في فهم كتاب الله، وبالتالي خلق أجيال محمدية ربانية ليس للمستبدين في حياتها سبيل.
يقول جل من قائل في كتابه العزيز: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) الفرقان)، يتفق سواد الأمة اليوم على أن هذه الآية تنطبق على واقع حالنا اليوم ومنذ فترة طويلة أيضاً. فإذا كنّا فعلاً قد هجرنا القرآن بعد كل ما نبذله من الانشغال بالقرآن سابق الذكر، فأين يكون هذا الهجر إذن؟ وكيف يتأتى؟.
قد يجيب البعض على هذا السؤال بأن الهجر قائم بالتطبيق وأنّا ما عدنا نطبق تعاليم القرآن في حياتنا. فإن صح هذا الجواب ابتداءً، فإن كل الممارسات سالفة الذكر التي ننشغل فيها بالقرآن، والتي يُدافع عنها ويُذكر فضلها ليلاً نهاراً، تصبح لا معنى لها وليست ذات أهمية في حياة القرآن طالما أن الهجر قائم بوجودها!. فإن قلنا ببطلان هذه الممارسات حينها ستبطل بالتالي عملية تطبيق التعاليم ذاتها لأن ممارسات الانشغال بالقرآن هذه هي المرجع الأوحد بحسب رجال الدين لفهم تعاليم القرآن التي يجب أن نطبق، إذن نكون بذلك قد أدخلنا أنفسنا كأمة في عنق الزجاجة فلسفياً واجتاحتنا جدلية الجدل السلبي أو معضلة نفي النفي.
وهكذا نرى أننا فعلياُ قد انشغلنا بالقرآن بما جعله رجال الدين المنهج الفعلي للقرآن، لكن هذا المنهج بكل أسف يتبين لنا يوم بعد آخر أنه منهج عقيم لا يمت إلى القرآن ومنهج الله فيه بصلة. حيث أنهم قد خلقوا بذلك النهج الانشغالي الذي سنّوه ما يسمى بنموذج التفكير أو الإدراك الخاص (البارادايم )، ولكن هذا البارادايم جاء مقولباً محنطاً جمد القرآن فأفسد علينا الدين والدنيا معاً. لقد أغفلنا وهجرنا بسبب ذلك ما بثه الله من منهج وبارادايم قرآني في القرآن ذاته يرشدنا ويفتح لنا أسرار القرآن بما يوافق كل زمان ومكان وبقدر تطور المعرفة الإنسانية فيه. لذلك فقد بتنا بذلك المنهج العقيم وقد عطلنا المعجزة وهجرنا الرسالة.
أما المعجزة التي عطّلناها!؛ فهي قدرة هذا النص الثابت على الدوران مع الزمان والمكان لخلق نظريات معرفية جديدة تناسب كل جديد في الحياة وتحمل ذات الرسالة التي جاء بها ولكن بشكل متطور يلائم عصره وواقعه ويسهم في دفع هذا التطور إلى الأمام تحقيقاً لمقصد الاستخلاف وأداء الأمانة. وأما الرسالة التي هجرناها!؛ فهي رسالة القيم السامية ومكارم الأخلاق والتي لا تنفصل عن أي معرفة أو علم نكسبها أو نطورها مهما كان، بل إن أي معرفة او علم غير مستند إلى القيم السامية هو بالضرورة معارف وعلوم غير إنسانية وغير إيمانية مهما تسترت بالنصوص المنسوبة للدين وحتماً ستؤدي إلى ما سينعكس على الإنسان بالضرر. وكما قال ابن القيّم “فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل” (3).
وهكذا نرى أن هذا المنهج العقيم قد أودى بنا كأمة إلى هذا التخلف والانحطاط لأننا قد خسرنا فعلياً القرآن الكريم كقوة محركة لتطوير أنفسنا ومجتمعاتنا عندما عطلنا معجزته وهجرنا رسالته. وبالتالي ألغيناه حقيقة من حياة الأمة وارتضينا ألا يكون إلا صورة من غير روح وشكل من غير مضمون. كما أن ممارساتنا الانشغالية السالفة الذكر تجعلنا نقول في كل حين أننا نتبع ونحيا بالقرآن، والحقيقة أننا نعيش مع الظل منه منزوين عن نوره الساطع.
وحتى نكون محددين وعمليين في طرحنا ووصفنا لهذا المنهج العقيم يجب علينا أن نحدد طبيعة هذا المنهج وآلياته ودوره في تعطيل المعجزة وهجر الرسالة، لذلك سنطلق على هذا المنهج اسم (البارادايم المَرَضِي) (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ – 10 البقرة) (أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ – 50 النور). حيث يستند هذا البارادايم المَرَضِي (نموذج الإدراك المعتل) إلى خمسة أسس يمكن اعتبار أنها هي القيود التي أدت إلى تكبيل القرآن وتحييده من حياة هذه الأمة وهي ما سنناقشه في الجزء الثاني من هذا المقال. وهذه الأسس هي:
1. القدسية الكهنوتية
2. أقفال القلوب
3. استنطاق الوحي
4. غريزة العَجَل
5. النزعة الأسطورية
لكن ختاماً لهذا الجزء، من المهم الإشارة إلى أن حديثنا حول هذه الانشغالات بالقرآن لا يعني بحال من الأحوال أن المقصود هو النهي عنها والتوقف عن ممارستها، بل القصد هو إقامتها حق الإقامة وإعادة فهم المقاصد الإلهية لهذا الكتاب. فإذا تلونا القرآن تلوناه ونحن نجعل سبيل الفهم لآياته والقيام بها هو سبيلنا وليس مجرد أرقام من الحروف نتلوها لنشغّل عداد حسناتنا. وإذا حفظنا آياته نحفظها ونستذكرها لتعيننا في كل موقف من حياتنا وتساعدنا على تدبرها والقيام بحقها وليس مجرد استعراض لقدرات ذاكرتنا الكمبيوترية. وكما جاء في الدر المنثور للسيوطي عن ابن عباس أنه قال : “إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا وبينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة” (4).
وأيضاً إن كنا قد أشرنا إلى التراث الفقهي والشرعي والأحاديث المروية عن رسول الله (ص) فليس المقصد أبداً هدم هذا التراث برمته وإنكاره، بل القصد هو تعزيز الصحيح منه ولكن على شرط القرآن حصراً، فالصحيح منه يكون؛ ما تواتر من صحيح سنده، ولم يخالف بمتنه القرآن لا نصاً ولا منهجاً ولا مقصداً، ثم التمييز بعد ذلك فيه بين سننه الرسولية منها والنبوية ومقاصدها.